Blog
هل ما زال لنا أن نقرأ ترولوب؟ .. ترجمة : زينب بني سعد
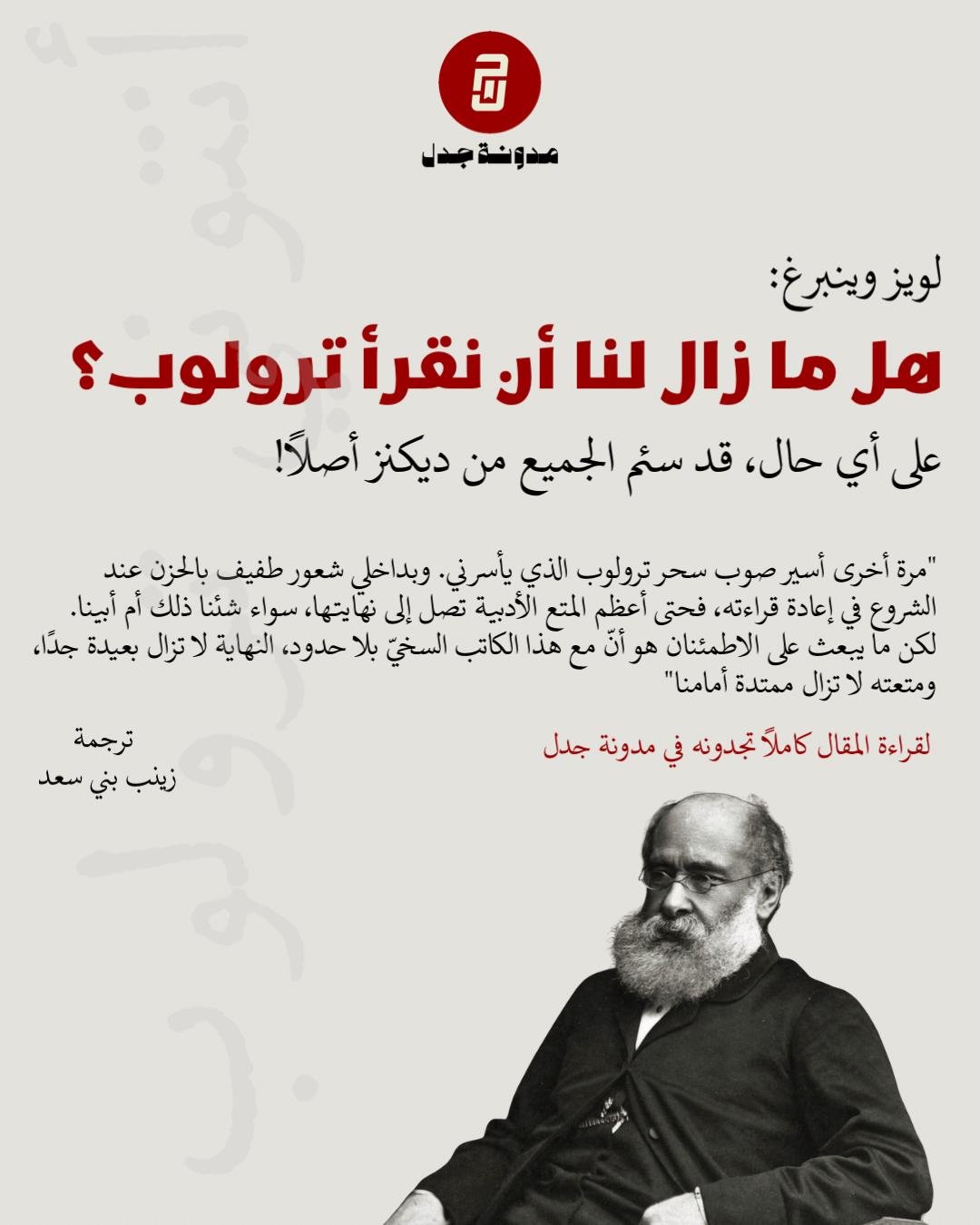
لويز وينبرغ “هل ما زال لنا أن نقرأ ترولوب؟”
في صحبة ترولوب من جديد
ترجمة : زينب بني سعد
شرعتُ القراءة لترولوب من جديد، فإذا بي أجد نفسي مضطرًة للدفاع عنه، ومعه عن نفسي أيضًا. حتى أصدقائي الذين يقرأونه يشاركونني هذا الحذر الغامض، كأنّ في قراءته شيئًا يستدعي التبرير. أمّا أولئك الذين لم يطرقوا عالمه بعد، فينظرون إلينا بدهشةٍ رقيقة، متسائلين: ما الذي يدفعنا إلى القراءة له؟. ذلك السؤال الأول – هل ما زال لنا أن نقرأ ترولوب؟- يبدو، كما يعلم الجميع، أنه نشأ لأن ترولوب نفسه، نسف سمعته بيده في سيرته الذاتية. تلك العادات المنظَّمة في العمل! وتلك الأرباح المدوّنة بدقّة، حتى آخر شلن وبنس! لقد جعل من نفسه، في نظر الفيكتوريين، كاتبًا تجاريًا مأجورًا من كتّاب “شارع گراب” اللندنيّ.
لكننا اليوم تجاوزنا تلك الأوهام الرومانسية التي حملها الفيكتوريون، إذ ظنّوا أن السمة الحقيقية للحياة الفنية هي الفوضى والطيش البوهيمي. في المقابل، أصدرت دار نشر جامعة أكسفورد مؤخرًا، طبعات فاخرة جديدة من روايات باريستشاير والبرلمانيات، إلى جانب نسخٍ أنيقة بغلافٍ ورقي لتلك الأعمال وغيرها من مؤلفات ترولوب. لا شك أن هناك من يشتريها. تتدفّق اليوم سيرٌ ذاتية جديدة عن ترولوب من كل صوب. ومع ذلك – كما كان ترولوب نفسه يحب أن يفتتح جمله بعبارة “ومع ذلك” أو حتى “لكن مع ذلك” – ثمة خللٌ عميق ما يزال يعتري سمعته إلى هذا اليوم. فهناكَ قرّاء لا يكتفون بعدم القراءة لترولوب، بل يرفضون قراءته رفضًا قاطعًا. وأكثر من يصرّ على ذلك هم الإنكليز أنفسهم. ففي نظرهم، لا يقرأ ترولوب إلا أناسٌ “فظيعون” – وأكاد أراهم في خيالي عمّاتًا عزباوات وضبّاطًا متقاعدين. أظنّ أن شعورهم هذا نابع من أن ترولوب، في مخيّلتهم الثقافية، كاتبًا من “الطبقة الوسطى” ثقافيًّا. ويُدرَج في هذا التصنيف مع غيلبرت وسوليفان، اللذين لا يجمعهما به شيء سوى روعتهما التي لا يُقدّرها الناس حقّ قدرها. والمفارقة أن هذا الكاتب الإنكليزي الصميم، بات ذوقًا أمريكيًا خالصًا. فمهما كان أولئك “الناس الفظيعون” الذين يقرؤون ترولوب، فنحن الأمريكيين قد انضممنا إليهم. ولأكون صريحة، أظن أننا نحن بالفعل، أولئك الناس الفظيعون. ناقشتُ كل هذا في لندن مع شابة تعمل في مجال النشر، قالت لي:
“انظري، إنَّ ترولوب بمثابة ديكنز من الدرجة الثانية. وإن كنا نريد هذا النوع من الأدب، لقرأنا الأصل، شكرًا جزيلًا.”
وأطلق رفاقها تلك الهمهمات الإنكليزية القصيرة التي تعبّر عن الموافقة. ثم أضافت:
“وعلى أي حال، قد سئم الجميع من ديكنز أصلًا.”
لا أدري لِمَ قرنت تلك الشابة بين ترولوب وديكنز. ربما كانت تقصد أن ديكنز كاتب “من الطبقة الوسطى” هو الآخر، أو لعلها – كما يفعل الذين لم يقرأوا ترولوب عادة – كانت تفكر في ميله إلى اختيار أسماءٍ ذات دلالات لافتة وشبه ساخرة. لكنّ الجمع بين ترولوب وديكنز خطأٌ بيّن، ليس فقط لأن أشخاصًا مثلي لا يمكن أن يفكروا أصلًا في مشروعٍ لإعادة قراءة ديكنز (فنحن، مثل صديقتي الإنكليزية، قد سئمنا من ديكنز). بل لأن الكاتبين في الجوهر لا يجمعهما الكثير. ديكنز، في نهاية المطاف، كان صاحب رسالة اجتماعية إصلاحية، يسعى إلى تليين قسوة قلوبنا تجاه من يُسمَّون اليوم بـ “المشرّدين” أو “الطبقة الدنيا” أو “العمال الفقراء”. كان يريد أن نرى كم يمكن لأولئك الناس، المتّسخي الثياب، أن يكونوا محبوبين في حقيقتهم، وكم قد تبدو عيوبهم المنفرة جذّابة، حين نراها بعين التعاطف، وكم يمكن للطبقة الوسطى ومؤسّساتها أن تكون قاسية على النساء والأطفال الضعفاء الذين لا يملكون سوى هشاشتهم. أما ترولوب، فلم يكن معنيًّا بشيءٍ من هذا كله. بل كان في ردٍّ صريحٍ على ديكنز – الذي سمّاه هو نفسه “السيد عاطفة” – حين أعلن في روايته “راعي المأوى” أن شخصياته ستكون في آنٍ واحدٍ، محبّبةً وأنانية، جذّابةً وفاسدة، مثل الناس في الحياة الواقعية تمامًا. وبطبيعة الحال، يعترف ترولوب في الموضع نفسه – وبصراحةٍ لا تخلو من المودّة – بأنه يُحب ديكنز. فهو يُبدي إعجابًا مدهشًا بشخصيات ديكنز الثانوية، التي “تحيا؛ نعم، تحيا، وستظل تحيا”، حتى يغدو اسم الممرّضة في الذاكرة الشعبية مرادفًا لـ السيدة غامب نفسها. ولا شك أن ديكنز، من حينٍ إلى آخر، يتجاوز برنامجه الأخلاقي والاجتماعي المرسوم، ولا سيما في روائع مثل “آمال عظيمة”. لكن ترولوب لم يكن يمتلك ذلك البريق العبقري الآسر الذي مكّن ديكنز من أن يمنحنا شخصيات مثل مس هاڤيشام وإستيلا. فهاتان الشخصيتان، رغم خلودهما الأدبي، تَبدوان في نظر ترولوب شديدتي الإغراب، مبالغتين في سطوعهما، بحيث لا يمكن أن يولدهما خياله الواقعيّ الهادئ. لم يكن ترولوب يمتلك ذلك الوهج المسرحي الذي يلمع في أعمال ديكنز. أما صديقتي الإنكليزية، التي وصفت ترولوب بالعبارة القاتلة: كاتب من الدرجة الثانية، فقد كانت تعبّر بذلك عن الشعور السائد بأن ترولوب لا يمثل شيء من “الأدب” بالمعنى الرفيع للكلمة، وأن أدبه ليس “فنًّا عظيمًا”. فهو، وإن كان فريدًا في قدرته على الإمتاع، يبدو – في نظرهم – خفيف الوزن بعض الشيء، يفتقر إلى الجلال والسمو. أظنّ أن هنري جيمس، وهو كاتبي المفضّل الآخر، قال يومًا عن توماس هاردي بإنه – ومهما كانت عيوبه – كان قادرًا على أن يلمس الوتر التراجيدي ويضبط نغمة المأساة. أما ترولوب، فلم يلمس ذلك الوتر قط. إذ وصفه جيمس بأنه “سيّد العاديّ”. ومع ذلك، لا يعني هذا أن صفحات ترولوب تخلو تمامًا من العتمة أو المأساة؛ فحين نفكّر في نهاية ملموت في رواية “العالم الذي نحيا به اليوم” أو في الخراب الكامل الذي أصاب حياة السيدة لورا في روايات “ڤينياس فين”، ندرك أن ظلال الألم والحسرة تتسرّب إلى عالمه بين حينٍ وآخر.
وهناك أيضًا، زلات تثير القلق وتحبس الأنفاس: الوثيقة المزورة في رواية “العالم الذي نحيا به اليوم”، والوصية المزورة في “مزرعة أورلي”، أو “ماسات ليزي يوستاس” المسروقة. ومع ذلك، فإن هذه الظلال لا تبدو إلا وكأنها تتساقط برفق تحت عين ترولوب الهادئة المتعاطفة، فهو ليس من أولئك الذين يغوصون في المأساة الكبرى. والأمر الطريف أنني لست متأكدة مما إذا كان هنري جيمس نفسه قد نجح يومًا في مسّ الوتر التراجيدي. إذ يشترك ترولوب وجيمس في مساحة واسعة من الاهتمامات. ولا أعني بذلك فقط أن كلا الكاتبين منشغل بمخاطر العالم الخارجي على الناس العزلاء: فعند ترولوب، التهديد يأتي من الجديد في العالم؛ أما عند جيمس، فيأتي من القديم. بل إن ثمة مادة متطابقة بشكل يثير الدهشة تجذبهما: فكلاهما يعرف كيف يحوّل شخصية المغامرة القارية الزائرة وأخيها الفنان البوهيمي إلى مادة سردية شيقة – جيمس في روايته “الأوروبيون” وترولوب في جزء من “أبراج باريستشاير” – وقد سبق ترولوب جيمس في هذا الأسلوب بحوالي عشرين عامًا. لكن الأهم، والأعظم، ما يمنحه هذان الكاتبان المختلفان في طبيعتهما للقراء، هو رفيق السرد الحميم. هذا الرفيق شخصية ممتعة إلى أقصى حد: رشيق، مصقول، ومطّلع على العالم، وفي الوقت نفسه ودي، وفضولي، وثرثار. وهذا الرفيق يعرف كيف يضبط نغمة الفكاهة بطريقة بديعة. لكن كتب ترولوب، على عكس كتب جيمس، لا تتجه نحو ذروة الألم العاطفي بين الشخصيات، ولا نحو كشف مثير للريبة. فجيمس يمتلك عنصر الجلال، حتى دون أن يلمس الوتر التراجيدي، وحتى إذا تجاهلنا نظرياته الجمالية وأسلوبه المترف في الكتابة. وليس من المستغرب أن يقطع الناس الطريق، للحج إلى منزل جيمس في راي وينادوه بـ “المعلم”. لكن ما من أحد قد يتصرف بالمثل تجاه ترولوب؛ فهو يفتقر إلى كل ما في جيمس من غموض وسحر.
على أي حال، لعل كل هذا مجرد تفاصيل جانبية. فأنا بدأت أشك في أن السبب الحقيقي وراء اعتبار قراءة ترولوب أمرًا “غير مقبولٍ أو لائق” في عصرنا الحالي، يكمن في أنه ليس متوافقًا مع المقاييس السياسية الحديثة. أليسَ الحضور الأكثر هيمنة في أعمال ترولوب، والذي يطل على صفحات رواياته جميعها تقريبًا، هو شخصية النبيل الإنكليزي؟ فسؤال “ما هو النبيل الإنكليزي؟” يلهب تفكير ترولوب بلا انقطاع، وشخصياته لا تستطيع الوفاء بهذا المثل إلا بشكل ناقص في ألف موضع. ولا أحد يرغب في أن يُرى وهو يقرأ مثل هذا الأدب بدافع الفضول البريء. قد لا ترغب صديقتي الإنكليزية الشابة في أن يُكتشف أنها تقرأ كتابًا من كتب ترولوب أكثر مما ترغب أن يُكتشف أنها تقرأ كتابًا عن آداب السلوك. والأمر الأكثر إحراجًا، هو أن ترولوب نفسه، موظف مدني – موظف في مكتب البريد تحديدًا – منشغل بتفاصيل النبلاء والدوقات بطريقة قد تبدو سخيفة اليوم. كيف لنا نحن المؤمنين بالمساواة والمتفائلين، أن نعترف بانجذابنا لأيٍّ من هذا الفضول؟ وما لا يُطاق حقيقةً، هو أن ترولوب دائمًا ما يتحدث عن العرق والنسب والدم والتنشئة الاجتماعية، وكأنها محور الكون بأسره.
إنَّ ترولوب في الحقيقة، معقد للغاية بحيث لا يمكن لأسباب سطحية أن تنفرنا منه. فهو، أولًا وقبل كل شيء، ليبراليّ بالمعنى الحقيقي، وليس مجرد ليبراليّ من الطراز التقليدي. ففي “راعي المأوى”، كان راتب السيد هاردينغ محدّد وفق ما أقرّه التقليد، لكنه يظل عاجزًا عن تبريره لنفسه، لأنه يُستمد من صندوق مخصص لفائدة أولئك الذين تحت رعايته. يدرك ترولوب جوهر الأمور حين يكون الاعتياد محل شك، ويرى أن بعض الأحكام الإنكليزية المسبقة، أو السياسات الثابتة، قد تكون سيئة أو سخيفة. ومع ذلك، فهو يميل إلى الأساليب القديمة، وبوجه عام لا يسعى إلى تغييرها. فراتب السيد هاردينغ، في الحقيقة، لا ينبغي أن يكون أقل بكثير مما هو عليه، ولا يمكن لأولئك الذين تحت رعايته أن يستفيدوا من شلن إضافي واحد أكثر مما خصّص لهم. وعندما يستقيل السيد هاردينغ، لا يكون أثر ذلك سوى حرمان المسنين الذين تحت رعايته من قرب صديق اعتادوا الاعتماد عليه. ففي عالم ترولوب – ولنعترف بذلك – التغيير يكاد يكون دائمًا للأسوأ. رغم ذلك، يجرؤ ترولوب على السخرية من الطرق القديمة بأسلوبٍ رقيق. ففي أبراج باريستشاير، يقدم لنا شخصية الآنسة ثورن من آل أولاثورن، الأخت العزباء للمالك الريفي، المتمسّكة بعاداتها القديمة بإصرار لا يلين. تتوقع الآنسة ثورن من ضيوف الحفلات أن يشاركوا في لعبة قرون وسطى طريفة، تتضمن أن يُغطّى اللاعبون بأكياس الطحين، فتغضب حين يرفض الجميع المشاركة.
صحيحٌ أنَّ ترولوب يكنّ فخرًا للعِرق، فالفتى الإنكليزي الأشقر هو محبوب ترولوب المدلل، ومع ذلك، تظهر في أعماله نساء داكنات البشرة، قريباتٍ من الطراز الفرنسي، يتبين فيما بعد أنَّ بعضهنّ إنكليزيات، مثل ليزي يوستاس والسينيورا نيروني في “أبراج باريستشاير”، وبعضهن لطيف جدًا، مثل ماري ملموت في رواية “العالم الذي نحيا به اليوم” وواحدة منهن تصل إلى مرتبة الروعة الكاملة – مدام ماكس غوزلر في الروايات البرلمانية.
كما يمتلك ترولوب الجرأة الفكرية على ما قد يُعد مستحيلاً؛ فهو يسمح للتعليم والمعرفة أن تتفوق على الدم والنسب، بل ويقرن الزواج بما قد يخرق الأعراف التقليدية. ففي رواية “الدكتور ثورن”، يقدم لنا بطلة رومانسية، رغم رقتها وتهذيبها، إلا أنها من أصل متواضع وابنة غير شرعية. أما في رواية “أبناء الدوق” يضطر بلانتاجانت باليزر، أعظم الليبراليين في عالم ترولوب، إلى تزويج كل من أبنائه، لشخصيات لطيفة وذات فضائل عالية، كان طوال الرواية يعتقد أنها بعيدة المنال. ندرك في النهاية أن فكرة “النبيل الإنكليزي ” التي أولع بها ترولوب ليست هاجسَ متكبّرٍ أرستقراطي، بل هي في جوهرها نزعةٌ ماكرة نحو المساواة. ففي روايةٍ تلو الأخرى، نراه يصوّر شخصياته وهي تدافع عن أصدقائها أو أحبّتها من ذوي المراتب الأدنى أو الأنساب المتواضعة، قائلة: “إن كان رجلًا نبيلاً – أو كانت سيدة بحق – فأي فرقٍ يصنع الأصل أو المقام؟”
وفي نهاية المطاف، يظل قلم ترولوب ودودًا رحبًا ومتسامحًا، يفيض روحًا من السكينة الإنسانية والاعتدال الأخلاقي. ومن هنا، لا ينبغي أن يكون في قراءة ترولوب ما يُستنكَر. لكن هذا يقودني إلى تساؤل آخر: ما الذي يجعل قراءته مجزية إلى هذا الحد؟ لماذا لا يزال حاضرًا على رفوف المكتبات دون انقطاع؟ ولماذا، في هذه اللحظة تحديدًا، هناك قرّاء في شتّى أنحاء العالم يستغرقون في صحبته، متلفّعين بدفء كلماته؟ وبطبيعة الحال، نقرأ ترولوب – كما نقرأ جين أوستن – من أجل كوميديا المجتمع؛ ذلك الفنّ الذي أتقنه ببراعة لا تُجارى. غير أنّ في ترولوب ما يتجاوز أوستن؛ ولا أعني بذلك أنه أعظم منها، بل أنه أوسع أفقًا وأغزر عالَمًا. فعالم ترولوب أكثرَ ذكوريةً، وأكثر حركةً وقلقًا من عالم جين أوستن. إنه عالم المضاربات المالية، وسكك الحديد الحديثة العهد، وتقلّب الإدارات، ومشروعات الإصلاح، والشكّ في رجال الدين الراسخين في مؤسساتهم. يكتب ترولوب قصص حبّ كما تفعل أوستن، لكنّ شخوصه يعيشون تحت وطأة ضغوطٍ هائلة. إنّه واقعيّ حتى العظم. فالرجل في روايات ترولوب، إذا أثقلته الحاجة – كما يحدث في معظم الأحيان – لا يختفي كما يفعل نظراؤه عند جين أوستن أو هنري جيمس، لا يُنفى إلى مستعمرة نائية، ولا يُلقى به في مكتبٍ بائسٍ في المدينة ليجرب حظّه. بل يبرم بعضهم صفقاتٍ حقيقية في مشروعات سككٍ وهميّة، ويعقدون اجتماعاتٍ فعلية لمجالس إدارةٍ زائفة، ويقترضون في مشاهد مؤلمة أموالًا حقيقية من أشخاصٍ طيّبين حدّ السذاجة في قلب لندن المالية. قال هنري جيمس ذات مرة إنّ كلَّ شيءٍ يحدث في حفلات العشاء. أما في روايات جين أوستن، فالأحداث تقع أيضًا في الحفلات الراقصة والنُّزهات وحدائق المنازل وغرف الاستقبال. وأظنّكم تأذنون لي بالقول إنّ هذه الفضاءات ذات طابعٍ أنثوي إلى حدٍّ بعيد. لكنّ الأمور في عالم ترولوب تجري على نحوٍ مختلف؛ فهي تحدث في نوادي الرجال – من النوع الراقي مثل نادي الإصلاح، ومن النوع المشكوك فيه مثل نادي بيرغاردن الذي لا يمكن نسيانه – كما تقع في المكاتب المغبرّة في المدينة، وفي أروقة المحاكم، وفي مساكن العزّاب، بل وتحت قبة مجلس العموم ذاته.
ثم انظروا إلى عالم ترولوب، إلى ما تزخر به رواياته من شخصيّات! فعنده تنضمّ إلى أولئك المتأنّقين من الطبقة الوسطى الذين وصفتهم جين أوستن في باث، وإلى نبلائها المتعالين المعتدّين بأنسابهم، طائفةٌ جديدة من الوجوه: تجّار رحلاتٍ يبيعون أثاثًا معدنيًّا فظيعًا، ومضاربون ماليّون نصّابون على مستوى عالمي، وصحفيون متنفّذون شعبويّون، وأعضاء في حكومة صاحبة الجلالة. ولا بدّ من الاعتراف بأنّ ترولوب، حتى في أروع رواياته، يمنحنا أحيانًا بطلاتٍ مملّات – حكيماتٍ وصالحاتٍ نعم، ولكن مملّات. ومع ذلك، يعوّض هذا الخلل بفيضٍ من النساء المدهشات، اللواتي لا يمكن نسيانهنّ. فهناك الفتاة الصاخبة ڤيولا إفنغهام التي تقتحم سلسلة “الروايات البرلمانية” في ڤينيس فين، وليزي يُستاس الذكية الفطِنة على نحوٍ عفويّ، والليدي كارْبري المستقلة في “العالم الذي نحيا فيه اليوم”، والليدي لورا الطموحة التي تهيم بحبّ ڤينيس، والسيدة براودي المتسلّطة، الأسقف الحقيقي لمدينة بارچستر. ثمّ هناك السنيورة نيروني المفعمة بالإغراء، التي تفوح منها هالة من “العطر” تكفي لأن تُغري من يقف بقربها أن يمدّ يده إليها. وهناك أيضًا النساء الحكيمات العارفات بالعالم، الناضجات بحقّ، مثل مدام ماكس، وفي المقابل، النساء الساذجات البريئات، غير العالمات، اللواتي لا ينضجن أبدًا، مثل الليدي غلين. جميعُ هؤلاء الأشخاص يمتلكون في عالم ترولوب واقعيةً نابضةً بالحياة. ففي رواياته، كما أراد لها، لا نجد أشرارًا خُلّصًا ولا قدّيسين مطلقين؛ بل بشرًا متناقضين، يجتمع فيهم النبل والضعف كما هو الحال فينا جميعًا. حين يُرفع الستار عن أبراج بارچستر، نرى رئيس الشمامسة غرانتلي واقفًا ينتظر موت أبيه الأسقف، وفي قلبه مزيجٌ من الحبّ الحقيقي والحزن العميق والاحترام البنوي الصادق. ومع ذلك، وفي اللحظة نفسها، يتمنّى – في أعماق نفسه – لو أن أباه يُسْرِع إلى الموت، إذ إنّ الحكومة إن سقطت قبل أن يرحل الأب، فسيضيع على غرانتلي أمله في أن يُعيَّن خلفًا له في الأسقفية. ومع هذا، يجعلنا ترولوب نغفر له، بل نتعاطف معه؛ إذ يُقنعنا بأنّ طموحه الدنيوي مفهومٌ إنسانيّ، وبأنّ حبَّه وحزنه واحترامه لأبيه صادقٌ لا غبار عليه. ثم، تأمّلوا الليدي كارْبري في رواية “العالم الذي نحيا فيه اليوم”، وهي تنسج خيوط مكرها لتظفر بمراجعاتٍ مشيدةٍ بكتابها الزائف الطابع، “ملكات الجريمة”. ثلاثةُ محرّرين عند قدميها، وهي مستعدة لأن تُقدِّم… لا كلَّ ما عندها، ولكن ما يكفي لتغويهم تمامًا. وهي تفعل ذلك فعلًا – تسحرهم جميعًا، وتسحرنا نحن أيضًا. فما العجب؟ إنّ ترولوب ابنُ أمّه بحقّ؛ فـفرانسِس ترولوب قد عاشت من قَلَمها، ورسمت لنا، في كتابها “العادات المنزلية للأمريكيين”، صورةً ما تزال تُقرأ إلى اليوم. لقد أدرك ترولوب أنّ النساء المستقلّات ذوات المواهب المتواضعة عليهنّ أن يشققن طريقهنّ في عالمٍ لا يرحم، وأنّ حِيَلَهُنَّ الصغيرة، مهما بدت براقة أو محسوبة، تُخفي وراءها شجاعةً تستحقّ الإعجاب، لا السخرية – ولهذا يجعلنا نبتسم لهنّ، بإعزازٍ لا استهزاء. سألني أحد الأصدقاء مؤخرًا سؤالًا بالغ الطرافة:
ماذا لو تناول ترولوب القصة التي كانت تشغل الرأي العام آنذاك- قضية فشل زوي بيرد في نيل ترشيحها لمنصب المدّعي العام في إدارة كلينتون الجديدة؟ كيف كان سيتعامل ترولوب مع ما سُمِّيَ بـ”انتهاكها” لقوانين الهجرة التي كانت ستتولى تطبيقها؟
أظنّ أن ترولوب كان ليدع حياتها تتحطّم أمام أعيننا، وليُهيِّئ نصرًا مدوّيًا لأولئك الكاشفين عن الفضائح في صحيفة جوبيتر “المشتري” – تجسيده الروائي لصحيفة التايمز – تمامًا كما فعل في رواية “راعي المأوى”.
لكنّ القارئ، في النهاية، كان سيدرك أن ترولوب يرى في هذا الانهيار الصاخب نوعًا من الوعظ الأخلاقي الفارغ والعبث الممجوج، كما رأى الأمر ذاته في مصير السيد هاردينغ “راعي المأوى”. وفي رواية “الدكتور ثورن”، نجد شخصيةً ثانوية هي المحامي رومر، يعمل لصالح المحافظين في انتخابات المقاطعة. يشتكي إلى السيد رومر صاحبُ حانةٍ محبّ للشراب، يمتلك نفوذًا انتخابيًا، من أنّ فاتورته – ويُرجَّح أنّها ثمن البيرة – لم تُسدَّد بعد الانتخابات الأخيرة. يشير رومر بهدوء إلى أنّ الامتناع عن الدفع كان نتيجة خلاف على الحساب، ولكن صاحب الحانة يصرّ على موقفه أيَّما إصرار قائلًا:
“يحبّ الرجل أن تُسدَّد فاتورته الصغيرة”.
عندها، وبروح طيّبة، يدفع رومر الفاتورة، ويبدو كل شيء على ما يرام. ولكن، عندما تنتصر القوى المحافظة، يكتشف الليبراليون تساهل رومر مع صاحب الحانة، فتثور صحيفة “المشتري” مدوّية، معلنةً أنّ رومر قد اشترى الانتخابات. فتغدو الحياة في إنكلترا مستحيلة على رومر، ويجد له أصدقاؤه ملاذًا بعيدًا في هونغ كونغ. والأسوأ من ذلك، أنّ المتعصّبين البرلمانيين يطالبون باستدعائه من هونغ كونغ ليواجه العار والدمار الكاملين. كل هذا، رغم أنّ ترولوب يشير بذكاء إلى أنّ جميع أعضاء البرلمان حينها قد جلسوا في مقاعدهم بعد أن دفعوا من أموالهم ما يعادل – بل أكثر- مما دفعه رومر ليحصل على منصبه ويحتفظ به. إنّ قصة السيد رومر، في جوهرها، تشبه كثيرًا قصة السيد هاردينغ في “راعي المأوى”. ومن هنا، أرى أنّ ترولوب كان سيُهلك زوي بيرد، لكنه لن يقف إلى جانب أولئك الذين يُدمّرونها بانتصارهم. قد أكون مخطئةً، لكن في “مزرعة أورلي” ترتكب الليدي ميسون زلةً أشدّ خطورةً من زلة بيرد، وكل ذلك من أجل خير أولادها، وبحقٍّ عادل لهم. تُبرَّأ في المحكمة، لكن ترولوب يرى أنّ العملية القانونية مجرد خدعة محتقرة. ورغم البراءة، ورغم تعاطفه ومحبته لها، يجعلها تتحمّل عقوبةً شديدة، لدرجة أنّ تضحياتها بنفسها، لا يراها سخيفة أو وعظية، بل يقدّرها مع أسى ويعتبرها لازمة. ومع ذلك، يبدو لي أنّ ترولوب الأخلاقي المتألم في “مزرعة أورلي ” أقلّ إقناعًا وأقلّ تمثيلًا لذاته الحقيقية مقارنةً بـ ترولوب المشكك اللاذع، الماكر في مقاربة مصائر هاردينغ ورومر.
يمتاز ترولوب بالسعة والشمول في تصوره الأدبي. تتطوّر شخصياته عبر مدى زمني طويل، وكتب ضخمة، وأحيانًا نصف دزينة أو أكثر من الكتب، متشابكة في علاقاتها المعقدة، ممتدةً إلى الأجداد وحتى الجذور الأسرية الأبعد. ولفهم اتساع رؤيته الأدبية، يجب أن نُدرك أنّ روايات “باريستشاير” و”الروايات البرلمانية” ليست مجموعتين منفصلتين كما نجدهما اليوم في النسخ المجلدة. بل هما ككل متكامل أكثر بكثير من مجرد مجموعتين منفصلتين. فتصبح كتب الكهنوت في باريستشاير جزءًا من الروايات البرلمانية، وتتشابك الروايات البرلمانية بدورها مع أحداث باريستشاير. فهناك، في باريستشاير، يقف سكاتشدَر، إمبراطور السكك الحديدية، والمدمن على الشراب، كرمز للبرلمان. ويلتقي بطل الروايات البرلمانية الخجول، أو قُلْ اللا-بطل، بلانتاجانيت باليزر بحبه الأول في جزءٍ من أجزاء باريستشاير، البيت الصغير في ألّينغتون – حُب لما قبل غلينكورا، الذي لم يُذكر إلا ضمن إشارات عابرة في الروايات البرلمانية.
أما في “دوق أومنيوم”، ذلك العجوز المتأنق الفاسق، فيتولى الرئاسة في قلعة جاتروم في كلا السلسلتين: في “الدكتور ثورن” كما في “ڤينيس فين”، وحتى خارج هاتين السلسلتين، في “العالم الذي نحيا فيه اليوم”. قد يكون تطور هذه الشخصيات متسرعًا أحيانًا، إذ يقتل ترولوب بعضهم بين كتاب وآخر، فقط لكي يفسح المجال لشخصية جديدة. والكتب نفسها ليست متسلسلة بالمعنى التقليدي؛ فالشخصيات تتسلل إلى الكتاب التالي، لكنه ليس عالمها بعد الآن، بل قصة شخص آخر. يُتابع ترولوب عشرات الشخصيات بدقة، وحتى ضمن حدود كتاب واحد، فيشعر القارئ بعظمة الفكر الذي استطاع ابتكار هذه العوالم، ونسجها بعناية لتصبح عوالم ضمن عوالم. وهذا، بلا شك، ليس مجرد “كوميديا اجتماعية”؛ بل هو كوميديا الإنسان بكل تناقضاته. أحيانًا يكون التأثير مذهلًا، وكأنّه من عالم آخر. ففي “البيت الصغير في ألّينغتون”، عندما نسمع لأول مرة عن الليدي غلينكورا، يقتصر الأمر على خبرٍ وحيد: أنّ بلانتاجانيت باليزر مخطوب لها. وعندما نلتقي بها لاحقًا في رواية “هل تستطيعين مسامحتها؟”، فهي ليست البطلة الرئيسة للعنوان، بل شخصية ثانوية عابرة. ولكن فجأة، يستقبلها ترولوب كما لو كانت صديقةٌ عزيزةٌ قديمة، فيمنح القارئ شعورًا بأنّه يحتفظ بمودة قديمة تجاهها، وكأن كل أحداث قصتها في الكتب الخمسة القادمة مألوفة له قبل أن يكتبها. ويقشعر بدنك عند هذه التحية الأولى للليدي غلين، تمامًا كما يقشعر بدن المرء عند سماع البوق الفرنسي وهو يرحّب بكلارا في الحركة الأخيرة من السيمفونية الأولى لبراهامز. وباستثناء رواية “راعي المأوى”، الجوهرة المتقنة، فإنّ هذه الكتب ليست كتبًا صغيرة ومرتبة بعناية، بل هي فسيحة وفوضوية بطريقتها الخاصة. ولكن عندما يُخبرك ترولوب بصراحة منذ البداية أنّ البطلة ستتزوّج بالبطل، فإنه واثق تمامًا من أنّك ستستمتع برحلته الأدبية مهما حدث. وفي هذه الكتب الواسعة، هناك مجال لكل أنواع المتع، وأهمها مشهد ترولوب المميز لمطاردة الثعالب. ففي منتصف معظم كتبه، بل في أفضلها من الروايات البرلمانية، نجد مشهد صيد متقنًا، حيًّا ومتحركًا. خلال هذه المطاردة، تتحرك الأحداث، وتتغير حياة الشخصيات، ومع ذلك تشعر وكأنك كنت في الميدان بنفسك، تصوب البندقية، وتلاحق الثعلب بين التلال. ولا أعني بذلك فقط أنّك تدخل إلى المناظر الطبيعية الإنكليزية على طريقة الفنان كونستابل، التي ينسجها ترولوب ببراعة فائقة، رغم أنّك تفعل ذلك أيضًا، بل إنّك تشعر بكل حواسّك، تشعر بالهواء العليل، برائحة العشب، بصخب الكلاب والخيول، وبنغمة المغامرة التي تملأ المكان. هناك رحلة مطاردة الثعلب على طريقة ترولوب، تبدأ من اللحظة التي تنتظر فيها على صهوة جوادك، متلهفًا لحدوث شيء ما (وما يحدث غالبًا هو تناول الغداء على ظهر الحصان)، وتمتد إلى اللحظة التي يُكتشف فيها الثعلب، فتتبع عن كثب رئيس الصيادين وتنطلق نحو المغامرة والخطر. الميدان مليء بالحياة: هناك الكلاب النابحة، والمتسكعون والمتواكلون على الآخرين، ورجال المقاطعة البارزون، والنساء الحازمات اللاتي يعرفن جيدًا ما يفعلن، والرياضيون الحكماء الذين يعرفون متى لا ينبغي السماح للحصان بالقفز فوق السور، والمخادعون الذين يختصرون الطريق ليصلوا إلى الثعلب دون أن يواجهوا أي خطر حقيقي. وتُعدّ مطاردات الثعالب هذهِ، واحدة من الجواهر النادرة للأدب الإنكليزي. يكمن أسلوب ترولوب الفريد في أنه، وسط صفحاتٍ ممتلئة بالحوار المليء بالسخرية والتوتر، يفتح لنا المونولوجات الداخلية الرائعة لشخصياته. فهو مهتم بما قد يفعله الناس في موقف معين، وطريقته الخاصة -التي يمكن وصفها بأنها “افتح صفحة عشوائية وستجدها”- هي أن يغوص في وعي الشخصية، ويسمح لنا بمراجعة الموقف من منظورها الخاص. وعادةً ما تكون هذه المواقف موترة ومشحونة بالتوتر، وهذا ما يجعل السؤال عن زوي بيرد مناسبًا تمامًا. في “العالم الذي نحيا به اليوم”، نجد عشاء ميلموت للإمبراطور الصيني موصوفًا عبر صفحات متتابعة من الحوار الهزلي الذكي؛ ثم، في لحظة يأسه، يخوض ميلموت مونولوجًا داخليًا غارقًا في التأمل، والاستياء، والوهم الذاتي، لكنه في الوقت نفسه، مدركٌ لواقعه، وهو يراقب المشهد ويتأمل مستقبله. هذه هي تراتيب ترولوب الأصيلة بكل ما تحمله من براعة فنية وتمثيل نفسيّ دقيق. إن التحولات الأنيقة في الحبكة تُحوّل مخاوف الشخصيات وتحليلاتهم الداخلية إلى تجربة حية للقارئ. ففي قصة زوي بيرد، كان ترولوب سيمنحنا نافذة على مونولوجها الداخلي: هل تتقدم لشغل المنصب الوزاري؟ هل تكشف عن هفوة صغيرة لفريق كلينتون؟ أم هل تنسحب؟ كل خيار من هذه الخيارات يُحلَّل ويُدار داخليًا بطريقة تتيح للقارئ فهم الصراع النفسي في كل خطوة. وفي عائلة السيد سكاربورو أو ألماس إيستاس، يتجلّى براعة ترولوب في استكشاف تأثير التغييرات على حياة شخصياته الداخلية: وصايا سكاربورو المتغيرة، أو مكان ألماس إيستاس المتنقل. تجادل الشخصيات نفسها حول كيفية نشوء الأمور، وحول خياراتها المتاحة؛ تستسلم أم تصمد أمام نقائصها، تبرّر أو ترفض التبريرات، بحيث تصبح كل لحظة من تصرفاتها نافذة إلى تناقضها الإنساني المستمر. وعندما تتحدث الشخصيات أو تكتب رسالة، قد يُحرِّك كل خيطٍ من هذه الخيوط الداخلية كلماتها، مما يجعل تصرفاتها المتقلبة كتابًا مفتوحًا أمام أعيننا. أفضل المشاهد لدى ترولوب هي تلك التي تتلاقى فيها الشخصيات في مواقف مشحونة بالتوتر، تتصارع، وتكشف عن نفسها- إن لم يكن لبعضها بعضًا، فلبعضنا نحن القراء. وكما يحب السيد سكاربورو المخادع أن يفاخر بزهوٍ مستحق:
“إنها خير من أي عرض مسرحي.”
وها أنا ذا، مرة أخرى أسير صوب سحر ترولوب الذي يأسرني. وبداخلي شعور طفيف بالحزن عند الشروع في إعادة قراءته، فحتى أعظم المتع الأدبية تصل إلى نهايتها، سواء شئنا ذلك أم أبينا. لكن ما يبعث على الاطمئنان هو أنّ مع هذا الكاتب السخيّ بلا حدود، النهاية لا تزال بعيدة جدًا، ومتعته لا تزال ممتدة أمامنا.
