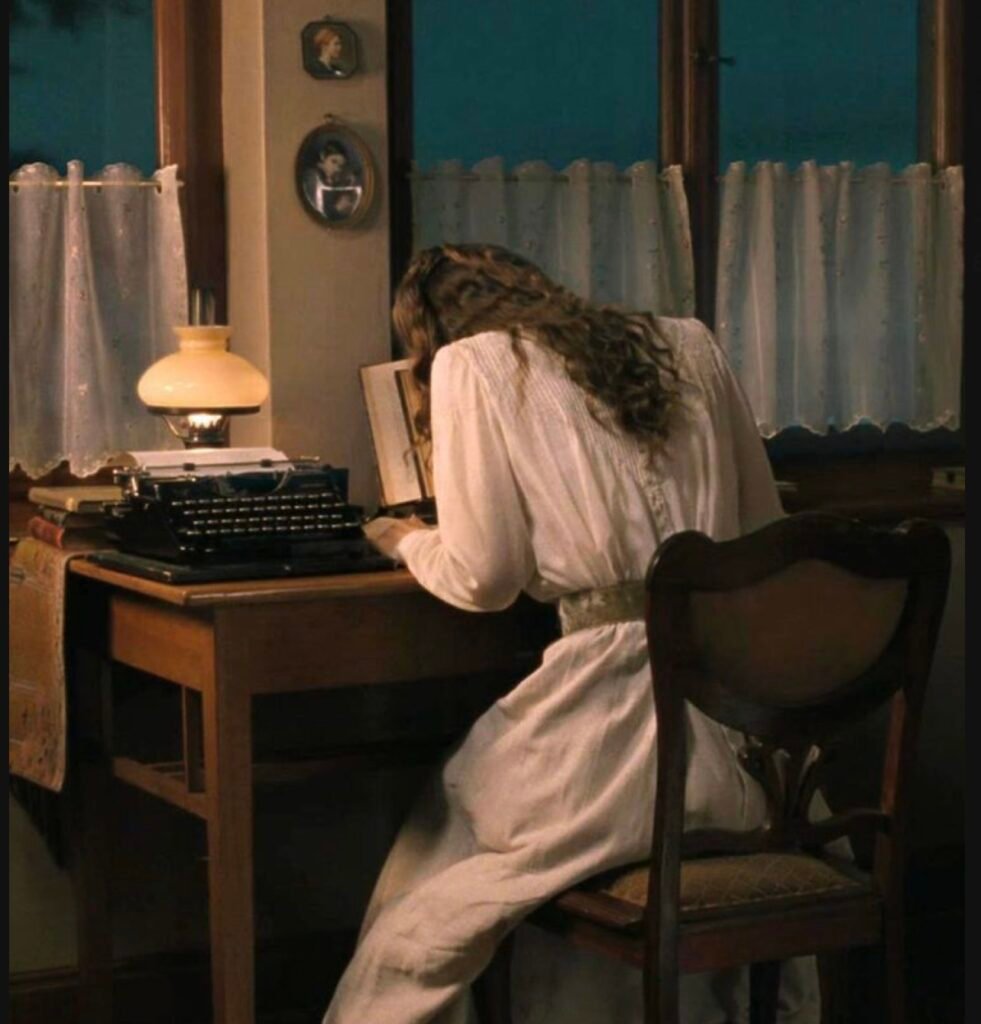Posts by نوره بابعير
الفلسفة وإتقان الحوار: من تشكّل الهوية إلى وعي الأثر
نوره بابعير
يُعدّ الحوار أحد أرقى أشكال التعبير الإنساني، إذ لا يقتصر على تبادل الألفاظ، بل يتجاوز ذلك ليصبح مرآة للهوية، ونتاجًا للفكر، وميدانًا تتجلّى فيه الأخلاق والسلوكيات. ومن هنا، تستمدّ الفلسفة جوهرها العميق في إتقان الحوار مع الإنسان والآخرين، بوصفها علم التساؤل، وفن الفهم، ومنهج البحث عن المعنى.
تنطلق الفلسفة من سؤال الذات قبل سؤال الآخر، فالحوار الحقيقي لا يبدأ من الخارج، بل يتكوّن أولاً داخل الإنسان نفسه. حين يختار الفرد طريق تفكيره، تتشكّل هويته الذاتية، وتتبلور مواقفه، وتُبنى منظومته القيمية التي تحكم طريقة تفاعله مع العالم. هذا الاختيار الفكري لا يحدث بمعزل عن الوعي، بل هو حصيلة تراكم معرفي وتجربة إنسانية، تتحوّل مع الزمن إلى قناعة، ثم إلى خطاب.
ومن هنا، ترتبط الهوية الذاتية بالألفاظ والكلمات ارتباطًا وثيقًا؛ فالكلمة ليست مجرد أداة لغوية، بل هي وعاء للفكر، وحامل للمعنى. وكلما نضج الفكر، ارتقت اللغة، وتحولت من تعبير سطحي إلى خطاب واعٍ قادر على التأثير. فالارتقاء الفعلي للحوار لا يتحقق إلا حين تنسجم الفكرة مع اللفظ، ويتوازن المحتوى مع الأسلوب، ليخرج الحوار صادقًا في أدائه، عميقًا في دلالته.
إن نجاح الحوار مرهون بوجود قواعد ذاتية تحكم أداءه، وتمنح الإنسان القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ في اختياراته الحوارية. فالحوار ليس ساحة للغلبة، بل مساحة للفهم. وليس وسيلة لفرض الرأي، بل جسر للتقارب. وعندما يدرك الإنسان هذه القواعد، يصبح الحوار أداة تخدم الفكر واللفظ معًا، في توازٍ يحفظ للمعنى قيمته، وللآخر إنسانيته.
ولا يمكن إغفال الدور الجوهري للسلوكيات والأخلاقيات في بناء الحوار. فالبدايات التي تُطرح على الإنسان في علاقته بالآخرين هي التي تحدد مسار الحوار، إما أن يتمدد وينمو، أو أن ينتهي ويتلاشى. والسلوك الإنساني هو العامل الحاسم في توليد القبول أو الرفض، وهو ما يكشف عن قيمة الأخلاق الذاتية في إدارة الحوارات. فحين يتحلى الإنسان بالاحترام، والإنصاف، والقدرة على الإصغاء، يجد طريقه نحو حوار مثمر، حتى في الاختلاقات .
تسهم الفلسفة في إتقان الحوار حين تجعل الإنسان مدركًا لقوة “الضوء” الكامن فيها؛ ذلك الضوء الذي يتمثل في الوعي، والدافع الداخلي نحو الفهم، والبحث عن المعنى العميق بدل الاكتفاء بالسطحي. فالفلسفة لا تعلّم الإنسان ماذا يقول فقط، بل كيف يفكر قبل أن يقول، وكيف يزن كلماته بميزان العقل والأخلاق. وعندما يحدث هذا الإدراك، تتغير مجريات الحياة، وتتبدل المفاهيم، ويصبح الإنسان أكثر إنصافًا في ترتيب اختياراته، وأكثر اتزانًا في أحكامه.
طرق تساعد الإنسان على صناعة حوار جيد يترك أثرًا واعيًا:
1. الوعي بالذات قبل الحوار: أن يدرك الإنسان دوافعه، ونقاط قوته وضعفه، وأن يسأل نفسه: لماذا أتحاور؟ وما الهدف من هذا الحوار؟
2. الإصغاء العميق: فالحوار لا ينجح بالكلام وحده، بل بالقدرة على الاستماع الحقيقي، وفهم ما وراء الكلمات، واحترام وجهة نظر الآخر.
3. التوازن بين الفكر واللغة: اختيار الألفاظ بعناية، بحيث تعبّر عن الفكرة دون إساءة أو تعالٍ، وتخدم المعنى بدل تشويهه.
4. الالتزام بالأخلاق الحوارية: مثل الصدق، والاحترام، والإنصاف، والابتعاد عن السخرية أو التقليل من شأن الآخر.
5. الانفتاح على الاختلاف: تقبّل التباين في الآراء بوصفه مصدرًا للثراء الفكري، لا تهديدًا للهوية الذاتية.
6. تحويل الحوار إلى تجربة إنسانية: بحيث يخرج الطرفان بشيء من الفهم، أو مراجعة الذات، أو إعادة التفكير، لا بمجرد الانتصار الجدلي.
ويبقى الحوار الفلسفي أداة للارتقاء الإنساني حين يُمارس بوعي، ويُبنى على أخلاق، ويُوجَّه نحو المعنى. وحين يدرك الإنسان أن كل حوار هو فرصة لترك أثر، لا لإثبات ذات، يتحول الحوار من مجرد كلمات متبادلة إلى فعل حضاري يسهم في نضج الفرد، ورقي المجتمع .
قصّة قصيرة جدًا: الذئب.
يوسف يونس
الذئب
في أقصى الشرقِ لقريتنا، هناك في البعيدِ، يسكنُ ذئبٌ يكرههُ كلُّ مَن في القريةِ. كثيرًا ما كنتُ أسمعهم يَصِفونَه بعباراتٍ يشوبُها الحنقُ من قبيلِ: الشريرِ! القاتلِ! الخدّاعِ! يُقالُ إنَّه التهمَ أكثرَ من حقِّه من محصولِ الصيفِ، ولطَّخَ حقولَ القمحِ الذهبيّةَ بدماءِ المساكينِ ممّن لا يستطيعون في وجهِه دفاعًا. وكنتُ أسمعهم يتهامسونَ في المساءاتِ الهادئةِ، خِفيةً، عن شراستِه في التهامِ زهورِ الأقحوانِ في أيدي الصبيةِ، وعوائِه المحمومِ عندَ مصبِّ النهرِ، ووقاحتِه غيرِ المتناهيةِ في أنَّه يفكِّرُ بتنصيبِ سلالتِه أُمناءَ على أعناقِنا، وحُرّاسًا لكرومِ العنبِ التي بات يفوحُ منها رائحةُ لُعابِ عائلتِه القذرِ. كثيرًا ما فكرتُ في الأمرِ لأضعَ له حلًّا ما، إمّا بمواجهةِ الذئبِ الشريرِ لأجعلهِ ينتهي عن أفعالِه الشنيعةِ تلك، أو بمحاولةِ إشعالِ تمرّدٍ من أعضاءِ القريةِ الذين قد يتحلَّون بشيءٍ من الشجاعةِ. ولكنَّ الذئبَ كان قليلَ الظهورِ، ينزوي في أكثرِ الأماكنِ حُلْكَةً وغموضًا – كما يقولُ فئةٌ قليلةٌ من الأشخاصِ الذين يدّعون أنَّهم قابلوه في أزمنةٍ غابرةٍ – ولم يره أحدٌ منذُ زمنٍ طويلٍ. غيرَ أنَّه في ليلةٍ قمراءَ، كنتُ أجلسُ في فناءِ منزلِنا أرقًا، بعد أن توقَّفت أصواتُ الصفيرِ والموسيقى الصاخبةِ من عرسٍ في الجوارِ لأحدِ العائلاتِ الثريّةِ في القريةِ. أظنُّه عرسُ ابنةِ سرحانَ أبو الخيرِ، أحدِ أفرادِ عائلةِ أبو الخيرِ الكبيرةِ التي تمتلكُ كثيرًا من النفوذِ والأراضي داخلَ القريةِ، ممّا يجعلُ الجميعَ يقدّرونها ويمنحونَها منزلةً عظيمةً. فهم – على حسبِ قولِ أهالي القريةِ – لم يبخلوا على أحدٍ قطُّ، وبدمائِهم سقَوا ترابَ القريةِ للدفاعِ عنها ضدَّ العدوِّ، كائنًا مَن يكونُ. كان العرسُ صاخبًا، كعادةِ أعراسِهم – فهذه الصبيةُ الثالثةُ التي تتزوّجُ تاجِرًا كبيرًا من خارجِ القريةِ – تتخلَّله أصواتُ إطلاقٍ ناريٍّ وهديرُ طبولٍ عميقٍ، ممّا جعل النومَ يهربُ من عينيَّ. في هذه الأثناءِ من هدأةِ الليلِ، لمحتُ الذئبَ في المدى وحيدًا يتهادى في سيرِه في قلبِ الظلامِ. فكّرتُ أن أعودَ القهقرى، ولكنَّ الذئبَ كان يبدو جميلًا، وله من اللمعانِ ما يكفي ليستأثرَ بانتباهِ مَن يراه. حثثتُ الخطى وقد استهلكَ منّي الأمرُ شجاعةً كبيرةً، ودنا بدورِه ببطءٍ نحو فناءِ منزلِنا بعد أن شقَّ طريقَه عبرَ السهلِ، إلى أن صار منّي على مسافةِ صفرٍ، غيرَ آبهٍ بتلك العصا التي أحملها، وجعل يحكُّ فروهُ الأسودَ الكثيفَ بساقَيّ المسمرّتَينِ في مكانِهما من الخوفِ. ترددتُ قبلَ أن أداعبَ وجهَه برفقٍ، ممّا حمل الذئبَ على أن يشرئبَّ بعنقِه إلى الأعلى فأعلى، مطلقًا من صدرِه أنينًا شديدَ العمقِ. جلستُ القرفصاءَ لأرى في إحدى ساقيهِ جرحًا عميقًا غائرًا. نام الذئبُ على جنبِه وقد زاد صوتُ أنينِه عمقًا، غيرَ أنَّه الآن جاءَ موجِعًا أكثرَ. توهّمتُ أن هناك رصاصةً داخلَ الجرحِ، فهرعتُ نحو المطبخِ لآتي بملقطٍ كي يتسنّى لي التقاطُ الرصاصةِ، وخرقةٍ قماشيةٍ ألفُّ بها ساقَه بعد أن أغسلَ له الجرحَ. ثبّتُّه على الأرضيةِ، وأمسكتُ بحذرٍ ساقَه، وباليدِ الأخرى أدخلتُ الملقطَ داخلَ الجرحِ الذي كان ينزفُ بشدّةٍ، وأخرجتُ الرصاصةَ برفقٍ. كانت تلك رصاصةَ بندقيةِ صيدٍ ثمينةً، من التي تبتاعُها عائلةُ أبو الخيرِ ويضعونَها زينةً على كلِّ جدارٍ من جدرانِ منزلِهم. ويبدو أنَّها استقرّت في ساقِ الذئبِ أثناءَ إطلاقِ رصاصٍ في الهواءِ خلالَ احتفالِهم بالعرسِ. وضعتُ الرصاصةَ المدمّاة على طاولةٍ قريبةٍ، ثم بعد أن لففتُ ساقَه، وبعد أن انتهى من شربِ الحساءِ الذي صببتُه في الطشتِ، أحضرتُ له غطاءً كي يتمكّنَ من الراحةِ أو النومِ بقيةَ الليلِ. أمضيتُ قليلًا من الوقتِ في تنظيفِ الملقطِ من الدماءِ وغسلِ الطشتِ قبل أن أستلقي على أريكةٍ عند عتبةِ فناءِ المنزلِ. كان الذئبُ ينامُ على جنبِه، واستطعتُ أن أرى ارتعاشاتِ جسدِه القلِق قبلَ أن يغرق تدريجيًا في النومِ، فيغلبني النعاسُ معه، وأنامَ حتى أيقظني الفجرُ. تفتّحت عينايَ لأولِ خيطٍ من خيوطِ الشمسِ. نهضتُ ببطءٍ، وتراءى لي مكانُ الذئبِ الأسودِ خاليًا. تقدّمتُ رويدًا رويدًا أتطلّعُ يمنةً ويسرةً، ولكن ما من أثرٍ. نظرتُ صوبَ المدى الذي كان عندئذٍ يتلوّنُ بلونِ السماءِ بزُرقةٍ مهيبةٍ. بدا لي المدى مرعبًا من فرطِ اتساعِه وتركيزِ هدوئِه. خمّنتُ أن يكون قد عدا إلى البعيدِ وقد استوحشَ ضيقَ المكانِ، أو أنَّه قرّر ببساطةٍ المغادرةَ. ولكن كيف؟ إنَّ جرحَه لا يزالُ حديثًا، ومن شبهِ المستحيلِ أن يكون قد التأمَ. اقتربتُ من الموضعِ الذي نامَ فيه، وقد هممتُ بإمساكِ الغطاءِ، عندها بزغَ الذئبُ من بينِ الأشجارِ الصغيرةِ يعدو عدوًا مندفعًا، بيدَ أنَّ عرجًا في ساقِه المصابةِ كان واضحًا. وثبَ نحو صدري باندفاعٍ كبيرٍ غيرَ آبهٍ بالإصابةِ. سقطتُ معه على الأرضيةِ الصلبةِ، وراح يلعقُ يديَّ اللتين كنتُ أحمي بهما نفسي خوفًا منه. كان يلهثُ بشدّةٍ، وتراءت لي عيناهُ بوضوحٍ أكبر هذه المرة: مفتوحتينِ على اتساعِهما، ويبدو عليهما لمعانٌ غريبٌ. نهضَ من فوقي. راقبتُه باندهاشٍ وهو يتعثّرُ بخطوهِ في الباحةِ بصورةٍ لا تخلو من البهجةِ، ثم راح يعدو إلى السهلِ، وغاب بعد ثوانٍ معدوداتٍ في المدى الواسعِ. أطلقتُ من صدري زفيرًا طويلًا، واستغرقتُ في التفكيرِ بأشياءَ كثيرةٍ في مكاني، قبل أن ألمحَ على الأرضِ الرصاصةَ المضرَّجة بالدماءِ التي استقرّت في ساقِ الذئبِ وقد سقطت من الطاولةِ عندما أطاحَ بي أرضًا منذ قليلٍ. أثارَ منظرُ الرصاصةِ فيَّ سخطًا شديدًا. ولم أستطع أن أمنعَ نفسي، وأنا أحدّق في المدى الواسع، من أن أتمتمَ بحنقٍ: أيُّها الذئبُ! الشريرُ! القاتلُ! الخدّاعُ!
حين تختارنا الأسئلة: كيف تبدأ قصة الفلسفة الفكرية؟
نوره بابعير
تبدأ الفلسفة الفكرية منذ اللحظة الأولى التي يُلقى فيها السؤال على الإنسان، لا بوصفه استفهامًا عابرًا، بل كشرارة توقظ العقل من سباته. فالسؤال هو الحدّ الفاصل بين السكون والحركة، بين التلقي الأعمى ومحاولة الفهم. وما إن تُطرح الأسئلة، حتى يبدأ العقل في التفاعل معها، متجاوزًا حدود المعرفة السطحية، باحثًا عمّا يكمن خلف المعنى الظاهر.
لكن، هل المحرّك الأساسي لتفعيل المعرفة هو الرغبة في الحصول على الإجابة؟ أم أن التحليل الذي يحدث أثناء البحث هو الإجابة الحقيقية بذاته؟ يبدو أن الإجابة لا تكمن في النتيجة النهائية بقدر ما تسكن في الرحلة نفسها. فحين يضع الوعي لمساته الأولى على العقل، يبدأ الفكر في التشكّل، وتنمو المخيلة الفكرية، وتتجه نحو استيعاب أعمق للمعاني، لا باعتبارها حقائق جاهزة، بل كمساحات مفتوحة للتأمل.
إن بعض الأسئلة لا نختارها بقدر ما تختارنا. تظهر فجأة حين نشعر بالفراغ تجاه المعنى، حين يتسع الداخل أكثر مما يحتمل الصمت. في تلك اللحظة، لا يكون السؤال ترفًا فكريًا، بل ضرورة وجودية. وهنا، يتدخل الوعي ليملأ ذلك الفراغ، ليس بإجابات سريعة، بل بممارسة التفكير ذاته، ليُشبع احتياج الوعي الناضج الذي لا يهدأ إلا حين يفهم.
ومع تقدم العقل في رحلة الفهم، يدرك أن العالم ليس فوضى من الأفكار، بل شبكة من المفاهيم التي تحتاج إلى مسميات وصفات، تُرتب وجودها في العقل كما تُرتب حضورها في الحياة. فالتسمية ليست فعلًا لغويًا فقط، بل ممارسة فلسفية تمنح الأشياء معناها، وتُعيد تشكيل علاقتنا بها.
وتبقى القوة الذاتية، مهما بلغت، بحاجة دائمة إلى وعيٍ نيّر، وعي يسعى باستمرار إلى ترجمة المفاهيم إلى صور متوازية بين الفكر والواقع، بين الداخل والخارج. فالفلسفة لا تبحث عن إجابات نهائية، بل تدرّب الإنسان على أن يكون أكثر وعيًا بأسئلته، وأكثر قدرة على الإصغاء لما يقوله عقله وهو يفكر.
وهكذا، لا تبدأ قصة الفلسفة عند أول إجابة، بل عند أول سؤال صادق، سؤال يطرق باب العقل، ويتركه مفتوحًا على احتمالات لا تنتهي
” حصلتُ على شهادة في الفلسفة”
نوره بابعير
حينما حصلتُ على شهادة الفلسفة، لم أكن أستلم ورقة اعتمادٍ أكاديمي فحسب، بل كنت أفتح بابًا جديدًا في داخلي. تلك الفلسفة التي كانت تتسع في مساحات العقل، تُلحّ بالأسئلة وهي تدرك الحراك الذي يفيض من بحورها، كانت تدرك الأعماق المخبأة خلف أضوائها. حينما يفتش الإنسان عن عقلٍ نَيِّر، يجد نفسه أمام مرآة الفلسفة؛ يدخل في دهشة الأفكار، والتحليل، والتخييل الذاتي، والانتباه، والتنبؤات التي تسعى إلى تكوين المعنى بالمفهوم المُقَرَّب. لذلك كنت أدرك أن النمو العقلي يبدأ من وجود الفلسفة في المعنى، وأن لكل شيء أسلوبًا فلسفيًا يقود الوعي إلى وجهته.
ومع هذا الإدراك، يتضح أن الفلسفة ليست ترفًا ذهنيًا ولا معرفة مؤجلة للحياة، بل هي اختيار واعٍ للتطور. حين يقدّم الإنسان لنفسه شيئًا من هذا العلم، فإنه لا يضيف معلومة إلى مخزونه العقلي بقدر ما يعيد تشكيل طريقة تفكيره. الفلسفة تعلّمنا كيف نسأل قبل أن نُسلّم، وكيف نُفكك المسلّمات التي اعتدنا عليها، وكيف نرى ما وراء الظاهر دون أن نفقد اتزاننا أمام التعقيد.
اختيار الفلسفة هو اختيار للوعي؛ وعيٌ بالذات، وبالعالم، وبالعلاقات التي تشكّل وجودنا. إنها تدفع الإنسان إلى مراجعة أفكاره، وتمنحه شجاعة إعادة النظر، وتحرّره من الأحكام الجاهزة. ومع كل سؤال فلسفي، يحدث تطور خفيّ في الداخل؛ يتسع الأفق، ويصبح العقل أكثر مرونة، وتغدو الفكرة مجالًا للتأمل لا للصراع.
وحين يتطور الإنسان فلسفيًا، ينعكس ذلك على حياته كلها. يصبح أكثر قدرة على الفهم لا على الإدانة، وعلى التحليل لا على الانفعال، وعلى اختيار مواقفه بوعي لا بردّة فعل. الفلسفة لا تغيّر ما نراه فقط، بل تغيّر الكيفية التي نرى بها، وتمنحنا أدوات للتمييز بين ما يُقال وما يُفكَّر فيه، بين الحقيقة والرأي، وبين المعنى والفراغ.
إن تقديم الإنسان للفلسفة لنفسه هو فعل شجاعة معرفية؛ لأن هذا العلم لا يمنح إجابات نهائية، بل يضعك في مسار دائم من التساؤل والنمو. لكنه مسار يقود إلى نضجٍ أعمق، وإلى وعيٍ أكثر صفاءً، وإلى قدرة على العيش بفهمٍ أوسع للذات والعالم. وهكذا، تصبح الفلسفة ليست شهادة تُعلّق، بل تجربة عقلية تُعاش، وخيارًا للتطور المستمر، ونقطة انطلاق نحو إنسانٍ أكثر وعيًا بذاته وبمعنى وجوده
” العقل الخائف رماداً بلا نار “
نوره بابعير
لماذا يتوقف العقل عن استشعاره للمخاوف؟
رغم أن الإنسان قد يدرك بعقله حدود قراراته وإمكاناته الذاتية، إلا أنه أحيانًا يظنّ أنه عاجز عن النهوض أو التجاوز، فيقف عند نقطة من الجمود الداخلي، وكأن وعيه انسلخ عن قدرته على الفهم.
وفي غفلة منه، يتجرد وعيه من الفهم العميق، فيبقى رهينًا لذلك الخوف الذي اجتاح أفكاره وأفعاله وتعامله مع الآخرين، فيغدو متغيّبًا عن الحقيقة التي يفترض أن يواجهها في داخله.
قد يكون السبب في ذلك قلة الثقافة الذاتية؛ إذ تجعل الإنسان يرى الحياة بسطحيةٍ لا تمكّنه من لمس العمق في وعيه تجاه ما يمرّ به من أحداث. فالعقل الذي لا يُغذّى بالمعرفة ولا يُدرَّب على التأمل، يكتفي بظاهر الأشياء، ولا يملك أدوات التحليل أو التفكيك، فيبقى خاضعًا لما تمليه عليه انفعالاته.
وربما أيضًا القناعة المتعلّقة بالخوف هي التي تفرض هذا الانغلاق، حين يتشبّع الإنسان بشعورٍ دائمٍ من الخشية: الخوف من التجربة، من التغيير، من الرفض، أو حتى من تقبّل ذاته كما هي. فيغدو الخوف سلطة داخلية تتحكم في قراراته وتحدّ من رؤيته للحياة، حتى يُصبح الوعي مشلولًا أمامها.
لكن الحقيقة أن العقل لا يتوقف فعليًا، بل ينسحب من مساحة الفهم إلى مساحة الدفاع، فيحاول حماية النفس من الألم أو الخطر، ولو كان ذلك على حساب النموّ والتطور. وهنا تكمن المفارقة؛ إذ يتحول الخوف من وسيلة للنجاة إلى قيد يمنع الحياة نفسها.
إن التحرر من هذا الجمود يبدأ من المواجهة الهادئة، حين يقرر الإنسان أن يواجه ذاته لا أن يهرب منها، وأن يسائل خوفه بدل أن يخضع له. فالفهم أول طريق الشفاء، والوعي الحقيقي لا يُبنى إلا بالشجاعة، تلك التي تدفع الإنسان لأن يرى ضعفه بصدق، ويعيد بناء توازنه بثقة.
وحين يتصالح العقل مع خوفه، ويفهم أسبابه بدل أن ينكرها، تتحول تلك المخاوف إلى قوةٍ دافعة نحو الإدراك والنضج، فيتبدد العجز، ويولد من رحم الخوف وعيٌ جديد قادر على الفهم والتجاوز .
” حينما تركض التساؤلات “
نوره بابعير
الانتماء الفكري للمكان قد يُضعف دور العقل في رؤية الحقيقة داخل الإنسان نفسه، فاعتياد السلوكيات الخاطئة يجعلها تتحول مع الزمن إلى عادات مستقرة في سلوك الإنسان، بل ويُعيد إنتاجها في غيره. وما يصدر عن الإنسان من أفعال ليس بالضرورة خطيئة بقدر ما هو ترجمة لتغيّرات داخلية دائمة، لكنها تتجلى أحيانًا في سلوك غير سوي، مما يؤدي إلى الوقوع في أنماط سلوكية مشوَّهة.
الغريب أن تلك السلوكيات، مع مرور الوقت، تتسلل تدريجيًا إلى عمق الذات حتى تصبح جزءًا من أساسياتها، فيراها الإنسان أمرًا طبيعيًا يمنح ذاته قيمة، رغم أن القيمة الحقيقية لا تُكتسب بالاعتياد، بل بالتفكير الواعي الذي يميز بين ما هو مكتسب وما هو حقيقي. وهنا تتشكل مشكلة الفهم والوعي، إذ يظل العقل يمارس أفعاله الموروثة والمكتسبة سواءً عن قناعة بها أو بتأثير من البيئة المحيطة، حتى يعتادها فلا يعود قادرًا على مساءلتها أو التحرر منها.
وحين يواجه الإنسان لحظة انتفاضة عقلية تجاه ما اعتاده، يجد نفسه أمام سؤالٍ جوهري: هل يحتاج إلى إعادة تأهيل لبناء سلوكيات جديدة؟ أم أن تلك السلوكيات القديمة كانت تعبيرًا عن طبيعته الأصيلة التي زرعتها نفسه منذ البداية؟ ومع مرور الوقت، تنبت تلك البذور لتكشف ما أرادته النفس حقًا.
والمؤلم أن بعض العقول لم تزل بعيدة عن الازدهار، وأخرى لم تصل بعد إلى الفهم الحقيقي له، ربما لأنها تظن أنها بلغت الكفاية من الوعي. لكن حين يتغيب العقل، تعود المشكلات إلى أسبابها الأولى، فتتعثر رحلة النضج والتفكير النقدي.
ويبقى السؤال غالباً لماذا يعجز البعض عن اتخاذ خطوة التغيير، والتحرر من الخطايا الفكرية المتوارثة؟ ربما لأن الاعتراف بالضعف والمخاوف لا يزال مؤجلاً، فيكذب الإنسان على نفسه، ويقاوم الأفكار التي قد تعيد إليه وعيه الحقيقي… وعودة عقله كما يجب أن يكون
كل عقل مُهيأ أن يكون واعياً
نوره بابعير
مهم أن تفهم كيف تفصل المفهوم المستحق من حياتك، لتتمكّن من بناء أفكار واضحة تخدم قدراتك في مسيرتك نحو التقدّم. فمثلاً، إذا أدركت أن العقل هو الخزينة الثمينة لذاتك، ستصبح العناية به أولوية من أولوياتك، وذلك من خلال تحسين أدائه واتساع معرفته ووعيه وقناعاته. وكل هذا ثمرة اجتهاد فكري قيّم يضع لك حدود القيمة في كل ما تملك. وهكذا تتحول أفكارك إلى حوار مثمر، يتيح لك أن تدرك المعنى الحقيقي لكل فكرة، ولكل حوار عميق، في محاولات عديدة تستكشف من خلالها لبّ وعيك وتكشف عن تغيّراتك.
الفهم يصنع للذات حياة تتوافق مع قدراتها. كثيرون يدركون هذه الحقيقة، لكن الوصول إليها ليس بالسهولة التي نظن؛ بل يحتاج إلى جهد متواصل يحقق لك مستوى من الانضباط فيما تسعى إليه. ومع ذلك، فالسعي في الحياة لا يقتصر على زاوية واحدة، بل يتشكل من مفاهيم متنوعة، والغاية قد تكون وصفًا، لكن المعنى يُترجم بطرق مختلفة تبعًا لاحتياجات كل شخص. وهنا تكمن المشكلة: أن بعضهم يلجأ إلى التقليد، فيتبع الآخرين بما يملك من وعي، كأنه يتخلى عن وعيه المستقل. وعندما تغيب الأفكار الواعية، تتسلل مكانها الأفكار الفاسدة، فتحجب جزءًا من مساحة العقل رغمًا عنه.
ومسألة الفهم ليست سهلة كما نتصورها، بل تحتاج إلى كثير من العلم لتتلاشى الأوهام المؤقتة ويأخذ الوعي مكانه الصحيح. ومع أن لكل إنسان خيارًا، إلا أن بعضهم يفقد الاختيار الجيد، فلا يملك إلا أفكارًا سطحية، وحوارات فارغة، وتغذية عقلية ضعيفة، وسلوكيات لا تُعين على النضج ولا على تنوير العقل.
لماذا يخفق عقل ويتفوّق آخر؟ لأن الأساس يتشكل منذ البداية. فالعقل الواعي يُدرّب نفسه على الانفتاح، والتأمل، والمراجعة، ويصوغ من التجربة قيمة تساعده على التمييز بين الغث والسمين. أما العقل الخامل، فيرضى بالسطحية، ويكتفي بظاهر الأشياء، فيتعثر كثيرًا ويهدر جهده في دوائر مكررة لا تنتهي.
والفرق بينهما هو الفارق بين عقلٍ يبحث عن النور، وآخر يكتفي بالظل. فالواعي ينقّب عن الحقيقة ويختبرها، بينما الخامل يسلّم نفسه لما يأتيه دون أن يُثير في داخله سؤالًا واحدًا. ولهذا، فالتفوّق لا يُقاس بما نملكه من معلومات، بل بقدرتنا على تحويلها إلى وعي فعّال يقودنا إلى قرارات أصحّ، وخيارات أوسع، وحياة أكثر اتزانًا.
في النهاية، العقل كالأرض؛ إن زرعته بالفكر الجيد، أثمر وعيًا يرافقك في كل مراحل حياتك. وإن أهملته، نما فيه عشب الوهم وغلبه الجهل. فالمسؤولية أن تختار أي عقل تريد أن تكون: عقلًا واعيًا يضيء لك الطريق، أم عقلًا خاملاً يطفئ نورك قبل أن يبدأ.
العقل في جوهره يُبنى من اختياراته الأولى؛ فالواعي يتعامل مع كل فكرة كأنها بذرة قابلة للنمو، يختبرها ويغذيها بالمعرفة حتى تكشف حقيقتها. أما الخامل فيرضى بقبول الفكرة كما هي، بلا تدقيق ولا مساءلة، فيُثقل نفسه بما لا ينفع.
العقل الواعي يدرك أن خطواته الأولى هي أساس مساره، فيزرع في بداياته وضوحًا وانضباطًا ليبني مستقبله على قواعد راسخة. بينما إذا تهاون الإنسان في بدايات عقله، ترك فجوات تتسع مع الوقت حتى يضيع في التباسات لا يعرف كيف يعود منها.
وهكذا، يبقى الفارق بين عقلٍ يصنع معنى لحياته، وآخر يظل أسير العشوائية، هو مقدار الجهد المبذول في التهذيب والتجريب والمراجعة. فلا وعي بلا ممارسة، ولا نضج بلا معاناة صادقة تبحث عن جوهر الفكر.
والحقيقة أن كل عقل مُهيأ أن يكون واعيًا أو خاملاً، والقرار يبدأ من لحظة إدراك الذات: هل تختار أن تصنع مسارك بفكر مستقل، أم تترك نفسك للتيار بما يحمله من فوضى وتناقضات؟
فِي ثقل التساؤلات، حيوات أُخرى
نوره بابعير
تظلُّ التساؤلات، منذ فجر الفكر الإنساني، هي البذرة الأقوى في حقل الوعي، والنبع الذي لا ينضب مهما حاول العقل أن يرويه.
كيف لعقلٍ أن يتشبث بسؤالٍ واحد، ثم لا يلبث أن يحيله إلى همسٍ داخلي يتكاثر كالنار في هشيم الفكر، حتى يغدو ثرثرة صاخبة ترفض السكون؟ وكيف تتحول تلك الثرثرة إلى غذاءٍ للعقل، لا يعرف الشبع منه إلا حين يظفر بغاية السؤال، فيدرك عندها أن الوصول ليس نهاية، بل بداية لأسئلة أخرى أكثر عمقًا وإرباكًا؟
كيف للإنسان أن يفرغ نفسه حتى يصبح كصفحة بيضاء تنتظر الحبر الأول، ثم كيف يمتلئ حتى يكاد يفيض عن ذاته؟
هل الصمت امتناع عن القول، أم أنه كلامٌ آخر لا تُدركه الأذن، بل تصغي إليه الروح؟ وهل الكلام امتلاء بالمعنى، أم محاولة يائسة لسد فراغات الوجود بما نظنه أفكارًا؟
إن الحوارات ؛ حين تكون صادقة ، تُشبه عدوى فكرية تنتقل من عقلٍ إلى آخر، فتثريه بما يحمله من ذخائر المعرفة والرؤى، لكن السؤال الأعمق: كيف يمكن للإنسان أن يبقى هو نفسه وسط هذا التبادل العميق؟ وهل الثبات على الذات فضيلة، أم أن التحول هو جوهر الحياة؟
ربما لا نعيش بالحقائق بقدر ما نحيا بالأسئلة. فالأسئلة تمنحنا القدرة على إعادة النظر في أنفسنا وفي العالم، وتُربك يقيننا كي لا يتحول إلى جمود. لعل الإنسان، في نهاية الأمر، ليس سوى كائن يبحث عن نفسه بين ما يفرغه من فكر وما يملؤه من دهشة، بين صمته الذي يفتح أبواب التأمل، وكلامه الذي يوقظ الآخرين. وربما تكمن الحكمة الكبرى في أن ندرك أن امتلاءنا لا يكتمل إلا حين نتقن فن النقص، وأن الوصول إلى الإجابة ليس إلا بداية طريق نحو سؤالٍ آخر أكثر اتساعًا .
لكن، ماذا لو كان السؤال نفسه كائنًا حيًا يعيش فينا؟ ماذا لو كان هو الذي يختارنا، لا نحن من نختاره؟ ربما نحن لسنا سوى أوعية مؤقتة للأسئلة التي تبحث عن أجساد لتسكنها، عن عقول لتدور فيها، وعن قلوب تتسع لثقلها ودهشتها. وربما لهذا السبب، كلما حاولنا إغلاق باب التساؤل، تسللت الأسئلة من شقوق أخرى، لأننا وُجدنا لا لنسكن في الإجابات، بل لنتنقّل بين احتمالات لا تنتهي.
إن الامتلاء الحقيقي لا يأتي من تراكم الأفكار، بل من القدرة على النظر في أعماقها، في مساحات الظل التي تخفيها، وفي المناطق الصامتة التي لا يقترب منها ضوء اليقين. الإنسان الذي يكتفي بما يعرفه، هو إنسان أغلق أبواب بيته الفكرية وعلّق على الباب لافتة تقول: “المعرفة هنا اكتملت”، لكنه لا يدرك أن الغبار سيتراكم على جدرانه الداخلية حتى يختنق.
لذلك، ربما كان أعظم ما يمكن أن نفعله هو أن نعيش كما تعيش النهر: متحركين دائمًا، نستقبل ما يأتي من منابع جديدة، ونتحرر مما لم يعد صالحًا للبقاء. أن نكون كالأفق، لا يكتفي بلون واحد، بل يتشكل مع كل فجر وكل غروب.
في النهاية، قد لا نعرف هل نحن من نصنع الأسئلة أم أن الأسئلة هي التي تصنعنا، لكن المؤكد أن حياتنا، بكل ما فيها من فراغ وامتلاء، من صمت وكلام، ليست سوى محاولة طويلة لفهم ما لا يمكن فهمه بالكامل. وهذا هو سر جمالها.
عبدالله ناجي: اللغة و الخيال أحلّق بهما في سماوات الكتابة الإبداعية
نوره بابعير
كان عبدالله ناجي مهتمًا بالمعنى الحقيقي لمفهوم الكتابة، وكانت له وجهة نظر خاصة من هذه الزاوية، مقتبسًا من الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت قوله: “أنا أفكر، إذن أنا موجود”. فجعل من هذه العبارة مرجعية فكرية ومعنوية، وأعاد صياغتها على طريقته قائلاً: “أنا أكتب، إذن أنا موجود”.
ربما كان في هذا المعنى شيء من العمق، مما دفعه للتوغل أكثر في إبراز هويته ككاتب وشاعر وروائي. كان يرى أن الكتابة شكل من أشكال التذكار، تُبقي ذهنه يقظًا، وتحفّز ذاكرته. كلما كتب، انغمس في التفاصيل، وكلما فكّر، نفض عن ذاكرته غبار النسيان.
الكتابة بالنسبة له وسيلة لتوثيق اللحظات، من خلال سرده، وشعره، ورواياته.
الكاتب والشاعر عبدالله ناجي صديقًا وفيًا للغة، والشعر، والرواية. خاض تجارب كتابية عديدة، يمتلك فيها الإبداع، ويصقل المعاني من خلال لغته الثرية وأسلوبه المتفرّد
-هل تؤمن بأن الشعر تجسيد للجماليات؟ وكيف ترى ارتباط الشعر بالفلسفة؟
التجسد الأول للشعر كان البحث عن حقيقة الوجود، ومن هنا ارتبط الشعر بالفلسفة برباط خفي أزلي، فكلاهما باحثان عن الحقيقة، الأولى شعرية والثانية فلسفية. ولأن الحقيقة عبر طريق الشعر تتخذ أشكال عدة بينما تحتفظ بجوهر واحد، وهو الجمال أو الفن، فإن الشعر اتخذ المكانة الأعلى فيها، فالحقيقة الشعرية متأصلة في الذات والكون، غير مفهومة المعنى ولكنها تعاش بكامل أناقتها الفنية والجمالية، وتتنقل بالإنسان فضلا عن كونه شاعرا من مرتبة وجودية إلى مرتبة أعلى. ذلك يشبه التصوف أو الترقي بشكل ما، ولكنه لا يعبأ بالطقوس، فالشعر طقس بمفرده، وحالة كامنة في اللاوعي، تنبثق في الوجدان، وتتجلى في المعاني والأشياء، وإلى ذلك الطقس المفرد تنجذب الفنون بكل تنوعاتها. ولا أعني بذلك الوقوف على الشكل الشعري النظمي، بل أطير إلى المعنى الحقيقي والاتساع الأجمل، فكل جمال أو فن أو حب أو بهاء أو رؤية هو شعر أو حالة شعرية. والشعرية أعم من الشاعرية، إذ هي التجسيد الكامل للجماليات، أو النظر إلى الجمال الكامن في كل شيء.
-ما مكانة الشعر في حياة الشاعر؟ وهل ترى أن له تأثيرًا عميقًا في تجربته الشخصية والوجودية؟
إذا ارتبط الإنسان بالشعر كباعث له وخالق لمفرداته فإن حياته تصبح مرهونة للشعر، وبه يتكون وجوده. فهو مسكون بهواجسه وطقوسه، يعيش في دائرته داخل دائرة الحياة، ودائرة الشعر أرحب لأنها الجمال ذاته. ومن هنا تتحدد مكانة الشعر في حياته، وتتجدد، فالقصائد هي تجلياته المتعددة، ولكل قصيدة روح تعيش بها بعد أن ينفخ فيها الشاعر من روحه، ويهبها الكثير من نفسه ويودعها مشاعره وأحاسيسه. والروح هي من تصنع تجربة الشاعر على الحقيقة، لا مجرد نظم الأبيات وإبداع التراكيب، ومن تلك الروح ستتوالد علاقات جديدة بين الكلمات وتتسع الرموز وتتجاوز حدودها الأولى. ويصبح الـتأثر والتأثير متبادلا بين الشاعر وقصيدته، وكلما تجذرت الروح في المعني الشعري تعمقت التجربة الوجودية في ذات الشاعر وفي شخصيته. وما يدل على أثر الشعر في شخصية الشاعر هو نظرته المختلفة للوجود بكلّيته وبأجزائه، فيرى في الموجودات معنى قد لا يراه غيره، ويلتقط فكرته من شيء لا يأبه له سواه.
-الكتابة مشروع أدبي متكامل، كيف يتعامل عبدالله ناجي مع هذا المشروع؟
تختلف الكتابة الأدبية من مشروع إلى آخر، ومن تجربة إنسانية أو اجتماعية إلى ثانية، وحتى في المشروع الشعري على سبيل المثال تتنوع طريقة تعاملي مع القصيدة، هناك نصٌ شعريٌ يكتب نفسه في اللحظة ذاتها، وينتهي بانتهائها، ويبقى عليّ تنقيحه ومراجعته، على أن هذا النص لا يمحنك فرصة المراجعة كثيرا، فغالبا ما يجئ مكتملًا كأنما انفتحت بوابةٌ من مكان ما، ودفع عربة القصيدة عدد من الشياطين أو الملائكة ثم اختفوا بعد ذلك واختفت معهم تلك البوابة. وهناك قصيدة تتشكل على مراحل وتتخذ سلما شعريا ترقى فيه وتأخذ كامل وقتها في البناء والتجلي. ويتجدد تعاملي مع الشعر غالبا في لحظات ذلك التجلي والفيض. أما في السرد فيختلف التعامل عطفا على اختلاف الفن والمشروع الأدبي والاستعداد النفسي والتهيؤ الداخلي، ففي الرواية يتطلب المشروع استعدادا نفسيا وذهنيا كبيرين، لا ينتهي بانتهاء مرحلة الكتابة، ويبدأ قبل الدخول فيها بكثير، فهناك التخطيط الذهني للمشروع، ورسم الهيكل العام للرواية، وتحديد الشخصيات الرئيسة التي بها يبدأ ويقوم العمل، وقبل ذلك الإمساك بفكرة أو حدث أو حكاية تنبثق منها باقي الأحداث والفصول والشخصيات، ثم يتحول المشروع إلى هاجس وحلم وواقع يعيش معي طيلة مدة إنجازه سواء كنت جالسا إلى طاولة الكتابة أو كنت أمارس حياتي بكل تنوعاتها، يظل المشروع هاجسي ويتمدد في وجداني ويحدد لي العديد من اختياراتي في الحياة، فكأنما تتجول شخصيات الرواية معي وتعيش واقعي.
-الكتابة الإبداعية تكشف عن احترافية أدواتها، فما الأدوات التي يعتمد عليها عبدالله ناجي في الكتابة؟ وهل تختلف أدواته في الشعر عنها في الرواية؟
اللغة والخيال، لا أنفك أحلّق بهما في سماوات الكتابة الإبداعية بشقيها الشعري والسردي، ولا وجود لفن كتابي على حقيقته من دون هذين العنصرين، فهما أكثر من كونهما أداتين من أدوات الكتابة، ومع ذلك فهما أكثر ما يكشف عن احترافية الكاتب وسر جمال النص، وبطبيعة الحال والتجربة تأتي أدوات أخرى بعد ذلك لتساهم في إبداع تلك الكتابة والتجربة الأدبية، في الرواية مثلا تعجبني كثيرا لعبة الزمن، وتعدد المسارات الزمنية كما في ” حكايتان من النهر ” أو الانطلاق من لقطة الختام لتكون هي فاتحة الرواية كما في منبوذ الجبل، أو تكثيف الزمن ظاهريا وتمديده في المونولوج النفسي لشخصيات الرواية كما في حارس السفينة. أيضا هناك أداة مهمة اعتمد عليها كثيرا في رواياتي وهي في الأساس جزء من تكويني، تعميق النص من خلال أحداثه وشخصياته، وهذه الأداة تقودني إلى أداة أخرى وهي الترميز والذي يفتح مجالات للتأويل وتعدد القراءة، حدث ذلك معي جليا في حارس السفينة وماتزال إلى الآن تُقرأ بصيغ جديدة ومختلفة على الرغم من مرور خمس سنوات على صدورها. وبعض تلك الأدوات تعتمد عليها القصيدة كالترميز والاعتناء بالعمق النفسي للنص الشعري، ولكن نِسب الحضور والخفوت أو الغياب تختلف من نص إلى آخر ومن الشعر إلى الرواية.
-الحكاية هي جوهر السرد وفلسفته، وقد تحدثت عن تجربتك معها في عدد من مؤلفاتك. هل يمكن أن تحدثنا عن علاقتك بالحكاية، وبشكل خاص عن رواية“ حارس السفينة”؟
ما حدث معي في حارس السفينة أستطيع اعتباره حالة حكائية أو سردية فريدة، لم تتحدد المعالم السردية للنص ولا هيكله أو حتى شخصياته وفكرته، إلا حين الوصول في الكتابة إلى كل حدث أو فصل أو شخصية، أما قبل تلك اللحظة فكانت التجربة مرهونة لزمن الحكي/الكتابة، حتى إنني جعلت الاهداء تعبيرا عن جوهر السرد فيها “إلى الآخر الذي تقمصني ذات غياب وأملى عليّ هذه الحكاية، ولم يكن مني سوى الكتابة”. كانت عملية الحكي تسير بي حيثما تشاء في كل جلسة كتابة، وكنت منقادا لمشيئتها إلى أن اكتملت الرواية في اثنى عشر جلسة، وهي عدد مقاطع الرواية، امتلكت جوهر هذه الراوية قبل كتابتها بأربع أو خمس سنوات وظل يتقلب في وجداني حتى جاءت لحظة الكتابة وتدفق الحكي في ثلاثة أشهر فقط. ففي حارس السفينة لم أحاول خلق الأحداث أو تكوين الشخصيات أو بناء الأفكار من قبل، كما في روايتيّ منبوذ الجبل وحكايتان من النهر، ففي كل رواية كنت أعيش مع الحكاية قبل وأثناء وبعد الفراغ من الكتابة، أشاطرها أفكاري وتشاركني ليلي ونهاري، وترحل بي إلى عوالمها وأزمنتها، أصادق أبطالها، وشخصياتها الهامشية كذلك، وأغوص داخل نفوسهم، أما حارس السفينة فقد عشت مع السفينة فقط وبحثت عنها طيلة السنوات الخمس التي سبقت الكتابة، ثم جاءت القصة متتابعة كأنما كان هناك من يرويها لي فصلا فصلا في تلك الجلسات الكتابية، وكنت أتشوق لكل جلسة حتى تكتمل القصة في وجداني وعلى الورق معاً.
-أيهما يحضر بقوة في تجربة عبدالله ناجي: الكتابة الشعرية أم الكتابة الروائية؟
الكتابتان حاضرتان بقوة في تجربتي، ولا أبالغ إن قلت بأنهما غير منفصلتين من الأساس، فالشعر رواية الوجود، والرواية قصيدة الحياة، والإنسانية أنست بالأرض والمكان فحكت وروت، وتعلقت بالوجود فشعرت وتجلت. أكون شاعرا حينما يجتاحني الفيض العرفاني أو الوجودي، وأصبح روائيا عندما أركض في طرقات مدينتي، ولكن ذلك لا يقيم سدا منيعا بين التجربتين أو الكتابتين فلا وجود للأخرى إن وجدت الأولى ولا وجود للركض إن جاء الفيض، بل الجمع بينهما ليس مستحيلا، وهو كذلك غير مفهوم بشكل دقيق، وأفضّل ألا أفهمه. على أن أعيشه وأشعر به وأمارسه. وإذا شئت أن أبحث عن مفهوم يقف بي على الحالة تلك فسأصل إلى الفن.. الفن الذي حوّل هذا الكائن من مجرد مخلوق إلى إنسان. فبالفن -نقشا ورقصا وكتابة ونحتاج تأكد وجود الإنسانية.
-لكل شاعر تعريفه الخاص للشعر، فما هو الشعر في نظر عبدالله ناجي؟
قلت ذات مرة وأنا أحاول تعريف الشعر: الشعر مفردة ملغومة، ومحاولة تفكيكها أو تعريفها خطأٌ فادحٌ، فكل محاولة لتعريف الشعر هي محاولة غير مأمونة المعنى ولا مضمونة النتيجة. الشعر مبثوث في هذا العالم لكنه يفلت منا حال تعريفنا له، الشعر روح الكون، فماهي الروح؟ لا يمكننا تعريف الشعر من خارجه، إذ جل ما نفعله ونحن نقوم بهذه المحاولة هو الوقوف على الشكل والحالة، لن نعرّف الشعر إلا باقترافه ووحدها القصيدة قادرة على ذلك، ولكن القصيدة وهي تفعل ذلك لا تُعري لنا سوى نفسها بينما تخفي داخلها جوهر الشعر.. فالشاعر الأصيل حال التباسه بالكائن الشعري تتجلى له القصيدة فيظنها الشعر كله، وهي الشعر كله في لحظتها تلك، غير أنه وبعد زوال ذلك التجلي لا يجد بين يديه سوى قصيدته أما الشعر فيبقى ذلك المجهول العظيم، نعيشه ولا ندركه.
-من خلال تجربتك في الكتابة والإلقاء، ما الصفات التي اكتسبتها خلال مسيرتك الإبداعية؟ وهل ترى أن لهذه الصفات دورًا في إثراء المشهد الأدبي والثقافي من وجهة نظرك؟
الكتابة هي المرحلة الأولى في طريق التجربة الإبداعية ويليها الإلقاء بطبيعة الحال، ومن قبلهما تعلو القراءة كبساط معرفي يحملهما في سماء الإبداع، هذا هو السلم الأدبي الذي أتاح لي ككاتب اكتساب العديد من الصفات، تأتي الإجابة على سؤال: أين سأضع قدمي في المرحلة القادمة من تجربتي وأين أقف الآن إبداعيا؟ من أهم تلك المكتسبات، فمن دون الحضور تأليفا ونشرا أو قراءة وإلقاءً لن يقف الكاتب من تجربته موقفا صحيحا، وستظل نظرته غائمة ومسيرته غير واضحة المعالم، فكل كتاب أو لقاء معرفي أو تماس مع القرّاء هي بمثابة كشوف في رحلة الأدب، ورصد للمنجزات والمراحل ومحطات الطريق.. وكل ذلك يصب تلقائيا في إثراء المشهد الأدبي قراءة وتحليلا ونقدا ومداولات إبداعية، وتلاقحا للأفكار وتوليدا للتجارب الأدبية. وصفة أخرى أدين للتجربة الإبداعية في اكتسابها إلا وهي صقل المهارات الكتابية واكتساب رؤية عميقة للأشياء والوجود بشكل عام، وكذلك اكتساب أسلوب أدبي خاص بي، فالتراكم الإبداعي يصنع بصمة للكاتب يُعرف بها، وتتجلى أكثر عندما يكتمل مشروع الأدبي.
-متى ترى أن الكتابة تصبح مشروعًا مكتملًا؟ ومتى تعتبر مشروعًا مهزومًا أو غير مكتمل؟
الاكتمال بالنسبة للمشروع الكتابي لا يعترف بالكم وعدد الكتب والإصدارات أو اللقاءات، فقد يكتمل المشروع في كتابين أو ثلاثة، وذلك عائد إلى عمق التجربة ونضوج الرؤية واكتمال أدوات الكاتب لغويا ومعرفيا وإنسانيا وتقديمه لتجربة إبداعية حقيقية، لا مجرد تدوين لما يخطر في البال مع حرفة أدبية جميلة، ويبدأ المشروع بالوضوح عند امتلاك كاتبه لصوته الخاص، ويتعمق بتجذر الكتابة الإبداعية في تربة التجارب الإنسانية والذاتية وتصدير رؤية خاصة بالكاتب عن الحياة والموجودات والمعاني المجردة والحسية. وليس عليه أن يخوض في كل شيء حتى يكتمل مشروعه، أو يكتب في الأشياء العظيمة فقط، وإنما ينطلق من ذاته في النظر إلى الأشياء، حتى أصغر الأشياء، قد تتحول في يد المبدع إلى إبداع أخاذ إذا كُتبت بصدق وتجربة عميقة مع تميزٍ في أدواته الكتابية. عدا ذلك قد يهبط بمشروعه إلى الفشل ثم الاندثار، وتصبح الهزيمة هي الخيار المتاح والخروج بمشروع غير مكتمل، لا يدل على صاحبه ولا يشير إليه.
-لكل كاتب نصائح وممارسات تثري تجربته الإبداعية، فما أبرز النقاط التي ترى أنها تسهم في احترافية الكتابة، سواء في الشعر أو الرواية؟
بالنسبة لي كانت القراءة هي الممارسة الأجدى لإثراء تجربتي الإبداعية، والقراءة سبيل لاكتشافات عدة منها الموهبة الكامنة في الأعماق، إذ القراءة تحفزها على الظهور ثم تمنحها مكانة سامقة في عالم الأدب، وهي كذلك إحدى بوابات الخيال الأدبي الخصب، ورافد لامتلاك مهارات وتقنيات كتابية جديدة. يلي ذلك ويتبعه غالبا لقاء الأدباء والمبدعين من كل فن، فالنقاشات الأدبية والثقافية والاحتكاك بالتجارب المبدعة ستثري تجربته وترفع من احترافية كتاباته. وثمة ممارسة أو نصيحة أخرى أجدها مهمة في احترافية الكتابة، وهي أن يخلق الكاتب طقسا خاص به للكتابة، فمجرد الدخول في طقسه ذاك تتداعى إليه عوالم قصيدته أو روايته ويدخل بكامل تجليه في تجربته الإبداعية، ومع تكرار التجربة يتكون ارتباط نفسي بين الكتابة وطقسها، إلى حد أن الكلمات والمعاني والأفكار تشعر بحرية تامة في مناخها الكتابي فتتشكل في ذهن الكاتب باحترافية عالية.. فاحترافية الكتابة مثلها مثل غيرها من الفنون والمهن تتأصل وتتجدد بالممارسة الدائمة، والبحث الجاد عن فضاءات ثرية تأخذ بتجربته الإبداعية إلى الأجمل..
قيمة العقل لا تُقاس بما يتفق عليه
نوره بابعير
لم أعد أنظر إلى الاختلاف الفكري كنوعٍ من الخلاف، بل أصبح وسيلة لإيقاظ الوعي، إذ يساهم في اتساع الرؤية البصرية والبصيرة الداخلية. فالمعنى يتشظّى في كل مرة، ويتغير تبعًا لفهم الأشخاص له. وهذا ما يمنح الفكرَ قيمةً؛ إذ يتحرك العقل بين صحوة الوعي وجهل الآخر. وعندما تحدث مثل هذه الأمور، فإنها تُشكّل ترابطًا عميقًا بين الطرفين، لكلٍ منهما وجهة نظر مختلفة تضع أمام العقل خيار المفاضلة بينهما، حتى تتضح الصورة الكاملة للفهم.
لكن هذا لا يعني أن الآراء الأخرى خاطئة، فربما بُنيت على أسس صحيحة، لكن من زاوية فهم مختلفة.
أما التنبؤات الناتجة عن الاختلاف، سواء في الألفاظ أو الأفعال، فإنها تعود إلى طريقة تفاعل العقل معها؛ كيف كوّنها، ودوّنها، وأخرجها بالصورة الملائمة لقدراته. ومن هنا تتفرّع الآراء، ويبرز في كل رأي مدى النضج العقلي لصاحبه، فيتجلّى فيه إنصاف بين وعيٍ منير ونضجٍ متكامل، يقود الإنسان وفقًا لانعكاسات داخلية متشابكة.
فليست المشكلة في وقوع الاختلاف، ولا في الخلاف ذاته، بل في فراغ العقل حين ينظر إلى هذه الأمور ويضعها في غير موضعها الحقيقي، فيتمسك بها دون وعي، بدلاً من أن يترك مساحة كافية لاكتشاف الحقائق المخفية
وهنا يصبح الوعي مرآةً صافية، لا تعكس فقط ما يُرى، بل ما يُفترض أن يُفهم، فليس كل ما نسمعه يحتاج إلى تصديق، ولا كل ما نختلف عليه ينبغي أن نُحسمه بالصواب والخطأ. لأن جوهر الفكر لا يقوم على الانتصار لرأي، بل على فهم أعمق لطبقات المعنى، وإدراك أوسع لما بين السطور.
الاختلاف الحقيقي ليس صراعًا بين العقول، بل تلاقٍ بينها، حيث ينمو الفكر في منطقة التباين، لا في مناطق التماثل. فحين تتجاور الأفكار المتناقضة، تتكوَّن لدينا خرائط جديدة للفهم، ومساحات أرحب للتأمل، تجعلنا أكثر مرونةً في تقبّل وجهات النظر، وأكثر نضجًا في مراجعة قناعاتنا.
إن العقل الممتلئ لا يخشى الاختلاف، بل يحتضنه، لأنه يعلم أن كل فكرة تحمل احتمالًا للحقيقة، حتى وإن بدت لنا غريبة أو بعيدة. فالحقيقة ليست حكرًا على طرف دون آخر، بل هي حصيلة الحوار، والتقاطع، والتراكم المعرفي المستمر.
ولعلّ أحد أخطر ما قد يُفسد هذا المسار، هو التسرع في إصدار الأحكام، والرغبة الدائمة في تصنيف الآخرين تحت لافتات مسبقة. فالاختلاف لا يُدار بالعاطفة المجردة، ولا بالانحيازات الشخصية، بل بعقلٍ يُنصت قبل أن يُجادل، ويُحلل قبل أن يرفض، ويُقدّر أن لكل فكرة زمنها، وسياقها، وبيئتها.
من هنا، علينا أن نمنح عقولنا فرصة للنمو داخل مساحات الاختلاف، لا خارجه، فكل فكرة نستوعبها خارج قناعاتنا المعتادة، هي توسعة لمجال الرؤية، وتعميق لبصيرة لم تكن لتتفتح لولا احتكاكها بما يخالفها.
تبقى الفكرة الأكثر رسوخًا: أن قيمة العقل لا تُقاس بما يتفق عليه، بل بما يستطيع فهمه، ومراجعته، وتطويره، حتى وهو في قلب الاختلاف.