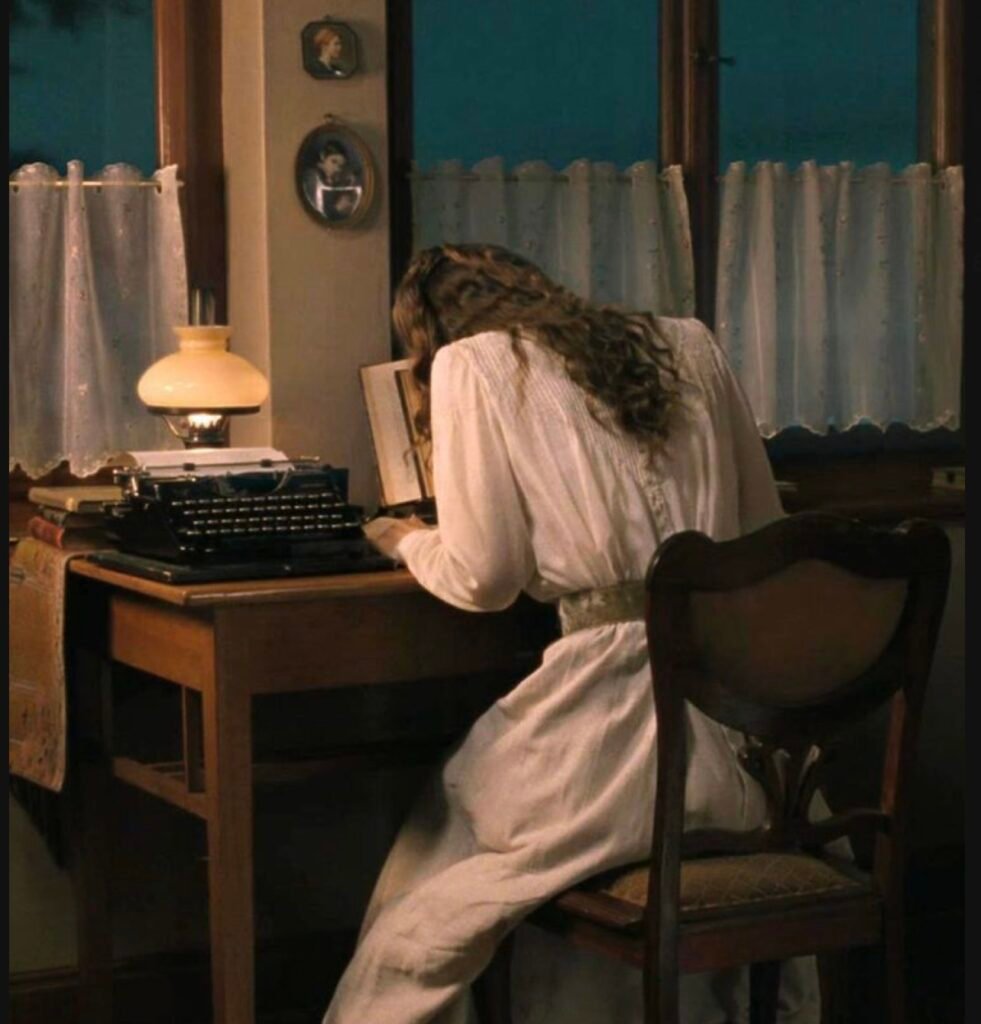موضوعات متنوعة
إرنستو ساباتو يتساءل: هل هي أزمة الفن أم فن الأزمة؟
هل هي أزمة الفن أم فن الأزمة؟
تحدث في هذه اللحظة الفارقة من التاريخ ظاهرة شديدة الغرابة: يُتهم الفن بأنّه يعاني من أزمة، وبأنه تجرد من إنسانيته، وبأنه نسف كل الجسور التي تربطه بعالم الإنسان. في حين أن الأمر على عكس ذلك تماماً، فإن ما يعدّ فناً في أزمة هو، بعبارة أكثر دقة، فن الأزمة، ولكن ما حدث أنّ الأمر نشأ نتيجة مغالطة. يرى أورتيجا، على سبيل المثال، أن تجريد الفن من إنسانيته مثبت كنتيجة الانفصال القائم بين الفنان وجمهوره. من دون أن يدرك أن الأمر قد يكون عكس ذلك تماماً؛ أن الجمهور وليس الفنان هو من تجرّد من إنسانيته. من الواضح أن الإنسانية شيء والجماهير العريضة شيء آخر مختلف تماماً؛ تلك المجموعة من الكائنات التي تخلت عن كونها بشراً لكي تتحول إلى أشياء مصنوعة بصورة متكررة، مقولبة وفقاً لتعليم نمطي، معلبة داخل مصانع ومكاتب، يُرجُّون يومياً على الإيقاع الموحد للأخبار التي تبثها محطات إلكترونية منحرفة ومكبلة بوساطة صناعة القصص المصورة والمسلسلات الإذاعية وعناوين الصحف والتماثيل التذكارية في البازارات. في حين أنّ الفنان هو الوحيد بامتياز، الذي استطاع للمفارقة الاحتفاظ بأروع خصال الجنس البشري، بفضل عدم مقدرته على التكيف، وبفضل تمرده، وجنونه. ما أهمية أن يبالغ أحياناً، ويقطع إحدى أذنيه؟ سيظل مع ذلك أكثر قرباً للإنسان الحقيقي من كاتب رصين في أرشيف وزارة. صحيح أن الفنان، المحاصر واليائس، ينتهي به الأمر بالفرار إلى أفريقيا، إلى فراديس الكحول أو المورفين، وإلى الموت ذاته؛ فهل كلّ هذا يدل على أنه هو الذي تجرد من إنسانيته؟
“إذا اعتلت حياتنا أحياناً (كتب جوجان إلى ستريندبرغ) فإن فننا يجب أن يكون كذلك أيضاً؛ وبوسعنا استعادة عافيته بالبدء من جديد، سواء كأبرياء أمكمتوحشين… تكمن علتكم في حضارتكم”.
ليس الفن سبب الأزمة بل المفهوم البرجوازي المتداعي “للواقع”، الاعتقاد الساذج في الواقع الخارجي. يُعدّ ضرباً من العبث الحكم على لوحة لفان جوخ وفقاً لذلك المنظور. في حين أنه بالرغم من حدوث ذلك (وبصورة متكررة!) لا يمكن استنتاج سوى ما يستنتج: أنّ اللوحات تصوّر نوعاً من اللاواقعية، وشخصيات وأشياء تنتمي إلى بقعة شبحية، نتاج مخيلة شخص ذهبت المعاناة والعزلة بعقله.
يقدم فنّ كلّ عصر رؤية للعالم، ومفهوم تلك الحقبة للواقع الحقيقي، ويستند ذلك المفهوم، وتلك الرؤية، إلى ميتافيزيقا وروح خاصة بها. بالنسبة إلى المصريين، على سبيل المثال، الذين اهتموا بحياة الخلود، لم يكن من الممكن أن يمثل هذا العالم الفاني ما هو حقيقي فعلياً؛ ومن هنا جاءت قداسة تماثيلهم الضخمة، وهندسيتها التي تعد دليلاً على الخلود، مع التجرد لأقصى مدى من العناصر الطبيعانية والفانية؛ هندسية تخضع لمفهوم عميق، وليست كما اعتقد البعض بصورة سطحية تنم عن قصور تشكيلي، لأنهم كانوا طبيعانيين بمنتهى الدقة حين نحتوا أو رسموا عبيداً بلا قيمة. عندما ننتقل إلى حضارة دنيوية مثل حضارة بركليس اليونانية، تقدم الفنون أعمالاً طبيعية، إلى درجة أنّ الآلهة ذاتها تصوّرعلى هيئة “واقعية”، ومن ثم، فإنه بالنسبة إلى هذا النمط من الثقافة الفانية، المعنية بصورة أساسية بالحياة الدنيا، الواقعُ الأساسي والواقعُ”الحقيقي” هو العالم الأرضي. يظهر من جديد مصاحباً للمسيحية، وللأسباب نفسها، فنٌّ مقدس مغاير للفضاء الذي يحتوينا والزمن الذي نحياه. ومع اقتحام الحضارة البرجوازية، ومع طبقة من المنتفعين، لا تعتقد إلا في هذا العالم وقيمه المادية فحسب، يعود الفن للطبيعانية من جديد. ونشهد الآن مع أفولها ردّ فعل الفنانين العنيف ضد الحضارة البرجوازية ورؤيتها المثالية للعالم. تكشف بتعصب وعدم اتساق، في كثير من الأحيان، أنّ ذلك المفهوم عن الواقع وصل إلى نهايته، ولم يعد يعبّر عن الهواجس العميقة لدى الجنس البشري.
كانت الموضوعية والطبيعانية في الرواية سمات إضافية (ومتناقضة في حالة الرواية) لتلك الروح البرجوازية. بلغت تلك النزعة الجمالية وتلك الفلسفة السردية ذروتها مع فلوبير وبلزاك وزولا بصفة خاصة، إلى درجة أنّه بفضلها بلغنا مكانة تتيح لنا معرفة أفكار ورذائل العصر، وحتى نوع المفروشات المعتاد استخدامه أيضاً. وصل الحال مع زولا، الذي تمادى مع هذا التقليد إلى حدّالعبث، إلى إعداد مذكرات عن شخصياته دوّن بها من لون عيونهم إلى أسلوبهم في ارتداء الثياب حسب فصول العام. كما أهدر جوركي، إلى حد ما، مواهبه الرائعة كروائي بامتثاله لتلك النزعة الجمالية البرجوازية (التي أعتقد أنها بروليتارية)، وطالما أكد أنه لوصف حارس أحد المخازن يجب دراسة مئةلانتقاء الملامح المشتركة بينهم، منهج في العلوم، يتيح الحصول على السمات العالمية بإزالة السمات الفردية؛ وهو السبيل إلى الجوهر، وليس إلى الوجود.وإذا كان جوركي قد نجا بصورة شبه مستديمة من كارثة تصوير شخصيات نموذجية مجردة بدلاً من نماذج حية، فكان ذلك رغماً عن جمالياته، وليس من أجلها؛ بدافع من غريزته الروائية، وليس من منطلق فلسفته الحمقاء.
قبل عقود من استسلام جوركي لهذا المفهوم، كان ديستويفسكي قد حطمه وفتح بوابات الأدب المعاصر كلها في “رسائل من تحت الأرض”؛ فلم يتمرد فحسب على سطحية الواقع الموضوعي لدى البرجوازي، بل عندما توغل في الأغوار السحيقة المظلمة للذات، وجد أن حميمية الإنسان لا علاقة لها بالعقل، أو المنطق، أو بالعلم، أو بالتقنية البليغة.
سيشمل هذا التحول نحو الذات العميقة كل الأعمال الأدبية الكبرى اللاحقة: سواء في رحابة أعمال مارسيل بروست أم الأعمال الموضوعية ظاهرياً عند فرانز كافكا.
ومع ذلك، أكد فلاديمير وايدلي في مقاله المعروف أننا نشهد عصر أفول الرواية؛لأن فنان اليوم “عاجز تماماً عن الامتثال للمخيلة الإبداعية”، مهووس كعهده بذاته الشخصية؛ وفيما يختص بكبار الروائيين في القرن التاسع عشر، يقول:”أولئك الكتاب، أمثال بلزاك، صنعوا عالماً، وقدموا مخلوقات حية من الخارج، أما أولئك الروائيون، مثل تولستوي، فقد أعطوا انطباعاً بأنهم الرب ذاته، أما كتّاب القرن العشرين فإنهم عاجزون عن إبراز ذاتهم، واقعون تحت تأثير التنويم المغناطيسي لمآسيهم ومخاوفهم، ومستوحدون للأبد في عالم من الأشباح”.
الحقيقة المستحيلة: قراءة في التحقيق لخوان خوسيه ساير
الحقيقة المستحيلة: قراءة في التحقيق لخوان خوسيه ساير
بقلم: م. كاندلاريا دي أولموس فيليز
“من يعبث بالكلمات لن يمتلك سوى الكلمات…”
تزفيتان تودوروف، العمر الصعب، في أجناس الخطاب
1. حبكة
التحقيق
لم تحظَ رواية التحقيق (1994) بالكثير من الاهتمام النقدي، وهي نص غير مألوف في مجمل أعمال ساير. فالإيقاع السردي الوصفي البطيء الذي اعتاد عليه قرّاؤه يفسح هنا المجال أمام متطلبات الرواية البوليسية، وهو جنس لم يتعامل معه الكاتب كثيرًا. حتى لو لم تصل الرواية إلى مستوى إدراجها ضمن “الأمثلة الكلاسيكية” للرواية البوليسية، فإنها على الأقل تستعير عدداً من تقاليدها لتنظيم مادتها السردية.
الفصل الأول يعرض قضية غريبة شغلت باريس لتسعة أشهر: سلسلة جرائم قتل استهدفت نساءً مسنّات يعشن بمفردهن. رغم جهود الشرطة، لم يتمكن مورفان ولا زميله لوتريه من كشف القاتل. في الوقت نفسه، يواجه القارئ مشكلة مماثلة: حتى الفصل الثاني، لا يعرف من يتحدث ومن يروي. هذه الاستراتيجية تجعل القارئ بدوره “محققًا”، يبحث ليس فقط عن القاتل، بل أيضًا عن هوية الراوي ولمن يوجه خطابه.
يتضح في الفصل الثاني أن الراوي هو بيشون، الذي يعود إلى الأرجنتين بعد عشرين عامًا في المنفى، ويقضي مساءً مع أصدقائه توماطيس وسولدي. خلال زيارتهم لابنة الكاتب واشنطن نورييغا، يعثرون على دَكتيلوغرام لرواية مجهولة العنوان في الخيام اليونانية. يبدأ الأصدقاء بالبحث عن هوية مؤلفها وزمن كتابتها.
أما الفصل الثالث فيعود فيه صوت بيشون لاستكمال الحكاية البوليسية: القاتل – وفق روايته – ليس سوى مورفان نفسه. غير أن توماطيس يعيد بناء الأحداث بطريقة مختلفة، تُدين لوتريه. وهكذا ينتهي القارئ أمام حلّين متعارضين، أي بلا حلّ.
باختصار، الرواية ليست سوى محادثة طويلة بين ثلاثة أصدقاء على العشاء، يتنقلون بين لغز الجرائم في باريس ولغز المخطوطة المجهولة. وكلاهما يتعلق بسؤال الهوية: من كتب الرواية؟ من ارتكب الجرائم؟ النتيجة النهائية: الحقيقة تظل احتمالية، مجرّد “نسخ” أو “إصدارات” سردية.
2. شهادة بيشون غاراي
يحاول بيشون أن يثبت أنه “شاهد”، فيصرّح:
لكن “شهادته” تتجاوز موقع الشاهد المحايد، إذ يروي تفاصيل عن أفكار ومشاعر مورفان لا يمكن لشاهد خارجي معرفتها. شهادته ليست نقلاً مباشراً بل مزيجاً من الصحافة والراديو والسينما والأدب. وهكذا، يفشل السرد “التوثيقي” ويذوب في تعدد الروايات. كل “نسخة” تولد أخرى، بحيث يصبح السرد عملية مفتوحة لا تصل إلى حقيقة واحدة.
3. نسخة بيشون: مورفان ولوتريه
يقدم بيشون صورة متناقضة عن الشرطيين:
- مورفان: شرطي مثالي، حياته الخاصة تعيسة، لكنه عقلاني ومهووس بالحقيقة.
- لوتريه: أقرب إلى الشرطي الخشن في الرواية البوليسية السوداء، يعتمد على العنف أكثر من المنطق.
كلاهما يمثل نموذجاً من تقاليد الرواية البوليسية (الإنجليزية الكلاسيكية مقابل الأمريكية السوداء). لكنهما في الوقت ذاته وجهان لعملة واحدة، وكل واحد منهما “نسخة” من الآخر.مع ذلك، سرعان ما ينقلب السرد: ربما القاتل هو مورفان نفسه. وربما لوتريه. وفي النهاية، لا أحد يعرف. الحقيقة الشخصية مثل الحقيقة الجنائية: عصية على القبض.
4. انقلاب توماطيس: التلاعب بالنوع البوليسي
يتدخل توماطيس ليقترح رواية أخرى: مورفان لم يكن القاتل، بل لوتريه هو المذنب. هذه “اللا-شهادة” تقوّض الرواية البوليسية التقليدية التي تعد قراءها بحلّ نهائي يعيد النظام للعالم. عند ساير، كل نهاية ليست سوى بداية “نسخة” أخرى. النتيجة: الرواية البوليسية تتفكك من الداخل، وتتحول إلى تأمل في معنى “الخيال” نفسه.
5. الشهادة المستحيلة للجندي العجوز
أما في المخطوطة المجهولة (في الخيام اليونانية)، فنجد ثنائية أخرى:
- الجندي العجوز: حاضر في الأحداث لكنه لا يعرف شيئًا عنها.
- الجندي الشاب: لم يشارك لكنه يعرف “الروايات” المتداولة في اليونان.
الأول يملك “تجربة بلا معرفة”، والثاني “معرفة بلا تجربة”. كلاهما يبرز استحالة تقديم شهادة كاملة عن الحقيقة. وما يبقى في النهاية هو الروايات، النسخ المتعددة، أي “الخيال” باعتباره الشكل الوحيد الممكن للمعرفة.
6. الاستنتاجات
تطرح التحقيق بوضوح موضوعًا محوريًا في أعمال ساير: الصراع بين الحقيقة والخيال. الرواية تستخدم “النسخة” (version) بثلاثة مستويات:
- كتصنيف أدبي (الرواية البوليسية).
- كأداة بنائية (تعدد الأصوات والحلول).
- كتصور فلسفي عن الذات والحقيقة.
النتيجة أن البحث عن الحقيقة يظهر كمسعى مستحيل، لكن هذا الاستحالة بالذات هي ما يجعل السرد ممكناً. فـ”الخيال” عند ساير ليس خداعاً بل نوعًا من “الأنثروبولوجيا التأملية”، وسيلة لفهم الإنسان عبر الاحتمالات والفرضيات، لا عبر “الحقيقة المطلقة”.
إرنستو ساباتو: التعليم وأزمات الإنسان
التعليم وأزمات الإنسان
العالم يعاني بشدة من عدم الإيمان بالتزامن مع دوغمائيّة شرسة. أما نظامنا التعليميّ فلا يُستثنى من هذه المعاناة؛ لأنه يعدّ أصل العلّة وتبعاتها في جدلية مؤسفة؛ لأنها لا تظهر فقط في المدارس والجامعات، بل في الشوارع والمصانع والملاعب وداخل كل منزل أيضًا، عبر تلك الشاشات شبه المُشعة التي تبهر وتفتن أرواح الأطفال في الظلام وتخلّ توازنها. ومن ثمّ، لا يمكن للتعليم أن يكون غريبًا على الدراما الكليّة لهذه الحضارة، ولا يمكنه التنصل من الإخفاقات الجوهرية التي تهزّ الروح الكونية لعصرنا وتهدد بانهياره.
حتى في أكثر البلدان تحضرًا، تحوّل الاختطاف والجريمة السياسية إلى أدوات حلّت محل الحوار والعدالة. لا يتوانى فيها المتعصبون والديماغوجيون، الذين كانوا أو ما يزالون على رأس السلطة، عن إجبار المعلمين والأساتذة على استبدال السعي إلى الحقيقة بحقن أيديولوجياتهم الخاصة، وتتويج العقيدة في المكان الذي كان قد ساد فيه التسامح في أزمنة أكثر رخاءً وسعادة. وكما لو أن ذلك كله لم يكن كافيًا؛ إن ظهور التلفزيون ـ أكثر الوسائل التي اختُرعت لتشكيل وتشويه الضمائر شرًّاـ يُسهّل ويُحرّفوسائل للاعتداء والاختطاف والتعذيب. كذلك هي الحال في بلادنا، بوصفها حصيلة مشؤومة لأزمة تحوير الجنس البشري العامة.
ومن ثمّ يُرتكب خطأ فادح لدى محاولة إصلاح التعليم كما لو كان مشكلة تقنيّة بحتة، وليس بوصفه نتيجة متأتيّة من رؤية الإنسان التي تشكل أساساً للفرضيّات المسبقة التي يكرّسها المجتمع لواقعه ومصيره والتي -بشكل أو بآخر- تحدد كيفيّة الحياة والموت، والموقف تجاه السعادة والبؤس. فرضيات ساهم في وضعها الفلاسفة وعلماء اللاهوت، وتلك المعاهد التي تعمّقت من خلال الفن في الحالة الإنسانية، وحرّضت وعالجت بواطنها الأكثر غموضًا. ومن ثمّ، التعليم لا يمارس تجريديًّا، وليس صالحًا لجميع الأزمنة أو الحضارات، إنما يتم على نحو موجّه ومحدد، ويُنفّذ انطلاقًا من مشروع يشمل الإنسان والمجتمع: وعليه إن إسبرطة لا يمكنها اعتماد نظام تعليميّ مماثل لذاك الذي في أثينا، ولا نظام التعليم في البلدان الديمقراطية هو ذاته في تلك الشمولية. وقبل كلّ شيء، تمثل هذه الافتراضات دلالة على ما يُراد من شعب ما ولأيّ غرض يتم تعليمهم؛ إن كان بهدف تنشئة محاربين أو إنسانيين، أو بغرض تخريج جلادين أو بشر يحظون باحترام أقرانهم.كما أنّ أمتنا صاغت بدورها فرضياتها الخاصة فقد أسّسها مفكرون بحجم ألبيردي وسارمينتو بنهج واضح على أسس روحية وسياسية. على أنه لا ينبغي لومهم على الطائفيّة التي دمّرت تعاليمنا في فترة من الفترات. لقد سال نهر من الدماء حول العالم منذ ذلك الحين، ووصلت إلينا أيضًا المذاهب التي حوّلت في يوم من الأيام روسيا وألمانيا إلى جحيم، واقتلعت -مثل موجة المدّ العاتية- كل الخير الذي حققناه. لا، لم تكن المعطيات التي حكمت حياتنا في العقود الماضية -التي تخللتها فترات تسامحٍ قصيرة- هي ذاتها التي تقدّم بها هؤلاء المُؤسّسون، وإنّما -مع الأسف- كانت أخرى ومختلفة تمامًا.
أنا لست بيداغوجيًّا (عالمًا في أصول التدريس) ولا مُتخصّصًا في المجال التعليمي؛ غير أنني، في هذه المرحلة من حياتي، أعدّ نفسي مُتخصّصًا في الآمال واليأس؛ لأنني تَعلّمت شيئًا من الضربات التي تلقيتها، ومن الأخطاء التي ارتكبتها، من تبدّدِ الأوهام؛ أنا جاهل بأشياء لا تحصى، ومساحات شاسعة من التاريخ والجغرافيا مجهولة بالنسبة إلي؛ على أني أعرف وأشعر بأرضي جيدًا، ومصير أطفالي وأحفادي يُؤرقني، ومصير أبناء بلدي، وقبل كل شيء مصير الصغار؛ الذين لا ذنب لهم بأي شيء على الإطلاق، ولا نملك الحق في أن نورّثهم كونًا سوداويًّا. لقد تأملت كثيرًا في كل هذا، ومن خلال بعض التّخيلات غير المكتملة حاولت أن أكتشف شيئًا عن نفسي؛ أي عن أي رجل، لأن قلب الرجل هو قلوب جميع الرجال. لماذا إذاً لا يحق لي أن أدلي ببضع كلمات عن تلك العملية التي تصوغ أرواح الرجال؛ منذ مناغاة الطفولة حتى تلعثم الكِبر؟ آمل أن يساعدني المزيد من الأشخاص الأكْفَاء في إجلاء الشكوك التي تقضّ مضجعي، وتشوش مخيّلتي وأفكاري. هنا -في الوقت الراهن- أعرض مسودّات عن أوجه لشكوكي هذه.
العمى الأحمر.. قصة بعنوان: لقد كنت حلماً لفؤاد الملفوف بقامة الموت
وصفة مرق البامية مشترکة في أفغانستان وإيران، لكن مذاق الواحدة منهما يختلف عن مذاق الأخرى. كنت ضيفة عمي في مدینة هرات عندما أكلت مرق البامية الأفغانية، وقلت لنفسي ربما تختلف البامية الأفغانية عن الإيرانية. حاولت أن أتذكر طعم ما أكلته سابقاً، لكنني لم أستطع. بالنسبة إلى شخص لا يعرف من الطبخ شيئاً، يشبه تذكّر الطعم الجرف في البحر مستعيناً بالملعقة!
ربما كان مذاقه حامضاً أكثر مما اعتدته، أو قوياً أو، على حد علمي، أكثر ملوحةً. مهما كان فلم يكن طعمه يشبه مرق البامية الإيرانية. أخبرت زوجة عمي بذلك، وقلت: «يبدو طعمه مختلفاً». قالت: «إن شاء الله في أثناء إقامتكِ هنا ترتبي لنا الوصفة الخاصة بكم حتى نتعلم!».
هکذا الحال عندما تفتح فمك من دون حكمة، ولم يكن كلامك في محله. في الواقع لم أكن أعرف الطبخ على الإطلاق! كنت دائماً مستهلكة للطعام وليس صانعة له. في ثقافتنا من المستبعد جداً أن تجد امرأة لا تعرف الطبخ! الأمر كما لو كانت تقول إنني لست امرأة! کل هذا كان كفيلاً، بالنسبة إلى زوجة عمي -وهي امرأة تقليدية من عائلة باراكزاي البشتونية الأفغانية، كما أنها لم تحببني أبداً- وسبباً آخر لتعتقد أنني لا أناسب ولدها، وكلّ هذا لعبة أطفال فحسب!
كنت في التاسعة من عمري، أضع كرسياً بطول 20 سنتيمتراً تحت قدمي حتى أتمكن من رؤية داخل القِدر، وكانت والدتي تمسك المغرفة،وتقف أمام الموقد، وتلقي خطاباً مفاده أنَّ للأرز سبعة حزم؛ وعندما تفتح الحزمة الخامسة علينا أن نسكبه في المشخل للضيف، وعندما يصل إلى الحزمة السادسة لن يكون صالحاً للضيافة،لكنه ينفعنا نحن. كان هناك الكثير من الضیوف الذين یتردّدون إلى منزلنا، وكان هناك طهاة يمكنهم صنع الأرز بصورةٍ تليق بالضيوف حتى لا نشقي أنفسنا كثيراً؛ لكن والدتي كانت امرأة لطیفة تحب الكمال، وكانت تعلّمنا هذا الكمال. كنت أفكر؛ كيف يمكنني وضع رأسي في الإناء الساخن کي أرى حبات الأرز؛ حبة، حبة، وأعدّ الحزم السبع تلك. حدقت والدتي في وجهي كما لو كانت تنظر إلى ضفدع ناطق، وقالت: «عليك أن تنظري إليه بشكل كلي».
وقتها كان عليّ أن أدرك أنني لن أتعلم الطبخ أبداً. بالنسبة إلى أمي كان القدر والمكونات،التي في داخله، شيئاً عاماً يمكن رؤيته في لمحة بصر، وبالنسبة إلي كانت دائرة تحتوي من مئة إلى مئتي أو ثلاثمئة حبة أرز. في بداية تدريب الكمال كنت قد سكبت الأرز في المشخل عدة مرات، وقالت والدتي وهي تنظر بصورة عابرة: «الضيف يأكله، نحن نأكله، الكلب لا يأكله!»؛على الرغم من أنَّها لم تعطِ مما أطبخه أياً من الكلاب أو القطط أو حتى الخراف لتأكل أو لا تأكل. «هذه مخلوقات الله أيضاً، فما الذنب الذي فعلته؟»، فتتنهد بحسرة وعمق شديد،وتقول: «يا شجرتي غير المثمرة…!».
أكدت زوجة عمي مراراً وتكراراً أنني دون ثمر يذكر؛ إنما لا تعرف لماذا يجب أن يقع ابنها في حبّ مثل هذه الفتاة الدلوعة، وماذا سيحدث لنا؟! وقد تؤيد والدتي ذلك الكلام بصدق عندما تسمعه، وهو: نعم إنَّها دلوعة وشرسة.
لقد تغلّب الحبُّ عليَّ، أول مرة، عندما كنت مراهقةً، بلا رحمة وعناد، ولم أكن أعرف ماهيته جيداً إلى درجة أنني كنت أقضي كل وقتي في المشاجرة وسوء المزاج! كنت أرغب في ذلك، ولم أكن أرغب فيه، واستطعت أن أرى، من كلّ قلبي، القوةَ تغمرني وتشدّنی بشكل لا إرادي خلفها! بالنسبة إلي، أنا التي تسكن في إيران، وحبيبي في أفغانستان، يرتبط الحب بكلمات خاصة: إدارة الهجرة، الحدود، بطاقة المرور، الطالب الأجنبي، بطاقة الهوية، المذهب… أيّ شيء يمكنه أن يقلل أو يطيل المسافة بيني وبين ابن عمي.
كانت زوجة عمي قد غسلت البامية، التي مثل البامية الإيرانية، ونشرتها في صحيفة، ثم سألتني: «حسناً، وماذا أنتم تفعلون؟!».
قلت: «أوه. إذاً أنتم تجففونه بعد غسله. لا، نحن نسکبه بعد الغسل مباشرة في القِدِر».
إنَّ العثور على غطاء لعدم المعرفة یکون أكثر تعقيداً من الاعتراف بعدم المعرفة نفسها. وكلما انخفض الادعاء أصبح الأمر غير مقبول. زوجة عمي، التي رأت عنادي مرات عديدة، اكتفت بابتسامة ناتجة عن السخرية.
في تلك السنوات، من أجل سعادة أمي وزوجة عمي؛ كنت أسعى لأن أثمر؛ أن أفعل شيئاً تعتقدان أنَّني أستحق به أن أكون امرأة. في الواقع أستحق أن أكون امرأة لفؤاد.
لقد بدأت بكتاب الطبخ الذي كُتِب فيه: مئة جرام من الزبدة، مئتان وخمسون جراماً من شرائح لحم العجل… لكن المذاق ما زال ليس جيداً! تقول أمي: «في بعض الأحيان الأمر عائد إليك». لم أستطع فعل أيّ شيء يُذكر سوى ما ورد في ذلك الكتاب؛ حتى وإن حدث وخبزت كعكة الليمون من الكتاب نفسه، ونجح الأمر؛ إنَّه لاكتشاف مهم في أيام امتحان قبول دخول الجامعة في سنّ السابعة عشرة. يختلف الطهي عن خبز الكعك والمقبلات؛ لا يمكن خبز الحلويات الاستعانة بالعينين. يجب أن يكون حجم المواد ودرجة حرارة الفرن دقيقين.
قلت لزوجة عمي: «موقدك من طراز روسي قديم، ولأنَّ الطقس في روسيا أكثر برودة سيكون اللهیب في هذه المواقد أعلی بكثير. من الجيد شراء موقد جديد من إيران». الأمر كان أسخف من قول إنَّ رأس شعب الطاجيك أكبر من رأس شعب الأفغان؛ لذلك إنَّ نشل القبعات لا ينفع.
قالت زوجة عمي، وهي التي لم تكن امرأة بسيطة: «لكنّ الموقد الروسي أفضل بكثير من الموقد الإيراني».
أنا لست خبيرة في المواقد، لكن كان عليَّ الدفاع عن فكرتي البسيطة، فقلت: «لكن البامية سَتُسحق بسرعة لو غلت كثيراً منذ البداية».
قالت: «حسناً يا فتاة. إذاً سنقلل اللهيب كي لا تغلي بسرعة».
قلت: «لا يمكن ذلك؛ لأنَّ موقدك من صنع الروس».
لقد أصبت الهدف. جاء صوت عمي من الجهة الأخرى: «لقد صنعوا كلّ شيء لنا، وأخذوا كلّ شيء منا. اسمعي الكلام يا صفية».
مع تصاعد نقاشهما، أدركت أنَّهما لن يبقيا في هرات. اليوم، أو غداً، سيذهبان إلی دوشنبه. إذاً، لماذا دوشنبه؟
لقد أشغلت نفسي بأدوات المطبخ الخاصة بهم. كان لدى زوجة عمي رف للبهارات، وكانت قد ألصقت اسم كلٍّ منها علی الزجاجة الخاصة به. شيءٌ مثل الكمون مكتوب على الزجاج الخاص به: «قدم الفتاة»، وشيء مثل الكركم اللامع قليلاً: «روح ليلي»، وأعواد تشبه أعواد القرفة، لكنها حمراء: «نكاره». قفزت في منتصف جدل عمي وزوجته، وقلت: «کم هو جمیل. لكلٍّ من النكهات هنا اسم امرأة. تذهب النساء هنا داخل الطعام ليجعلنَه لذيذاً».
رد عمي: «نعم طعمها کطعم سمّ الحیة…».ووضعت زوجة عمي سلّة بامية أمامي.
لم تكن لدي طريقة أخرى للهروب، فقلت: «علینا فصل خمس وثلاثين حبة بامية من الطول والحجم نفسيهما».
نطقتُ بعدد الخمس والثلاثين هكذا بصورة عفوية وبدافع اليأس. عندما كنت في السابعة عشرة من عمري، كنت أزن حبات حلوی الحمص بعناية، وكنت أعد كلّ خمسٍ وثلاثين حبة، ثم أقوم بتعبئتها في أكياس بلاستيكية معقّمة. وترسل والدتي عبوات الحلوى إلى جميع الأقارب، ثمّ تنقل الأخبار إلى أفغانستان عبر الهاتف. بطبيعة الحال، لم يكن يهمّ فؤاد إطلاقاً ما إذا كنت أخبز الحلوى أو لا، كانت رسائله مليئة بالشوق والحماسة لقراءة الأدب، وبحلمه بتحرير أفغانستان. تبدأ رسائله على هذا النحو:
«لقلبي الوحيد.
الاستبداد لن يدوم طويلاً، وستكون حياته لا حول لها ولا قوة وخجولة أمام ظهور الناس…».
وبعد هاتين الجملتين، یكتب لي وصفاً لِمَا كان يمرّ به ويفعله؛ لكنّني كنت أحاول أن أكون امرأة. بعد عام لن يصنع أحد الحلويات في منزلنا، إلا إذا قام باستشارتي، أو أذهب أنا إلى الفرن وأدواته كي أضبط درجة الحرارة والحجم. كان هذا النجاح نتيجة اهتمامي بالتفاصيل، وحاولت أن أقدّمها بشكل جيد، كما بدت والدتي مقتنعة بأنَّ ابنتها المراهقة، رغم نفاد صبرها وشوقها، تريد أن تكون امرأة، وأن يكون لها زوج.
قلت لزوجة عمّي: «الماء الذي نصبّه في الإناء يجب أن يزن خمساً وثلاثين حبة بامية. تحتاج إلى نصف لتر من الماء».
قالت: «حسناً، كيف لنا أن نزن الماء الآن؟!».
قلت: «باستخدام زجاجة مياه معدنية».
صببت زجاجة مياه معدنية وخمساً وثلاثين حبة بامية في القِدر.
صاح عمي من مسافة بعيدة: «لقد دمّرنا الروس كثيراً، فكيف لهم أن يرسلوا لنا الماء والخبز الآن؟! يا لكم من ملاعين. ما هذا العمل يا تری؟ أين كنتم عندما كنا في النعيم؟!».
عمي مثله مثل جميع رجال الأفغان؛ كان متورطاً في الضغوط الاقتصادية والسياسية، والآن، بعد عشرين عاماً من الوجود السوفييتي، أصبح مؤيداً ومريداً لأحمد شاه مسعود، وكان يصفه بأنَّه بطل قومي، ويخبرنا أنَّ شاه مسعود يأكل خبز الشعير حتى لا يلوث الخبز الأبيض للروس فمه. إنَّه لأمر غريب أن يصدر مثل هذا الاستحسان من عمي، وهو من جذور عائلة إقطاعية! لكن هل تترك الحرب أيّشيء كما هو؟! بدا لي أنَّ الروس كانوا موجودين في سلال الخبز والأواني، وفي مطبخ صفية والعم، والطعام له مذاق كمذاق الحرب! عندما قلت هذا، أجاب عمي: «أنا لا أفهم ما تقولين! لكنني أعلم أنَّ الروس لو استطاعوا لوضعوا البطاطا الروسية فی هذا الطعام حتى تحرق حناجرنا».
عندما تورّم وريد رقبة عمي، كانت البامية الأفغانية تغلي مع صلصة الطماطم الإيرانية في القِدر، ونسيتُ كم جراماً من الملح يجب أن… قلت لزوجة عمي: «كيف تضيفين الملح؟».
رمقتني بنظرة، مع علمها بأنني لا أقصد كيفية التقاط غطاء الإناء ووضع الملح فيه، فقالت: «هنا علينا أن نستعين بالعينين». طريقة أمّي ذاتها! وهو ما لم أكن أعرفه أبداً.
عندما مددنا مائدة الطعام، بدا أنَّ البامية الأفغانية في الصحن الزجاجي قد هُرست وتلاشت. لم أرشّ الملح، ولم تفعل زوجة عمي ذلك أيضاً، فقلت: «عمّاه، هل عرفت أنَّ حجم قارورة المياه المعدنية الروسية لم يبلغ خمسمئة ميللتر، وحجم هذه جميعها سبعمئة ميللتر؟ انظر كيف انهرس طعامي…».
وكأنَّ مائدة الطعام غدت ساحة لكل تاريخ أفغانستان النضالي، دفع عمي الصحن بغضب، وقال: «تباً لهم. انظري أيّ لعبة يلعبونها معنا! إلى متى سيستمر هذا البؤس؟!».
فسكتنا جميعاً، وتناولنا طعاماً مهروساً غير مملّح.
فدائماً ثمّة طريق للهرب؛ إحداها أن تسلط الضوء على أهم الأشياء حتى تقلّل فداحة عدم معرفتك. ومن المؤكد أنَّ الحرب في أفغانستان كانت أكثر أهمية بالنسبة إلى عمّي من مذاق البامية التي أعددتها أنا وزوجة عمي. وبطبيعة الحال، كان عمي أكثر ما يعنيني من بين جميع أولئك الذين كانوا يجلسون حول مائدة الطعام تلك. لم أكن أعرف أيتعيّن أن أكون ممتنةً الآن لشاه مسعود أم للمياه المعدنية الروسية! لكنني وجدت ضالتي، وقررتُ أن أفعل ما أتقنه؛سأقصدُ صباح الغد سوق هرات، وأبتاع عدداً من قوالب المعجنات، وأطحن السميد وأصنع كعكة لذيذة، لذيذة جداً إلى درجة ألا أضطر إلى تبرير ما لا أعرفه منتهزةً تعب الآخرين.
ذهبت وتجولت في السوق الذي مزقته الحرب، وكان ذلك قد حدث عام 2011 م؛ إذ كانت طالبان قد رحلت، وفي الوقت ذاته لم ترحل!وباعتقادي، كان ثمة ثمانية من بين كلّ عشرة رجال يناصرون طالبان. لم أعرف ما إذا كنتُ قد تعرّفت بشكل صحيح أو ما زلت في حالة صدمة من ذلك الطعام! فقد رأيت رجلاً يعتمر قبعة تشبه قبعة شاه مسعود، ويلف إزاراً طالبانياً حول خصره، ورأيت امرأة وشمت ذقنها بأربع نقاط رافعة برقعها، وقد ظهر شقّ صدرها، ورأيتُ طفلاً كان بائعاً في متجر أسلحة وطيور، يلحسُ البوظة… كانت ثمة صور كثيرة متناقضة، لم تدعني أعرف حقاً ما هذا المكان، ولماذا ليس شبيهاً بهرات؟! استمعت إلى كلام أشخاص يتبادلون أطراف الحديث، وبدا الأمر كأنني في مقاطعة ذاتية الحكم في باكستان. باكستان، السعودية، مدن إيران الحدودية… وبدا سوق هرات كأنَّه حالة اختلاط من كلّ شيء يمكن نسبته إلى مدينة مزقتها الحرب في الشرق الأوسط. كانت سُفرة مرقة البامية الخبيصة والقذرة التي أعددتها قد مُدت في السوق، وكنت أبحث عن طريقةٍ لإثبات شرعیتي المفقودة!ابتعتُ الدقيق والبيض من رجل يتكلم لغة البشتو. ولم يكن الميزان الرقمي الألماني معي، ولم يكن أمراً مستبعداً ألا يسعني إنجاز هذا العمل؛ لكنني فكرت في أنَّ البحث عن الميزان هنا، وفي هذه الحالة، ربما سيكون أغبى شيء يمكن القيام به.
رأيت عدداً من الرجال المسلحين في أماكن عدة من المدينة، وبدا زيهم كأنَّ آخر الزمان قد حان، وهمست امرأة في أذني: «قوات الناتو»، كأنَّه لا ينبغي نطق كلمة الناتو بصوت عال! «لا تحدقي فيهم. عندما يشعرون بالخوف يطلقون النار».
كنت أنا والآخرون مثلي نثير الرعب في قلوب هؤلاء المسلحين الذين يرتدون سترات واقية للرصاص. ولم أعرف، بعد أن انتهت الحرب، من بات عدوَّ مَن الآن؟!
لم يكن في هرات شيء يشبه سابقه على الإطلاق؛ سوى العم وبيته. وعندما عدت رأيت عمي جالساً بجانب بساط الأفيون منكباً على تدخينه، فصاح من أعلى المصطبة بفرح: «مرحى مرحى، لقد وصلت طاووس عمها».
اقتربت، فعانقني قائلاً: «لماذا لم أحضنك من قبل؟! لماذا نحلت، وأصبحت تبدين مثل حيوان السمور؟!».
فوضعت كيس التسوق بجانبي، وقلت: «يا عمي، ما هذا بحق الجحيم؟! يبدو أنَّ رائحة طالبان ما تزال تفوح من المدينة برمتها! كان الناس يحتفظون بملامحهم، فكيف أصبحوا يشبهون الباكستانيين؟! إذ كانوا قبل هذا كالإيرانيين!».
فتابع عمي بفرح: «أي نوع من الأزواج لديك؟ الماعز أثقل منك وزناً. لو كنتِ عروسي…».
أسررنا أحدنا للآخر بأمور عدة، وانكب عمي ثانيةً على غليونه، وانحنى على نار بقايا جذور القطن المشرفة على الخمود. وبدا الأمر كما لو كان قبل عشرين عاماً من الآن؛ إذ قفزت في الغرفة، وقلت باكيةً: «عمي. ابنك يقول: لا أريدكِ». كان عمي قد استخدم اسم حيوان كعادته، وقال: لأنَّه بغل! لكنْ، بدلاً من ذلك، أنت كالنمر البنغالي بالنسبة إلي».
فتركته. كان هذا التذكر خارجاً عن طاقتنا جمعياً. وبدأت يداي ترتجفان مرة أخرى. بعد كل هذه السنوات لم آتِ لأسمع كلام ابن عمي!
كان صيف عام 1999… كنت في الثمانية عشرة من عمري، وكان ابن عمي في العشرين من عمره. وكان قد كتب في رسالته عن شولوخوف، قائلاً: «إنَّهم يجمعون، خلال هذه الأيام، الروايات من مكتبة جامعة كابل»، فكتبت إليه رداً: «الفوضى تعم طهران، والأوضاع متأججة. لقد طردونا جميعاً من السكن الجامعي، وقالوا لنا اذهبوا إلى بلادكم حتى إشعار آخر».
ثم انقطعت أخبارنا عن بعض. لم يردّ أحد على اتصالاتي. كنت قد كتبت ثلاث رسائل ولم أتلقَّ رداً عليها! كان امتحان الطلاب الأجانب يقترب، وكان يتعين على ابن عمي المجيء إلى إيران؛ كنا نحب بعضنا مثل طفلين على جانبي حدود رسمها الآخرون، فاعتقدت، عندما يأتي، أنَّعمي أو أبي سيأخذان لنا منزلاً، ونتزوج، وتنتهي الحكاية؛ لكن بقي هذا الأمر مجرد أحلام تراود عمر الثمانية عشرة. وفي أغسطس من العام نفسه، اتصل أحدهم، وأطلعنا على خبر مقتل ابن عمي! قالوا إنَّ هجوماً قد شُن، فكُسرت عنقه، وتلقى طعنة في صدره، وفُتِح وريده. لقد قُطعت أوصال حبيبي النحيف الأبيض بهيّ الطلعة! كنت ناضجة إلى درجة تكفي لأقع في الحب؛ لكنني كنت أصغر حيال إدراك حقيقة الموت. كانت ذروة هجوم طالبان وصراعهم مع المجاهدين؛ فلم أستطع الوصول إلى أفغانستان. كانت طالبان قد هجمت، وكان حلفاء فؤاد من المجاهدين اليساريين قد كشفوا عن اسمه، وأفشوا كل عمليات اليساريين؛ لكن لم يتضح من الذي قتله. وهل ثمة فرق في ذلك؟!
مكثت في إيران، وكنتُ أنظر إلى الحدود من الجبال. أمسك التراب بقبضة يدي، وأضرب الأرض بها، وأبكي على جسد حبيبي الشاب. كنت قد أصبحت هرمة بسبب المعاناة، كهلة للغاية… وبدأ ارتعاش يدي منذ ذلك الوقت.
لم يعرف أصدقائي في طهران أيّ شيء عن ألمٍ في سن الثامنة عشرة، لم يعرفوا شيئاً عني على الإطلاق! إذ كنت واحدة منهم ببطاقة هويتي والبطاقة الوطنية الإيرانية، ولم أخض في مغامرات الحرم الجامعي والحركة الطلابية. لم أذهب إلى طهران، ولم يسعني الذهاب إلى منزل عمي. انهار تمثال بوذا في باميان، وبثّت التلفزيونات الإيرانية والعالمية صوراً مرات عدة؛لكني كنتُ أستمتع بصورة واحدة فحسب.
كان ثمة شخص بحجم حبة الحمص أمام تمثالي باميان قد قُتِلَ قبل سقوطه. تباً لباميان! تباً لتراث الأرض! ولم يرَ أحد معاناتي! كان التلفزيون يبث مشهداً لدخان يتصاعد من تمثالي بوذا. كنتُ قد تقوضتُ قبل بوذا، كنت عروساً حزينة لم يكتمل زفافها، ولم يسعني البوح لأحد بهذه المعاناة.
لا ينبغي لعمي أن يتحدث عن آلامنا المشتركة! كانت قد مرت سنوات، وتزوجت، ورُزقت بطفل، وها أنا أمارس لعبة الطعام والحلويات. كان ثمة شيء يمسك خناقي؛ تذكرتُ والدي عندما جمع صور ابن عمي وأضرم النيران فيها. هل أتذكر الطبيب النفسي الذي سألني: هل قبلته؟ هل رأيتِ جثمانه؟ أتذكر المعلم الذي كان يقول: هذه هي الحرب وتداعياتها. وحينما صرخت بشكل لا إرادي في الصف، ولم أخبر زملائي عن ألمي؛ذكرني عمي بأنّني كنت عروساً لم يكتمل زفافها، ثم عاد وانكب ثانيةً على أدوات تدخين الأفيون.
نهضت وذهبت إلى المطبخ أحمل أكياس التسوق. كان ظهر صفية محنياً تغسل الأطباق، منكمشة كما لو كانت تعاني آلام الظهر.
قلت: «لم أحسن طبخ البامية. أريد أن أصنع كعكة».
فالتفتت نحوي، وكانت نظراتها مفعمة بالألم، كما لو أنَّها كانت تبكي؛ فخلتها بالتأكيد قد سمعت حديث العم، فقلت: «هل أنت بخير يا زوجة عمي؟».
فأجابت: «ماذا تحتاجين حتى أحضره لكِ؟».
فهمت أنَّها لا تريد أن تتحدث، فقلت: «الفرن الخاص بالكعك فقط».
فنکست رأسها، وتابعت غسل الأطباق، وكأنَّها لم تسمعني. لم تكن على ما يرام، وكنتُ -أنا التي تتفوه بالترهات- مدينةً لها بشدة! فاقتربت منها، وأخذت الطبق من يدها، وقلت: «لا بأس يا زوجة عمي. بصراحة أنا لا أجيد الطبخ على الإطلاق. لقد قلت هذا يوم أمس لأجعل عمي سعيداً فحسب».
فجأة، أفلتت صفية الطبق، وصفعتني على وجهي بيدها المبللة… أبرد صفعة في العالم!
لا أعلم كم سنةً يلزمني حتى يسعني نسيان صوت الصفعة! لا أعرف لماذا صُفعت، وخجلت جراء تلك الصفعة أيضاً.
وقالت: «بعد مرور عام تأتين من إيران كي تجدّدي حزننا، وتطبخي لنا؟».
وعدت مجدداً إلى وقت موت ابن عمي، وصوت عمي الذي كان يصيح في الهاتف: «حمامة كابل الدامية…».
تكررت جملة عمي في رأسي، وصفعة صفية التي أدارت رأسي بالكامل. لا، ليس ثمة مذاق يمكنه أن ينقذ عائلتنا المدمرة. كنتُ أشعر بوجود مذاق كالسم، وذلك حينما مات حبيبي، وأطرقتُ رأسي، ونزلت إلى الطابق السفلي لأطبخ مرة أخرى، كي أكون محطّ قبول أولئك الذين عملت بجد لأظفر باستحسانهم. والآن أصبحت عاجزة من حبٍّ يرقد حبيبه في المقبرة!
قالت صفية: «سنذهب إلی مدینة دوشنبه حتى يأخذ عمك بثأر ابنه. جنسكم مصنوع من الحقد.جئت به من كابل إلى هرات كي ينسی، لكنه لم يفعل. يقول أنا من قتلت ولدي».
وجلست على أرضية المطبخ، وشرعت بالنحيب.
لم أكن أعرف كيف سينتقم عمي المدمن على الأفيون والضعيف، وممّن سينتقم؟! إذ لم يُعثر على قاتل ابن عمي إطلاقاً، وكانوا قد حملوا إحدى يديه من جثته الممثَّل بها كعلامة على الحقد، اليد نفسها التي كانت تكتب لي كل تلك الرسائل الغرامية، اليد التي أمسكت بيدي، ووعدتني بألا تتركني أبداً.
تعالى صوت عمي المنتشي والملازم لسفرة تدخين الأفيون، وهو يغنّي أغنية لأحمد ظاهر، وأخذت صفية، التي كانت تجلس على أرضية المطبخ، تمسح وجهها براحتي يدها الملطختين برغوة الصابون. مرت خمسة عشر عاماً، ومازلتُ أتألم كأنني أنا المذنبة!
يمكن لمثل هذه المعاناة أن تجعل الإنسان بائساً، وبدا الأمر كما لو أنّني من حركة طالبان، أو شيوعية، أو من المجاهدين. كنتُ قاتلة؛ لأنني أنا الضحية، وبقيت على قيد الحياة. ربما لم تكرهني صفية من صميم قلبها، لكني نكأت جراحهم مجدداً بحضوري وإصراري على إظهار ما حدث كأنَّه أمر طبيعي! استحققتُ تلك الصفعة؛ حيث أردت أن أقول إننا ما زلنا سعداء. تزوجتُ من رجل آخر، وسقطت طالبان، وها هم يرممون تمثالي بوذا من جديد… كان من الجيد لو يهدأ عقلي قليلاً. إذاً، لمَ يعيدون بناء معاناتنا؟! هل يمكن إعادة بناء يديّ فؤاد وجسده أيضاً؟!
مددتُ يدي نحوها: «انهضي يا زوجة عمي».
فدفعتني، فأمسكت بكتفها بإلحاح، لكنها صرخت، وأخذت تئنّ بصوتٍ عالٍ من الألم! فسحبتُ يدي برعب، وانزاحت ياقتها المفتوحة. كانت مؤخرة عنقها مجروحةً، وبدت لي الجروح في أماكن عدة قديمة، وفي أخرى جديدة وملتهبة. كان اللحم قد برز من تحت الجلد مثل القروح… فتمتمت: «أخخ..»، ثم أبعدتُ يدي.
كان مكان الحرق ناجماً عن سفود المنقل، ولم يغفر عمي لصفية إرسال ابنها إلى كابل للدراسة؛ ابنها الذي عاد جثماناً هامداً. وفي كل مرة كان يعتريه الحزن جراء ألم التذكر. كانت صفية، المكلومة والمحروقة والحزينة جراء الألم الذي كانت بريئة منه، تُعذَّب. لم لا تصفعني بالقدر ذاته الذي كنت أبدي فيه فرحاً مصطنعاً وكاذباً؟!
لم تنتهِ الحرب؛ لكنني لم أرَ عمي إلى حين موته! إذ كنت أبحث بروحٍ مكلومة عن يدٍ تمنّعت المقبرة عن استقبالها، يدٍ أرادت أن تكون كاتبة، وخرجت الآن من كمي. لم أكن أنا نفسي منذ الثامنة عشرة من عمري، بل كنت حلم فؤاد الملفوف بقامة الموت!
فِي ثقل التساؤلات، حيوات أُخرى
نوره بابعير
تظلُّ التساؤلات، منذ فجر الفكر الإنساني، هي البذرة الأقوى في حقل الوعي، والنبع الذي لا ينضب مهما حاول العقل أن يرويه.
كيف لعقلٍ أن يتشبث بسؤالٍ واحد، ثم لا يلبث أن يحيله إلى همسٍ داخلي يتكاثر كالنار في هشيم الفكر، حتى يغدو ثرثرة صاخبة ترفض السكون؟ وكيف تتحول تلك الثرثرة إلى غذاءٍ للعقل، لا يعرف الشبع منه إلا حين يظفر بغاية السؤال، فيدرك عندها أن الوصول ليس نهاية، بل بداية لأسئلة أخرى أكثر عمقًا وإرباكًا؟
كيف للإنسان أن يفرغ نفسه حتى يصبح كصفحة بيضاء تنتظر الحبر الأول، ثم كيف يمتلئ حتى يكاد يفيض عن ذاته؟
هل الصمت امتناع عن القول، أم أنه كلامٌ آخر لا تُدركه الأذن، بل تصغي إليه الروح؟ وهل الكلام امتلاء بالمعنى، أم محاولة يائسة لسد فراغات الوجود بما نظنه أفكارًا؟
إن الحوارات ؛ حين تكون صادقة ، تُشبه عدوى فكرية تنتقل من عقلٍ إلى آخر، فتثريه بما يحمله من ذخائر المعرفة والرؤى، لكن السؤال الأعمق: كيف يمكن للإنسان أن يبقى هو نفسه وسط هذا التبادل العميق؟ وهل الثبات على الذات فضيلة، أم أن التحول هو جوهر الحياة؟
ربما لا نعيش بالحقائق بقدر ما نحيا بالأسئلة. فالأسئلة تمنحنا القدرة على إعادة النظر في أنفسنا وفي العالم، وتُربك يقيننا كي لا يتحول إلى جمود. لعل الإنسان، في نهاية الأمر، ليس سوى كائن يبحث عن نفسه بين ما يفرغه من فكر وما يملؤه من دهشة، بين صمته الذي يفتح أبواب التأمل، وكلامه الذي يوقظ الآخرين. وربما تكمن الحكمة الكبرى في أن ندرك أن امتلاءنا لا يكتمل إلا حين نتقن فن النقص، وأن الوصول إلى الإجابة ليس إلا بداية طريق نحو سؤالٍ آخر أكثر اتساعًا .
لكن، ماذا لو كان السؤال نفسه كائنًا حيًا يعيش فينا؟ ماذا لو كان هو الذي يختارنا، لا نحن من نختاره؟ ربما نحن لسنا سوى أوعية مؤقتة للأسئلة التي تبحث عن أجساد لتسكنها، عن عقول لتدور فيها، وعن قلوب تتسع لثقلها ودهشتها. وربما لهذا السبب، كلما حاولنا إغلاق باب التساؤل، تسللت الأسئلة من شقوق أخرى، لأننا وُجدنا لا لنسكن في الإجابات، بل لنتنقّل بين احتمالات لا تنتهي.
إن الامتلاء الحقيقي لا يأتي من تراكم الأفكار، بل من القدرة على النظر في أعماقها، في مساحات الظل التي تخفيها، وفي المناطق الصامتة التي لا يقترب منها ضوء اليقين. الإنسان الذي يكتفي بما يعرفه، هو إنسان أغلق أبواب بيته الفكرية وعلّق على الباب لافتة تقول: “المعرفة هنا اكتملت”، لكنه لا يدرك أن الغبار سيتراكم على جدرانه الداخلية حتى يختنق.
لذلك، ربما كان أعظم ما يمكن أن نفعله هو أن نعيش كما تعيش النهر: متحركين دائمًا، نستقبل ما يأتي من منابع جديدة، ونتحرر مما لم يعد صالحًا للبقاء. أن نكون كالأفق، لا يكتفي بلون واحد، بل يتشكل مع كل فجر وكل غروب.
في النهاية، قد لا نعرف هل نحن من نصنع الأسئلة أم أن الأسئلة هي التي تصنعنا، لكن المؤكد أن حياتنا، بكل ما فيها من فراغ وامتلاء، من صمت وكلام، ليست سوى محاولة طويلة لفهم ما لا يمكن فهمه بالكامل. وهذا هو سر جمالها.
عبدالله ناجي: اللغة و الخيال أحلّق بهما في سماوات الكتابة الإبداعية
نوره بابعير
كان عبدالله ناجي مهتمًا بالمعنى الحقيقي لمفهوم الكتابة، وكانت له وجهة نظر خاصة من هذه الزاوية، مقتبسًا من الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت قوله: “أنا أفكر، إذن أنا موجود”. فجعل من هذه العبارة مرجعية فكرية ومعنوية، وأعاد صياغتها على طريقته قائلاً: “أنا أكتب، إذن أنا موجود”.
ربما كان في هذا المعنى شيء من العمق، مما دفعه للتوغل أكثر في إبراز هويته ككاتب وشاعر وروائي. كان يرى أن الكتابة شكل من أشكال التذكار، تُبقي ذهنه يقظًا، وتحفّز ذاكرته. كلما كتب، انغمس في التفاصيل، وكلما فكّر، نفض عن ذاكرته غبار النسيان.
الكتابة بالنسبة له وسيلة لتوثيق اللحظات، من خلال سرده، وشعره، ورواياته.
الكاتب والشاعر عبدالله ناجي صديقًا وفيًا للغة، والشعر، والرواية. خاض تجارب كتابية عديدة، يمتلك فيها الإبداع، ويصقل المعاني من خلال لغته الثرية وأسلوبه المتفرّد
-هل تؤمن بأن الشعر تجسيد للجماليات؟ وكيف ترى ارتباط الشعر بالفلسفة؟
التجسد الأول للشعر كان البحث عن حقيقة الوجود، ومن هنا ارتبط الشعر بالفلسفة برباط خفي أزلي، فكلاهما باحثان عن الحقيقة، الأولى شعرية والثانية فلسفية. ولأن الحقيقة عبر طريق الشعر تتخذ أشكال عدة بينما تحتفظ بجوهر واحد، وهو الجمال أو الفن، فإن الشعر اتخذ المكانة الأعلى فيها، فالحقيقة الشعرية متأصلة في الذات والكون، غير مفهومة المعنى ولكنها تعاش بكامل أناقتها الفنية والجمالية، وتتنقل بالإنسان فضلا عن كونه شاعرا من مرتبة وجودية إلى مرتبة أعلى. ذلك يشبه التصوف أو الترقي بشكل ما، ولكنه لا يعبأ بالطقوس، فالشعر طقس بمفرده، وحالة كامنة في اللاوعي، تنبثق في الوجدان، وتتجلى في المعاني والأشياء، وإلى ذلك الطقس المفرد تنجذب الفنون بكل تنوعاتها. ولا أعني بذلك الوقوف على الشكل الشعري النظمي، بل أطير إلى المعنى الحقيقي والاتساع الأجمل، فكل جمال أو فن أو حب أو بهاء أو رؤية هو شعر أو حالة شعرية. والشعرية أعم من الشاعرية، إذ هي التجسيد الكامل للجماليات، أو النظر إلى الجمال الكامن في كل شيء.
-ما مكانة الشعر في حياة الشاعر؟ وهل ترى أن له تأثيرًا عميقًا في تجربته الشخصية والوجودية؟
إذا ارتبط الإنسان بالشعر كباعث له وخالق لمفرداته فإن حياته تصبح مرهونة للشعر، وبه يتكون وجوده. فهو مسكون بهواجسه وطقوسه، يعيش في دائرته داخل دائرة الحياة، ودائرة الشعر أرحب لأنها الجمال ذاته. ومن هنا تتحدد مكانة الشعر في حياته، وتتجدد، فالقصائد هي تجلياته المتعددة، ولكل قصيدة روح تعيش بها بعد أن ينفخ فيها الشاعر من روحه، ويهبها الكثير من نفسه ويودعها مشاعره وأحاسيسه. والروح هي من تصنع تجربة الشاعر على الحقيقة، لا مجرد نظم الأبيات وإبداع التراكيب، ومن تلك الروح ستتوالد علاقات جديدة بين الكلمات وتتسع الرموز وتتجاوز حدودها الأولى. ويصبح الـتأثر والتأثير متبادلا بين الشاعر وقصيدته، وكلما تجذرت الروح في المعني الشعري تعمقت التجربة الوجودية في ذات الشاعر وفي شخصيته. وما يدل على أثر الشعر في شخصية الشاعر هو نظرته المختلفة للوجود بكلّيته وبأجزائه، فيرى في الموجودات معنى قد لا يراه غيره، ويلتقط فكرته من شيء لا يأبه له سواه.
-الكتابة مشروع أدبي متكامل، كيف يتعامل عبدالله ناجي مع هذا المشروع؟
تختلف الكتابة الأدبية من مشروع إلى آخر، ومن تجربة إنسانية أو اجتماعية إلى ثانية، وحتى في المشروع الشعري على سبيل المثال تتنوع طريقة تعاملي مع القصيدة، هناك نصٌ شعريٌ يكتب نفسه في اللحظة ذاتها، وينتهي بانتهائها، ويبقى عليّ تنقيحه ومراجعته، على أن هذا النص لا يمحنك فرصة المراجعة كثيرا، فغالبا ما يجئ مكتملًا كأنما انفتحت بوابةٌ من مكان ما، ودفع عربة القصيدة عدد من الشياطين أو الملائكة ثم اختفوا بعد ذلك واختفت معهم تلك البوابة. وهناك قصيدة تتشكل على مراحل وتتخذ سلما شعريا ترقى فيه وتأخذ كامل وقتها في البناء والتجلي. ويتجدد تعاملي مع الشعر غالبا في لحظات ذلك التجلي والفيض. أما في السرد فيختلف التعامل عطفا على اختلاف الفن والمشروع الأدبي والاستعداد النفسي والتهيؤ الداخلي، ففي الرواية يتطلب المشروع استعدادا نفسيا وذهنيا كبيرين، لا ينتهي بانتهاء مرحلة الكتابة، ويبدأ قبل الدخول فيها بكثير، فهناك التخطيط الذهني للمشروع، ورسم الهيكل العام للرواية، وتحديد الشخصيات الرئيسة التي بها يبدأ ويقوم العمل، وقبل ذلك الإمساك بفكرة أو حدث أو حكاية تنبثق منها باقي الأحداث والفصول والشخصيات، ثم يتحول المشروع إلى هاجس وحلم وواقع يعيش معي طيلة مدة إنجازه سواء كنت جالسا إلى طاولة الكتابة أو كنت أمارس حياتي بكل تنوعاتها، يظل المشروع هاجسي ويتمدد في وجداني ويحدد لي العديد من اختياراتي في الحياة، فكأنما تتجول شخصيات الرواية معي وتعيش واقعي.
-الكتابة الإبداعية تكشف عن احترافية أدواتها، فما الأدوات التي يعتمد عليها عبدالله ناجي في الكتابة؟ وهل تختلف أدواته في الشعر عنها في الرواية؟
اللغة والخيال، لا أنفك أحلّق بهما في سماوات الكتابة الإبداعية بشقيها الشعري والسردي، ولا وجود لفن كتابي على حقيقته من دون هذين العنصرين، فهما أكثر من كونهما أداتين من أدوات الكتابة، ومع ذلك فهما أكثر ما يكشف عن احترافية الكاتب وسر جمال النص، وبطبيعة الحال والتجربة تأتي أدوات أخرى بعد ذلك لتساهم في إبداع تلك الكتابة والتجربة الأدبية، في الرواية مثلا تعجبني كثيرا لعبة الزمن، وتعدد المسارات الزمنية كما في ” حكايتان من النهر ” أو الانطلاق من لقطة الختام لتكون هي فاتحة الرواية كما في منبوذ الجبل، أو تكثيف الزمن ظاهريا وتمديده في المونولوج النفسي لشخصيات الرواية كما في حارس السفينة. أيضا هناك أداة مهمة اعتمد عليها كثيرا في رواياتي وهي في الأساس جزء من تكويني، تعميق النص من خلال أحداثه وشخصياته، وهذه الأداة تقودني إلى أداة أخرى وهي الترميز والذي يفتح مجالات للتأويل وتعدد القراءة، حدث ذلك معي جليا في حارس السفينة وماتزال إلى الآن تُقرأ بصيغ جديدة ومختلفة على الرغم من مرور خمس سنوات على صدورها. وبعض تلك الأدوات تعتمد عليها القصيدة كالترميز والاعتناء بالعمق النفسي للنص الشعري، ولكن نِسب الحضور والخفوت أو الغياب تختلف من نص إلى آخر ومن الشعر إلى الرواية.
-الحكاية هي جوهر السرد وفلسفته، وقد تحدثت عن تجربتك معها في عدد من مؤلفاتك. هل يمكن أن تحدثنا عن علاقتك بالحكاية، وبشكل خاص عن رواية“ حارس السفينة”؟
ما حدث معي في حارس السفينة أستطيع اعتباره حالة حكائية أو سردية فريدة، لم تتحدد المعالم السردية للنص ولا هيكله أو حتى شخصياته وفكرته، إلا حين الوصول في الكتابة إلى كل حدث أو فصل أو شخصية، أما قبل تلك اللحظة فكانت التجربة مرهونة لزمن الحكي/الكتابة، حتى إنني جعلت الاهداء تعبيرا عن جوهر السرد فيها “إلى الآخر الذي تقمصني ذات غياب وأملى عليّ هذه الحكاية، ولم يكن مني سوى الكتابة”. كانت عملية الحكي تسير بي حيثما تشاء في كل جلسة كتابة، وكنت منقادا لمشيئتها إلى أن اكتملت الرواية في اثنى عشر جلسة، وهي عدد مقاطع الرواية، امتلكت جوهر هذه الراوية قبل كتابتها بأربع أو خمس سنوات وظل يتقلب في وجداني حتى جاءت لحظة الكتابة وتدفق الحكي في ثلاثة أشهر فقط. ففي حارس السفينة لم أحاول خلق الأحداث أو تكوين الشخصيات أو بناء الأفكار من قبل، كما في روايتيّ منبوذ الجبل وحكايتان من النهر، ففي كل رواية كنت أعيش مع الحكاية قبل وأثناء وبعد الفراغ من الكتابة، أشاطرها أفكاري وتشاركني ليلي ونهاري، وترحل بي إلى عوالمها وأزمنتها، أصادق أبطالها، وشخصياتها الهامشية كذلك، وأغوص داخل نفوسهم، أما حارس السفينة فقد عشت مع السفينة فقط وبحثت عنها طيلة السنوات الخمس التي سبقت الكتابة، ثم جاءت القصة متتابعة كأنما كان هناك من يرويها لي فصلا فصلا في تلك الجلسات الكتابية، وكنت أتشوق لكل جلسة حتى تكتمل القصة في وجداني وعلى الورق معاً.
-أيهما يحضر بقوة في تجربة عبدالله ناجي: الكتابة الشعرية أم الكتابة الروائية؟
الكتابتان حاضرتان بقوة في تجربتي، ولا أبالغ إن قلت بأنهما غير منفصلتين من الأساس، فالشعر رواية الوجود، والرواية قصيدة الحياة، والإنسانية أنست بالأرض والمكان فحكت وروت، وتعلقت بالوجود فشعرت وتجلت. أكون شاعرا حينما يجتاحني الفيض العرفاني أو الوجودي، وأصبح روائيا عندما أركض في طرقات مدينتي، ولكن ذلك لا يقيم سدا منيعا بين التجربتين أو الكتابتين فلا وجود للأخرى إن وجدت الأولى ولا وجود للركض إن جاء الفيض، بل الجمع بينهما ليس مستحيلا، وهو كذلك غير مفهوم بشكل دقيق، وأفضّل ألا أفهمه. على أن أعيشه وأشعر به وأمارسه. وإذا شئت أن أبحث عن مفهوم يقف بي على الحالة تلك فسأصل إلى الفن.. الفن الذي حوّل هذا الكائن من مجرد مخلوق إلى إنسان. فبالفن -نقشا ورقصا وكتابة ونحتاج تأكد وجود الإنسانية.
-لكل شاعر تعريفه الخاص للشعر، فما هو الشعر في نظر عبدالله ناجي؟
قلت ذات مرة وأنا أحاول تعريف الشعر: الشعر مفردة ملغومة، ومحاولة تفكيكها أو تعريفها خطأٌ فادحٌ، فكل محاولة لتعريف الشعر هي محاولة غير مأمونة المعنى ولا مضمونة النتيجة. الشعر مبثوث في هذا العالم لكنه يفلت منا حال تعريفنا له، الشعر روح الكون، فماهي الروح؟ لا يمكننا تعريف الشعر من خارجه، إذ جل ما نفعله ونحن نقوم بهذه المحاولة هو الوقوف على الشكل والحالة، لن نعرّف الشعر إلا باقترافه ووحدها القصيدة قادرة على ذلك، ولكن القصيدة وهي تفعل ذلك لا تُعري لنا سوى نفسها بينما تخفي داخلها جوهر الشعر.. فالشاعر الأصيل حال التباسه بالكائن الشعري تتجلى له القصيدة فيظنها الشعر كله، وهي الشعر كله في لحظتها تلك، غير أنه وبعد زوال ذلك التجلي لا يجد بين يديه سوى قصيدته أما الشعر فيبقى ذلك المجهول العظيم، نعيشه ولا ندركه.
-من خلال تجربتك في الكتابة والإلقاء، ما الصفات التي اكتسبتها خلال مسيرتك الإبداعية؟ وهل ترى أن لهذه الصفات دورًا في إثراء المشهد الأدبي والثقافي من وجهة نظرك؟
الكتابة هي المرحلة الأولى في طريق التجربة الإبداعية ويليها الإلقاء بطبيعة الحال، ومن قبلهما تعلو القراءة كبساط معرفي يحملهما في سماء الإبداع، هذا هو السلم الأدبي الذي أتاح لي ككاتب اكتساب العديد من الصفات، تأتي الإجابة على سؤال: أين سأضع قدمي في المرحلة القادمة من تجربتي وأين أقف الآن إبداعيا؟ من أهم تلك المكتسبات، فمن دون الحضور تأليفا ونشرا أو قراءة وإلقاءً لن يقف الكاتب من تجربته موقفا صحيحا، وستظل نظرته غائمة ومسيرته غير واضحة المعالم، فكل كتاب أو لقاء معرفي أو تماس مع القرّاء هي بمثابة كشوف في رحلة الأدب، ورصد للمنجزات والمراحل ومحطات الطريق.. وكل ذلك يصب تلقائيا في إثراء المشهد الأدبي قراءة وتحليلا ونقدا ومداولات إبداعية، وتلاقحا للأفكار وتوليدا للتجارب الأدبية. وصفة أخرى أدين للتجربة الإبداعية في اكتسابها إلا وهي صقل المهارات الكتابية واكتساب رؤية عميقة للأشياء والوجود بشكل عام، وكذلك اكتساب أسلوب أدبي خاص بي، فالتراكم الإبداعي يصنع بصمة للكاتب يُعرف بها، وتتجلى أكثر عندما يكتمل مشروع الأدبي.
-متى ترى أن الكتابة تصبح مشروعًا مكتملًا؟ ومتى تعتبر مشروعًا مهزومًا أو غير مكتمل؟
الاكتمال بالنسبة للمشروع الكتابي لا يعترف بالكم وعدد الكتب والإصدارات أو اللقاءات، فقد يكتمل المشروع في كتابين أو ثلاثة، وذلك عائد إلى عمق التجربة ونضوج الرؤية واكتمال أدوات الكاتب لغويا ومعرفيا وإنسانيا وتقديمه لتجربة إبداعية حقيقية، لا مجرد تدوين لما يخطر في البال مع حرفة أدبية جميلة، ويبدأ المشروع بالوضوح عند امتلاك كاتبه لصوته الخاص، ويتعمق بتجذر الكتابة الإبداعية في تربة التجارب الإنسانية والذاتية وتصدير رؤية خاصة بالكاتب عن الحياة والموجودات والمعاني المجردة والحسية. وليس عليه أن يخوض في كل شيء حتى يكتمل مشروعه، أو يكتب في الأشياء العظيمة فقط، وإنما ينطلق من ذاته في النظر إلى الأشياء، حتى أصغر الأشياء، قد تتحول في يد المبدع إلى إبداع أخاذ إذا كُتبت بصدق وتجربة عميقة مع تميزٍ في أدواته الكتابية. عدا ذلك قد يهبط بمشروعه إلى الفشل ثم الاندثار، وتصبح الهزيمة هي الخيار المتاح والخروج بمشروع غير مكتمل، لا يدل على صاحبه ولا يشير إليه.
-لكل كاتب نصائح وممارسات تثري تجربته الإبداعية، فما أبرز النقاط التي ترى أنها تسهم في احترافية الكتابة، سواء في الشعر أو الرواية؟
بالنسبة لي كانت القراءة هي الممارسة الأجدى لإثراء تجربتي الإبداعية، والقراءة سبيل لاكتشافات عدة منها الموهبة الكامنة في الأعماق، إذ القراءة تحفزها على الظهور ثم تمنحها مكانة سامقة في عالم الأدب، وهي كذلك إحدى بوابات الخيال الأدبي الخصب، ورافد لامتلاك مهارات وتقنيات كتابية جديدة. يلي ذلك ويتبعه غالبا لقاء الأدباء والمبدعين من كل فن، فالنقاشات الأدبية والثقافية والاحتكاك بالتجارب المبدعة ستثري تجربته وترفع من احترافية كتاباته. وثمة ممارسة أو نصيحة أخرى أجدها مهمة في احترافية الكتابة، وهي أن يخلق الكاتب طقسا خاص به للكتابة، فمجرد الدخول في طقسه ذاك تتداعى إليه عوالم قصيدته أو روايته ويدخل بكامل تجليه في تجربته الإبداعية، ومع تكرار التجربة يتكون ارتباط نفسي بين الكتابة وطقسها، إلى حد أن الكلمات والمعاني والأفكار تشعر بحرية تامة في مناخها الكتابي فتتشكل في ذهن الكاتب باحترافية عالية.. فاحترافية الكتابة مثلها مثل غيرها من الفنون والمهن تتأصل وتتجدد بالممارسة الدائمة، والبحث الجاد عن فضاءات ثرية تأخذ بتجربته الإبداعية إلى الأجمل..
ما بعد الظلم والكبت هل يمكننا تحليل الرأسمالية نفسياً؟
ما بعد الظلم والكبت التحليل النفسي للرأسمالية
هل يمكننا تحليل الرأسمالية نفسياً؟
ربما لو طُرح هذا السؤال على فرويد في حدّ ذاته لعبّر عن شكوكه في إيجاد إجابة عنه؛ لأنّه تساءل في خاتمة كتابه؛ الذي عنونه الحضارة وسخطها، عمّا إذا كان بإمكان المرء إجراء تحليل نفسي للمجتمع بأسره، وخَلصَ إلى أنّه لا يستطيع القيام بذلك. والمشكلة، حسب رأيه، ليست معضلة عملية؛ لكن على الرغم من أنّه لا يمكن للمرء أن يعرض مجتمعاً بأكمله، أو نظاماً اقتصادياً بأسره، لسلسلة من جلسات التحليل النفسي، فإنّ كلّ نظام اجتماعي وكلّنظام اقتصادي يعبّر عن نفسه من خلال المفاصل التي تخون أصداءه النفسية. ويمكننا تحليل هذه المفاصل من منظور النظرية التحليلية النفسية؛ فالعائق، الذي يقف عقبة أمام إنجاز أيّ تحليل نفسي للمجتمع، بالنسبة إلى فرويد،هو عائق نظري؛ إذ لا يستطيع المحلّل النفسي إدانة مجتمع بأكمله على أنّه عصابي، على سبيل المثال؛ لأنّ هذا التشخيص يعتمد على مستوى الحياة الطبيعية السليمة للمجتمعات، التي يمكن من خلالها تمييز المجتمع العصابي،لكنّ المفارقة التي تكمن في هذا الاستنتاج، وما يثير السخرية فيه، هما كونها واردة في كتاب يقوم بالتحليل النفسي للنظام الاجتماعي على هذا النحو، ولا بدّ أنّ هذه النقطة قد فاتت فرويد. إنّه قادر على أداء هذا العمل لأنّه لا يوجد نظام اجتماعي متكامل ومتطابق تماماً؛ فبدلاً من الاكتفاء الذاتي، ومن ثَمَّ عدم التعرّض للتحليل النقدي، يفتح كل مجتمع مساحة خارج نفسه يمكن للمرء، من خلالها، تحليله وإصدار حكم عليه. وينطبق الشيء نفسه على الرأسمالية باعتبارها بنية اجتماعية واقتصادية؛ إذ يوجد فضاء يسمح بالقيام بالتحليل النفسي للرأسمالية في خضم عدم اكتمال النظام الرأسمالي.
وإذا قبلنا الحكم بأنّه لا يمكننا القيام بالتحليل النفسي للرأسمالية بوصفها نظاماً اجتماعياًاقتصادياً؛ فإنّنا سنوافق ضمنياً على الحجج التي يتبناها المدافعون عن الرأسمالية؛ حيث يدّعي المدافعون عن هذا النظام أنّ الرأسمالية هي وظيفة للطبيعة البشرية، وأنّ هناك تداخلاًمثالياً بين الرأسمالية والطبيعة البشرية. ومن ثَمَّلا يوجد مكان يمكن للمرء من خلاله أن ينتقدها.
ومن هذا المنظور؛ إنّ أي نقد تأسيسي سيكون بطبيعته خيالياً وطوباوياً، لكنّ اشتغال الرأسمالية يعتمد بالضرورة؛ أكثر بكثير من الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، على عدم اكتمالها وعلى انفتاحها على الخارج. ويمكن للمرء القيام بتحليل نفسي للرأسمالية؛على الرغم من وجود تلك الفجوات التي ينتجها هذا النظام في حدّ ذاته وما يعتمده لتجاوز تلك الفجوات، إلا أنّ ممارسة التحليل النفسي لم تكن دائماً مساوية لهذه المهمّة.
يربط العديد من منتقدي الرأسمالية التحليل النفسي بالرأسمالية؛ إنّه يعمل، وفقاً لهذا النقد،كأحد الخَدَمِ الأيديولوجية للرأسمالية، وله تأثير يدعم المنشقّين المحتملين، ويحوّل الذواتالمتمرّدة إلى ذوات أكثر سكوناً. وهذا الفهم المتحامل للتحليل النفسي ليس غير مبرّر تماماً؛فأثناء ممارسته (خاصة في مناطق العالم الأكثر التزاماً بالرأسمالية مثل الولايات المتّحدةالأمريكية) أدى التحليل النفسي بالتأكيد دوراًفي تعزيز طاعة مرضاه وتدجينهم بدلاً من إلغاء شغفهم الثوري؛ لكنّ الحكم على ممارسة التحليل النفسي هو أمر متقلّب بالتأكيد.
لقد أدت نظرية التحليل النفسي دوراً رئيساً في نقد النظام الرأسمالي؛ على الرغم من أنّها لم تؤدِّ أبداً الدور الحاسم فيه.
ومعظم محاولات فهم كيفية اشتغال الرأسمالية ركّزت اهتمامها على بنيتها الاقتصادية أو على الآثار الاجتماعية التي تنتجها؛ لكن على الرغم من أهمّية هذه المقاربات، تغفل بالضرورة التركيز على المصدر الأساسي لقوّة بقاء الرأسمالية. وتنبع مرونة الرأسمالية، بوصفها شكلاً اقتصادياً أو اجتماعياً، من علاقتها بالجانب النفساني وكيفية ارتباط الأشخاص برضاهم النفسي. وهذا هو السبب الذي يجعل التحليل النفسي ضرورياً لفهم جاذبية الرأسمالية وإغراءاتها.
إنّ التحليل النفسي يبحث في مسألة رضا الأشخاص، ويحاول أن يفهم السبب الذي يجعل هذا الرضا يتّخذ الأشكال التي يتمظهر عليها،وهو بذلك لا يحوّل عدم الرضا إلى رضا، لكنّه يحلّل السبب الذي يجعل بعض الهياكل توفّر الرضا على الرغم من المظاهر السطحية. وبهذا المعنى؛ إنّه يمثّل طريقة جديدة لمقاربة الرأسمالية وفهم قوّتها الدائمة.
وأن نقوم بتحليل نظام ما نفسياً يستدعي بالطبيعة انتقاده؛ لكنّ الجهود السابقة في ترتيب تحليل نفسي معدٍّ لنقد الرأسمالية كانت باستمرار تضع التحليل النفسي في مكانة ثانوية، وكان النقد هو من يحتلّ مكانة أساسية، وعمل النقّاد على توظيف التحليل النفسي لخدمة النقد.
إنّ ما سأقوم به في ثنايا الفصول القادمة من هذا الكتاب هو العكس تماماً؛ حيث سيبقى التحليل النفسي للرأسمالية المحرّك الرئيس للتحليل، وإذا طفا على السطح أيّ نقد للرأسمالية، انطلاقاً من هذا التحليل النفسي؛فلن يكون أبداً القوّة الدافعة لهذا التحليل. وبطبيعة الحال، لا أحد بوسعه أن يكون محلّلاً محايداً للرأسمالية؛ لكنّني أزعم أنّ انغماس المرء داخل هيكلها وضمن إغوائها النفسي لا بد أن يكون بمنزلة التمهيد لأي نقد أو دفاع فعّال عن هذا النظام.
قيمة العقل لا تُقاس بما يتفق عليه
نوره بابعير
لم أعد أنظر إلى الاختلاف الفكري كنوعٍ من الخلاف، بل أصبح وسيلة لإيقاظ الوعي، إذ يساهم في اتساع الرؤية البصرية والبصيرة الداخلية. فالمعنى يتشظّى في كل مرة، ويتغير تبعًا لفهم الأشخاص له. وهذا ما يمنح الفكرَ قيمةً؛ إذ يتحرك العقل بين صحوة الوعي وجهل الآخر. وعندما تحدث مثل هذه الأمور، فإنها تُشكّل ترابطًا عميقًا بين الطرفين، لكلٍ منهما وجهة نظر مختلفة تضع أمام العقل خيار المفاضلة بينهما، حتى تتضح الصورة الكاملة للفهم.
لكن هذا لا يعني أن الآراء الأخرى خاطئة، فربما بُنيت على أسس صحيحة، لكن من زاوية فهم مختلفة.
أما التنبؤات الناتجة عن الاختلاف، سواء في الألفاظ أو الأفعال، فإنها تعود إلى طريقة تفاعل العقل معها؛ كيف كوّنها، ودوّنها، وأخرجها بالصورة الملائمة لقدراته. ومن هنا تتفرّع الآراء، ويبرز في كل رأي مدى النضج العقلي لصاحبه، فيتجلّى فيه إنصاف بين وعيٍ منير ونضجٍ متكامل، يقود الإنسان وفقًا لانعكاسات داخلية متشابكة.
فليست المشكلة في وقوع الاختلاف، ولا في الخلاف ذاته، بل في فراغ العقل حين ينظر إلى هذه الأمور ويضعها في غير موضعها الحقيقي، فيتمسك بها دون وعي، بدلاً من أن يترك مساحة كافية لاكتشاف الحقائق المخفية
وهنا يصبح الوعي مرآةً صافية، لا تعكس فقط ما يُرى، بل ما يُفترض أن يُفهم، فليس كل ما نسمعه يحتاج إلى تصديق، ولا كل ما نختلف عليه ينبغي أن نُحسمه بالصواب والخطأ. لأن جوهر الفكر لا يقوم على الانتصار لرأي، بل على فهم أعمق لطبقات المعنى، وإدراك أوسع لما بين السطور.
الاختلاف الحقيقي ليس صراعًا بين العقول، بل تلاقٍ بينها، حيث ينمو الفكر في منطقة التباين، لا في مناطق التماثل. فحين تتجاور الأفكار المتناقضة، تتكوَّن لدينا خرائط جديدة للفهم، ومساحات أرحب للتأمل، تجعلنا أكثر مرونةً في تقبّل وجهات النظر، وأكثر نضجًا في مراجعة قناعاتنا.
إن العقل الممتلئ لا يخشى الاختلاف، بل يحتضنه، لأنه يعلم أن كل فكرة تحمل احتمالًا للحقيقة، حتى وإن بدت لنا غريبة أو بعيدة. فالحقيقة ليست حكرًا على طرف دون آخر، بل هي حصيلة الحوار، والتقاطع، والتراكم المعرفي المستمر.
ولعلّ أحد أخطر ما قد يُفسد هذا المسار، هو التسرع في إصدار الأحكام، والرغبة الدائمة في تصنيف الآخرين تحت لافتات مسبقة. فالاختلاف لا يُدار بالعاطفة المجردة، ولا بالانحيازات الشخصية، بل بعقلٍ يُنصت قبل أن يُجادل، ويُحلل قبل أن يرفض، ويُقدّر أن لكل فكرة زمنها، وسياقها، وبيئتها.
من هنا، علينا أن نمنح عقولنا فرصة للنمو داخل مساحات الاختلاف، لا خارجه، فكل فكرة نستوعبها خارج قناعاتنا المعتادة، هي توسعة لمجال الرؤية، وتعميق لبصيرة لم تكن لتتفتح لولا احتكاكها بما يخالفها.
تبقى الفكرة الأكثر رسوخًا: أن قيمة العقل لا تُقاس بما يتفق عليه، بل بما يستطيع فهمه، ومراجعته، وتطويره، حتى وهو في قلب الاختلاف.
الكتابة كأفق ثقافي لتخييل الذات”
نوره بابعير
الكتابة ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل هي في جوهرها فعل وجودي، يعيد فيه الإنسان تشكيل ذاته، وتصفية وعيه، وتوليد إمكانيات جديدة لرؤية العالم ونفسه. إننا لا نكتب فقط لنُعبّر، بل لنفهم، لنهدأ، لنُنقي دواخلنا من ضوضاء العالم، ولنصنع داخل اللغة فسحة أوسع للحرية والتأمل.
التخييل الذاتي: حين يصبح الإنسان نصًا يُكتب
في فعل الكتابة، يبدأ التخييل الذاتي: أن يرى الإنسان نفسه ككائن قابل للتشكل، وكذات يمكن إعادة رسمها وتحريرها عبر الكلمات.
الكاتب، هنا، لا يدوّن الواقع كما هو، بل يُعيد ترتيبه، يفلتره، يتأمله، يضخ فيه ما يراه جديرًا بالبقاء، ويُبعد ما لا يحتمل الضجيج. إنها ليست كتابة سير ذاتية، بل إعادة خلق للذات من الداخل، وتصالح مع الهشاشة والأسئلة والانكسارات.
الكتابة بهذا المعنى لا تُجمّل السلوك، لكنها تُضيئه. تُجبرنا على مواجهة أنفسنا، على كشف “الضوضاء الزائدة” التي تشوش وعينا وتُغرقنا في الاستجابة التلقائية، بدلًا من الفعل النابع من وعي.
الضوضاء ليست فقط خارجية (كفوضى العالم وضجيج التواصل)، بل داخلية أيضًا: أفكار غير مكتملة، مشاعر مضغوطة، تصورات موروثة.
الكتابة تنقّي. لا لأنها تقول الحقيقة، بل لأنها تتيح للذات أن تُعيد تنظيم فوضاها، وتُراجع مساراتها، وتستعيد صوتها الداخلي وسط ضجيج الأصوات الخارجية.
المخيلة: بين اللغة والوعي
كلما اتسعت المخيلة، زادت قدرة الكاتب – أو القارئ – على فهم ما هو أبعد من الواقع المباشر. المخيلة لا تعني الهروب من الواقع، بل تعني القدرة على تخيّله بصورة مختلفة، وعلى إعادة صياغته وفق منظور شخصي أو جمالي.
هذه القدرة الخيالية تُنبت لغة جديدة، أوسع، أغنى، وأعمق. فاللغة لا تتطور من تلقاء نفسها، بل عبر استخدام مبدع وخيال حيّ.
لذلك، من يُطوّر مخيلته، يُطوّر لغته تلقائيًا. يتسع معجمه، تتشكل لديه حساسية لغوية أعلى، ويصبح قادرًا على التعبير بدقة وجمال.
ومن هنا يمكن القول إن المخيلة لا تبني جسورًا بين الإنسان واللغة فقط، بل تبني داخله جسرًا بين ذاته الواعية وذاته العميقة، بين أفكاره وظلال أفكاره، بين ما يعرفه عن نفسه، وما لم يكتشفه بعد.
الكتابة كأداة ارتقاء داخلي
الكتابة ، حين تقترن بمخيلة حرة وتأمل صادق – تصبح أداة للارتقاء. ليست رفاهية ولا ترفًا ثقافيًا، بل حاجة وجودية.
هي ما يُمكّن الإنسان من أن يُبطئ اندفاعه، أن يُمسك اللحظة ويفككها، أن يرى السلوك وهو يتشكل، فيحرر نفسه من التكرار واللاوعي.
ولعل أعظم ما تمنحه لنا الكتابة، هو هذا الشعور الدقيق بالتماسك الداخلي. لا بالانتصار على الفوضى، بل بالقدرة على التعبير عنها، وفهم أسبابها، وتحويلها إلى شيء يمكن النظر إليه لا الغرق فيه.
اصبحت لكتابة فعل مقاومة، والمخيلة ملاذًا، واللغة وسيلة خلاص. وكلما كتب الإنسان أكثر، خيّل ذاته أكثر، كلما صار أكثر قربًا من جوهره، وأبعد عن الضوضاء التي تحجبه عن ذاته الحقيقية
لغز البيت الأحمر.. جريمة قتل، إطلاق نار، جثة، ومشتبه مفقود.. فهل تعتقد أنك ستكتشف القاتل قبلهم..
لغز البيت الأحمر رواية خفيفة، ساحرة، وذكية، سيتمكن القارئ إلى حد كبيرمن فك غموضها مبكرًا، من الواضح من إيقاع الرواية أن ميلن استمتع كثيرًاأثناء كتابتها. الإهداء في بدايتها موجّه إلى والده، الذي كان من محبي رواياتالغموض.
البيت الأحمر الذي تدور فيه أحداث الغموض يخص مارك أبلت، رجل مستقلماديًا، كان في السابق يكتب للصحف، ولكنه ومنذ أن ورث ثروة مناسبة منراعية عانس، بات يكتب ما يشاء دون أجر. يستضيف أصدقاءه باستمرار فيمنزله، ويُبقي سيطرته على سير الأمور من خلال تنظيم الأنشطة وتوجيهضيوفه إلى كيفية قضاء وقتهم.
يعيش معه ابن عمه ماثيو كايلي، ويعمل كسكرتير له. في طفولته، تكفّل ماركبتعليمه، ثم وظّفه لاحقًا للاهتمام بشؤونه المالية والإدارية.
أثناء وقوع الجريمة، كان مارك يستضيف ضيوفًا متنوعين: ضابطًا متقاعدًا، ممثلة، أرملة وابنتها، وشابًا من الطبقة الراقية يُدعى بيل بيفرلي، الذي كتبإلى صديق له كان يمر صدفة بالمنطقة، ودعاه لزيارته في البيت الأحمر — تمامًا عند بدء الغموض.
توني غيلينغهام هو رجل لا يلتزم بمهنة واحدة لفترة طويلة، لكنه دائمًا يخرجسالمًا. عند وصوله إلى البيت الأحمر، كان يفكر في ماهية وظيفته القادمة. يلتقي بكايلي وهو يطرق بجنون على أحد الأبواب داخل المنزل، فيتدخل تونيعلى الفور.
قبل هذا المشهد بقليل، عاد الأخ الأكبر لمارك، روبرت أبلت، من أستراليا للقاءشقيقه. يعرف عنه من لم يسبق لهم رؤيته أنه شخصية غير موثوقة، دائمًا فيمشاكل مالية، وقد أُرسل إلى أستراليا لأسباب غامضة.
عندما يتمكن كايلي وغيلينغهام من دخول الغرفة، يعثران على جثة رجل، مصاببرصاصة في جبهته، ويؤكد كايلي أن القتيل هو روبرت أبلت. لا أثر لمارك. عندها، يقرر غيلينغهام أن يتقمص دور المحقق الهاوي، ويصبح بيفرلي هو“واتسون” لمحققنا “هولمز”.
وبين التقلبات والمنعطفات غير المتوقعة، تتكشف حقيقة ما حدث داخل المنزل. كلالعناصر موجودة: رجل مجهول يدّعي أنه الأخ العائد، شجار مسموع، طلقة، اختفاء مارك، وتواجد كايلي في لحظات محورية. ومع ذلك، هناك شعور بأنميلن كان يؤلف القصة بحرية أثناء سيرها، ويعكس هذا مرونة أسلوبه وجاذبيةشخصيتي غيلينغهام وبيفرلي.
بيفرلي بالتحديد يبدو مزيجًا بين بيرتي ووستر وجون واتسون. حماسيّ ومندفعلخوض غمار الغموض، لكنه بين الحين والآخر يتذكر أن الشخص المتورط قديكون صديقًا. أما غيلينغهام، الأكبر سنًا والأكثر خبرة، فهو الشخصيةالمهيمنة، ويظهر بيفرلي حرصه على نيل إعجابه.
عندما يُكشف الستار عن الحقيقة، تبدو الحبكة متكلفة إلى حد ما، كما أنالشرطة أغفلت مسارات تحقيق واضحة، مفضّلة القفز مباشرة إلى استنتاجسريع. لكن لغز البيت الأحمر تندرج ضمن أسلوب “العصر الذهبي للجريمة”، لذا يُتوقع منها شيء من اللامعقول.
النهاية توحي بأن ميلن ربما كان ينوي كتابة مغامرات أخرى لغيلينغهاموبيفرلي كمحققين هاويين. لكن بدلًا من ذلك، كتب رواية مستوحاة من زواجه(Two People، 1931)، ثم رواية جريمة كوميدية (Four Days’ Wonder، 1933)، ثم كوميديا اجتماعية (Chloe Marr، 1946).