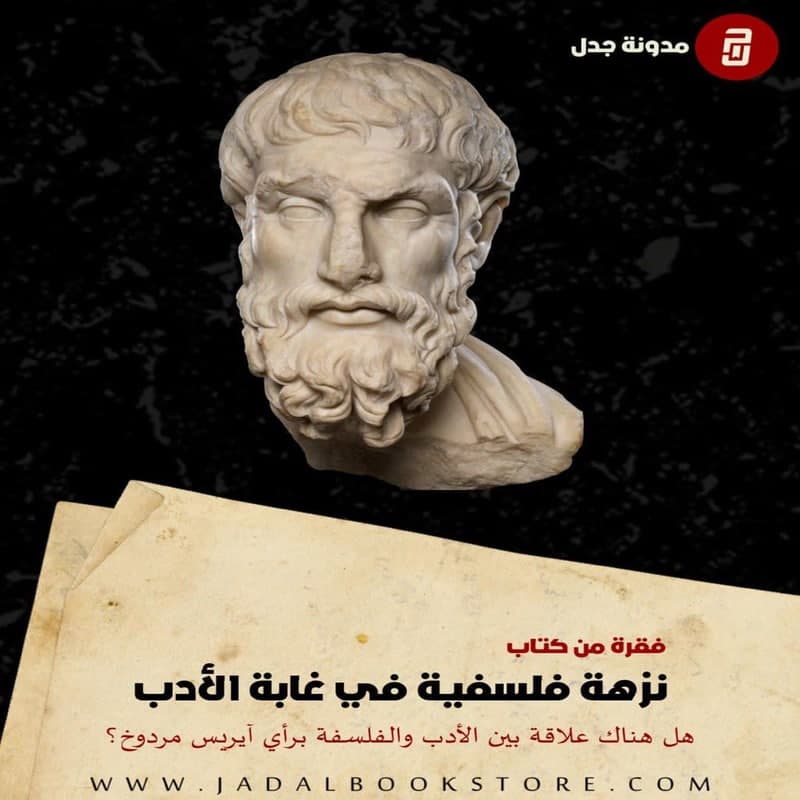القراءة مثل جمع الطوابع!
في حوار مع إحدى المجلات العربية، سُئلت عن رأيي في القراءة، هل هي هواية أم عادة ؟
هل يمكن أن تكون مثل كرة القدم، وجمع الطوابع، والمراسلة، تلك الهوايات الشائعة التي يمارسها الناس منذ الصغر، وتستمر مع بعضهم، بينما يقلع عنها البعض الآخر، في زحمة الحياة، أم تظل عادة يتعودها الشخص ولا يستطيع الإقلاع عنها مهما تقدم في العمر؟
رأيي أن القراءة ليست بالضرورة عادة أو هواية، وإنما تربية خالصة نتربى عليها منذ الصغر، وتصبح جزءاً أساسياً من التكوين الروحي لنا، أي لیست کالهواية التي يمكن الإقلاع عنها تحت أي ظرف، ولا العادة التي ربما نضطر لتركها يوماً، هي أعمق من ذلك كثيراً.
أذكر أننا كنا نعيش في مدينة بورتسودان الساحلية، وكان جزءاً من التربية لدى والدي أن نقرأ في كل أسبوع كتاباً، أي حوالي الخمسين كتاباً في العام، قانون صارم نشأنا عليه، وشارك في فرضه صاحب مكتبة اسمه رفعت، كان من أهالي مدينة سواكن القريبة من بورتسودان، وكان يملك مكتبة متوسطة في سوق المدينة، لكنه يربطها بكل ما يصدر داخل البلاد وخارجها، وكان أطرف ما فيه أنه يقوم بإيصال الكتب إلى المنازل، راكباً على دراجة نارية من ماركة فيسبا التي انقرضت الآن.
تلك الخدمة التي لم تكن معروفة وأصبحت الآن واحدة من أهم الخدمات، ليست في مجال الكتب بالطبع ولكن في مجال الطعام.
كنا نعرف الموعد الذي يأتي فيه رفعت، لا يطرق الباب، ويلقي بالكتاب المغلف في ظرف سميك من أعلى الحائط ويمضي، ونتقاتل جميعاً على ذلك الكنز، من يقرأه أولاً .. وعن طريق هذه الخدمة الفريدة، قرأنا في سن مبكرة مئات الكتب التي ربما لم يقرأها الآخرون إلا في سن متأخر.. تعرفنا على الأدب العربي والروسي والأوربي، وقرأنا في التاريخ والتراث العربي والإسلامي.
وحين كبرنا قليلاً، واقلع رفعت عن الحضور، ثم أغلق مكتبته وابتدأ في ممارسة نشاط تجاري آخر، لم نقلع عن القراءة أبداً، كنا نبحث عن بدائل، وعثرنا بالفعل على مكتبات أخرى وكتب أخرى وهكذا إلى الآن، بالنسبة لي ولإخوتي الذين عاصروا مكتبة رفعت المتنقلة، يعتبر تسوق القراءة، أهم تسوق لنا، نمارسه بانتظام، ونبحث في كل بلد نسافر إليه عن المكتبات أولاً قبل مولات التسوق وحوانيت الأزياء.
لا أتفق مع الذين يقولون بأن التكنولوجيا الحديثة بكل ما قدمته من ترف، وتسلية ومتعة، هي التي سرقت جيل أبنائنا من القراءة، بأن أوجدت له بدائل أشد جذباً، ذلك أن الشعوب الغربية التي اخترعت التكنولوجيا، والمفترض أن تنشغل بها، ما زالت تقرأ بشره كل ما يصدر، وأشاهد دائماً في موقع كبير مثل أمازون، كتباً لم تصدر بعد، وأعلن عن صدورها بعد عدة شهور، يتقاتل الناس على حجز نسخهم منها، حتى إذا ما صدر الكتاب بالفعل، تلقفه القارئ المشتاق وغرق فيه.
الذي حدث، أننا لم نخترع لأبنائنا صاحب مكتبة مثل رفعت، يأتي بالكتب حتى البيوت، ويتركهم يتقاتلون على قراءتها .
اسم المقال: عن القراءة
المؤلف: أمير تاج السر
المصدر: كتاب ضغط الكتابة وسكرها.