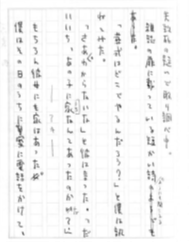غسان كنفاني وأدب المقاومة الفلسطينية
غسان كنفاني أديب فلسطيني تلتحم حياته بالمقاومة الفلسطينية التحاماً، وفي الحقيقة حياته بأكملها مقاومة لا يمكن فصلها منها في أي صورة، كما يقول الدكتور فؤاد: “غسان من هؤلاء الحالمين الذين يعملون على تقصير المسافة بين الفعل والكلمة، و يتطلعون إلى جنس جديد من البشر”. فإنه مقاوم من حيث الفعل، ومن حيث الكلمة، وقد وصفه كامل سلمان الجبوري بالفدائي كما يقول “غسان كنفاني أديب فلسطيني من كبار الفدائيين.” فهو أديب ولد في عنفوان ثورة عام 1936، واستشهد في ريعان شبابه عام 1972، وكابد شقاوة الحياة و مرارتها من التهجير والغربة، وعاش حياته لاجئاً تائها في البلدان العربية المجاورة، مختفياً في بعض الأحيان من السلطة. وهو كاتب ناضل بريشة قلمه وأفكاره طول حياته القصيرة التي لا تتجاوز أكثر من ست وثلاثين سنة، ولكنها غزيرة بالإنتاجات المفعمة بالحيوية وروح النضال والمقاومة، وهو كما – يقول محمود درويش-“ أحد النادرين الذين أعطوا الحبر زخم الدم. ونقل الحبر إلى مرتبة الشرف وأعطاه قيمة الدم” و ليس هذا فحسب، بل حياته مليئة بالنشاط السياسي والاجتماعي أيضاً.
- أسرة غسان كنفاني:
كانت أسرة غسان أسرة مسلمة سنية من أسر الطبقة المتوسطة بمدينة عكا مدينة بساتين البرتقال والزيتون القائمة على ضفة البحر المتوسط. أبوه محمد فائز عبد الرزاق كنفاني كان محامياً قد حصل على شهادة الحقوق خلاف رضى أبويه، ويشتغل محامياً بمدينة “يافا”، وكان يعمل في النشاطات القومية الفلسطينية ضد الاحتلال البريطاني، والاستيطان الصهيوني، ولذلك أودع السجن مراراً قبل النكبة. أما أم غسان كنفاني، فرغم كونها غير متعلمة –كما وصفها غسان- كانت عاقلة وذات حكمة عظيمة.
- ولادته و دراسته:
ولد غسان بـ”عكا” في 9 أبريل/نيسان عام 1936، في وقت كانت فلسطين تحترق في نار الثورة الكبرى، وكانت سلطة الاحتلال قد شمرت عن ساقها لاجتثاث إرادة الشعب للتحرير من أصولها. وبما أن أباه فائز محمد كنفاني كان يشتغل محاميا في مدينة “يافا” ويسكن في حي المنشئة هناك، فعاد به إلى يافا عندما انتهت فترة الإجازة. وفي يافا قطع غسان المرحلة الابتدائية من مراحل حياته ودراسته فعندما بلغ الثانية من عمره ألحقه أبوه بروضة الأستاذ وديع سري حيث تلقى دروسه الأولى في اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وبعد ذلك التحق بمدرسة الفرير التي كانت تديرها منظمة فرنسية تنصيرية بمدينة يافا.
- التهجير والغربة:
ولم يمض على دخول غسان في مدرسة الفرير بيافا بضع سنوات حتى اضطر أبوه أن يهاجر مع أسرته إلى مسقط رأسه “عكا” عندما تعرضت مدينة يافا للهجوم اليهودي الأول على المسلمين لقربها من تل أبيب إثر قرار تقسيم فلسطين عام 1947. في عكا لم يوفق له و لأسرته إلا أن يقضوا عدة شهور فقط، فعكا أيضا أصبحت فريسة للهجوم الوحشي اليهودي والتطهير العرقي في أواخر نيسان عام 1948. و مدينة “عكا” التي قد كان عدد سكانها 1800 نسمة عند صدور قرار تقسيم أصبحت تحتوي على أكثر من 40000 نسمة بعد أن أصبحت مأوى للمهاجرين من يافا، وحيفا، والقرى المجاورة التي قد سقطت قبلها. في 25 أبريل 1948 رجم اليهود مدينة “عكا” بالصواريخ ومدافع مورتورز مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من السكان. و قد عرض عدنان كنفاني أخو غسان صورة لهذا الوقت المأزق، فهو يقول “كانت إحدى ليالي أواخر نيسان 1948 حين حدث الهجوم الأول على مدينة عكا. بقي المهاجرون خارج عكا على تل الفخار (تل نابليون)، وخرج المناضلون يدافعون عن مدينتهم، ووقف رجال الأسرة في بيت جدنا الواقع في أطراف البلد، وكل يحمل ما تيسر له من سلاح وذلك للدفاع عن النساء والأطفال إذا اقتضى ذلك الأمر. ومما يذكر هنا أن بعض ضباط جيش الإنقاذ كانوا يقفون معنا. وكنا نقدم لهم القهوة تباعاً علماً بأن فرقتهم بقيادة (أديب الشيشكلي) كانت ترابط في أطراف بلدتنا. وكانت تتردد على الأفواه قصص مجازر دير ياسين، ويافا، وحيفا، التي لجأ أهلها إلى عكا وكانت الصور ما تزال ماثلة في الأذهان. وفي هذا الجو كان غسان يجلس هادئا كعادته ليستمع و يراقب ما يجري. ” وجملة عدنان الأخيرة تدل على أن غسان كان دقيق الملاحظة، ولهذه الملاحظة الدقيقة أثر كبير في التقائه الأبطال الأحياء من المجتمع لقصصه ورواياته.
وإثر الهجوم الأول، والخوف الذي أصاب اللاجئين مما شاهدوا من القتل والدمار الوحشيين والمجازر المروعة في مدنهم وقراهم، وبسبب قلة الغذاء والماء فقد كان اليهود قد لوثوا مياه “الكابري” -القناة التي كانت تزود عكا- بجراثيم التيفوئيد لتضيق الخناق على سكان عكا واللاجئين إليها، بدأت الأسر تنزح من عكا إلى البلدان العربية المجاورة في الزوارق عن طريق البحر، وفي الشاحنات في هرج ومرج، قبل أن يبدأ الحصار اليهودي لعكا في 28 شباط 1948. وعند سقوط عكا قتل اليهود أكثر من مئة مدني كان بينهم عدد غير قليل من الشيوخ والأطفال. وكانت أسرة غسان من الأُسَر التي تمكنت من الهجرة في شاحنة إلى لبنان، ونزلت بـ”صيدا”. وهناك استأجر أبوه مكانا لقيام أسرته في بلدة “الغازية” فمكثوا فيه، ولكن المقام لم يطِب لأبيه لأنه كان قد بذل كل ما كسب في بناء بيته في عكا وفي بناء منزل له في حي العجمي بيافا، ولم يبق لديه إلا بعض النقود التي لم تكن كافية لسد رمق الأسرة، وبالإضافة إلى ذلك لم يجد هناك مجالا للعمل الذي يساعد على قضاء الحياة في هذه المدينة الصغيرة، فلم يمض أربعون يوما على مكوثه هناك، حتى شد الرحال مع أسرته و طاف حلب ثم الزبداني، وفي النهاية استأثر القيام في “دمشق” حيث وجد المجال الأرحب للعمل كمحامي.
- استكمال الدراسة وبداية الحياة السياسية:
فتح أبو غسان مكتباً لممارسة المحاماة، و حقق نجاحاً في مهنته، فتحسن حال الأسرة الغريبة التي عاشت حياة قاسية حتى الآن، وسنحت الفرصة لأبنائه أن يكملوا دراساتهم، فانتهز غسان الفرصة وبدأ دراسته الثانوية التي خلالها برز تفوقه في الرسم والأدب العربي، وبدأت مواهبه تتفتح فقد جعل يقرض الشعر، ويكتب بعض من المقطوعات الوجدانية والمسرحية وهو لم ينته من الثانوية بعد، وكذلك جعل يقوم بتصحيح البروفات لبعض الصحف لكسب بعض المال الذي يكون عونا لأبيه. وعندما أكمل غسان دراسته الثانية في عام 1952 حصل على شهادة التدريس أيضا، بالإضافة إلى شهادة الثانوية. فبدأ حياته المهنية وجعل يعمل مدرسا للتربية الفنية في مدرسة “الإليانس” إحدى مدارس وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (اونرو) United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) في دمشق. وبالإضافة إلى اشتغاله بالتدريس، إنه التحق بقسم اللغة العربية في “جامعة دمشق” لممارسة دراسته العليا في الأدب العربي، وأعد أطروحته بعنوان “العرق والدين في الأدب الصهيوني”، وهناك لقي جورج حبش في عام 1953 الذي حرضه على الانضمام إلى “حركة القوميين العرب” (Arab Nationalists Movement). وجورج حبش الذي تخرج في الجامعة الأمريكية بـ”بيروت” كان مسيحياً متعصباً وكان له يد في الصدام العنيف بين الجماعتين من المسلمين، فقد لعب دوراً بارزاً في تحريض اللاجئيين الفلسطينيين ضد الحكومة الأردنية الذي أدى إلى صدام عنيف بين الجانبين في عام 1970. إنه كان قائد “حركة القوميين العرب” التي أسسها المسيحيون العرب من سوريا ولبنان، والتي اتخذت مقراً لها في الجامعة الأمريكية بـ”بيروت” وكان من أهداف هذه الحركة توحيد العرب على أسس اللادينة، لأن قائدها كان يرى الدين سببا هاما في هزيمة العرب. عملت هذه الحركة أولأ لأغراض الولايات المتحدة، ثم أصبحت تنادي بالماركسية والشيوعية.
انخرط غسان في “حركة القوميين العرب” على تحريض جورج حبش –كما سقنا آنفاً- وأصبح عضواً نشيطا لها، و نشاطاته هذه أدت إلى إحراج مع والده الذي كان يتمنى أن يكمل غسان دراساته، وفي النهاية إلى فصله عن الجامعة في عام 1955م، وهو لم يكن يمضي في رحاب الجامعة إلا سنتين.
- في الكويت:
بعد أن فصل عن الجامعة بسبب نشاطاته السياسية، قصد غسان “الكويت” في نفس السنة ليعمل هناك مدرساً للرسم والرياضة ولحق شقيقته فائزة و أخاه غازي الذين قد سبقاه إلى الكويت بسنوات للتدريس في المعارف الكويتية. وهناك تبدأ مرحلة جديدة من مراحل حياته، لها دور مهم في تكوين شخصيته من حيث تطور الأفكار عنده، ومن حيث الدراسة ومن حيث نقطة الانطلاق للإنتاج الأدبي.
أما من حيث تطور الأفكار، فعندما يصل “الكويت” يجد نفسه تتخذ القيام في غرفة يسكنها ست زملاء كلهم يحملون اتجاهات شيوعية، وهم أعضاء في إحدى الوحدات الشيوعية هناك، فيتأثر بهم، و كذلك يتأثر كثيراً بزوج أخته الذي كان ينتمي إلى منظمة شيوعية، ويعد من أهم أعضائها، وتحت هذا الأثر إنه مال إلى الشيوعية و بدأ دراسة الماركسية بشره. و قد تكلم غسان -في حوار أجراه الكاتب السويسري- عن علاقته بالاشتراكية واعتناقه للمبادئ الشيوعية، و تطور حركة القوميين العرب في حركة ماركسية: “يمكنني القول بأن حركة القوميين العرب كانت تشمل بعض العناصر الشابة، وكنت من ضمنها، التي كانت تسخر من حساسية الكبار في السن تجاه الشيوعية، وبالطبع لم نكن يومها شيوعيين، ولم نكن نحبذ الشيوعية. غير أن حساسيتنا ضد الشيوعية كانت أقل نسبة من حساسية المتقدمين في السن، و بالتالي، لعب الجيل الجديد دورا بارزا في تطوير حركة القوميين العرب إلى حركة ماركسية-لينية. و كان العامل الأساسي في ذلك كون غالبية أعضاء حركة القوميين العرب من الطبقة الفقيرة، أما الأعضاء المنتمون إلى البورجوازية الصغيرة، أو البورجوازية الكبيرة، فقد كان عددهم محدودا… و قد اطلعت على الماركسية في مرحلة مبكرة من خلال قراءاتي و إعجابي بالكتاب السوفيات.”
أما من حيث الدراسة، فكان قيامه في الكويت فرصة سانحة للدراسة الواسعة والعميقة، فأقبل على دراسة الأدب العربي، والماركسية إقبالا، و نجده يدرس بنهم لا يصدق، و يذكر أخوه عدنان كنفاني قوله عن إقباله على الدراسة فيقول “إنه لا يذكر يوما نام فيه دون أن ينهي قراءة كتاب كامل أو ما لا يقل عن ست مئة صفحة، و كان يقرأ و يستوعب بطريقة مدهشة.” أما نقطة الانطلاق للانتاج الأدبي، فنجد غسان في عام 1956 قد انخرط في إدارة صحيفة “الرأي” الكويتية الناطقة بلسان “حركة القوميين العرب،” وبدأ يكتب تعليقا سياسيا بتوقيع “أبو العز” الذي استلفت به اتجاه الناس. و في الكويت برزت مواهبه الفياضة في كتابة القصة القصيرة فكتب هناك عددا من باكورات قصصه القصيرة التي نشرها في هذه الصحيفة من أهمها “ورقة من الرملة”، و”ورقة من غزة”، و “ورقة من الطيرة”، و “إلى أن نعود”، و “درب إلى خائن”، و”أرض البرتقال الحزين”، و “القميص المسروق.” وقد نال على قصة “القميص المسروق” في عام 1957 الجائزة الأولى في مسابقة أدبية، و التي شكلت فيما بعد عنوانا لإحدى مجموعات قصصه القصيرة.
- في بيروت:
على دعوة جورج حبش للعمل كمحرر أدبي في مجلة “الحرية” التي اشترتها “حركة القوميين العرب” بـ”بيروت” لتكون مجلة رسمية لها، غسان يغادر الكويت عام 1960 إلى لبنان، و يختار القيام في بيروت. وهناك وجد الفرصة للوقوف على التيارات الأدبية والسياسية عن كَثَب حتى في وقت قليل أصبح بسبب نشاطاته التحررية و حماسته لقضية فلسطين و ثقافته الواسعة، مرجعا للمهتمين بالقضية الفلسطينية. وفي السنة التالية دخل في النصف الأفضل من حياته فتزوج بامرأة دنماركية آني هوفر (Anni Hoover) التي كانت حضرت بيروت للاطلاع على القضية الفلسطينية على كثب، و تعرف عليها غسان عن طريق بعض أصدقائه الذين ذهبوا بها إليه كمرجع للقضية الفلسطينية.
كانت آني هوفر امرة دنماركية و تعرفت إلى القضية الفلسطينية والظلم الواقع على الفلسطينيين عن طريق بعض الطلاب الفلسطينيين في دنمارك، ، فتحمست لهذه القضية، و شدت رحالها إلى البلاد العربية للاطلاع على القضية، وعندما زارت بيروت مروراً بدمشق التقت بغسان لأنه كان يعتبر مرجعا للقضية الفلسطينية، فقام غسان بشرح الموضوع لها، وزار معها المخيمات، و أراها الحياة القاسية هناك، فتأثرت بهذه القضية، وكذلك تأثرت بشخصية غسان، و تحمسه للقضية، و عندما عرض عليه غسان الزواج بعد عشرة أيام بلقائه إياها، أجابت بالقبول، فتزوجا. كانت آني معه في عسر ويسر، و ساعدته في تنظيم حياته غير المنتظمة، و في تقوية جسده النحيل الذي كان قد أرهقه مرض السكري، و التهاب المفاصل. إنها ساعدت غسان في توفير المواد لدراسته “أدب المقاومة في فلسطين المحتلة” عن طريق استخدام وسيلة وطنه. كان غسان و آني رزقا، في العام التالي لزواجهما، بابن سماه “فائز” ثم رُزقا بابنة سمياها “ليلى”.
ومر غسان في بيروت بأقسى ظروف عندما اضطر إلى الاختفاء عام 1962 لأنه كان لا يملك الوثائق الرسمية، وأثناء اختفائه، عندما اضطر أن يتوقف عن الكتابة في الصحف، سنحت له الفرصة أن يكتب روايته الاولى الشهيرة “رجال في الشمس”. و في السنة التالية 1963 ظهر كرئيس التحرير لصحيفة “المحرر” اليومية التي كانت تمثل نظرية القوات الناصرية المتقدمة، و محرراً لملحقها الأسبوعي “فلسطين” وأصدر أفضل وأشهر وأول روايته “رجال في الشمس” التي تعتبر معلما مهما في مسير الرواية العربية عموما و في الرواية الفلسطينية على وجه الخصوص، والتي ألقت الضوء على حالة الاستسلام والخنوع التي كان أهالي فلسطين يمرون بها سواء في الأرض المحتلة أو في المنفى
حياة غسان في بيروت كانت مشحونة بالنشاطات السياسية والأدبية معا، فنجده يزور االهند والصين عام 1965، و لكن من الأسف الشديد لا نجد أي تفصيل لزيارته للهند مثل ما لا نجد أي تفصيل لزيارته للعراق خلال إقامته بالكويت، و لكنه قد كتب رحلة حول زيارته للصين بعنوان “ثم أشرقت آسيا” التي صدرت في حلقات عام 1965. والجدير بالذكر هنا أن في هذه السنة، أنعم الله عليه بولادة ابنة سماها “ليلى”.
في العام التالي، أعني في عام 1966 يصدر غسان روايته الثانية “ما تبقى لكم” التي تجلب له “جائزة أصدقاء الكتاب في لبنان”. و في نفس السنة إنه أخرج دراسته الشهيرة “أدب المقاومة في فلسطين المحتلة 1948-1966” التي قامت بتعريف أدب المقاومة، و أخرجت الأدب الفلسطيني المتواجد في الأرض المحتلة من الانزواء إلى النور.
في عام 1967 التحق غسان بهيئة التحرير لصحيفة “الأنوار” الناصرية و عمل رئيسا لتحرير مجلتها الأسبوعية، و في نفس السنة شارك في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE (PFLP) ، برئاسة أحمد جبريل عقب تشتت حركة القوميين العرب، و أصبح عضو المكتب السياسي لها والناطق الإعلامي باسمها. وفي عام 1969 استقال عن صحيفة “الأنوار”، و قام بتأسيس مجلة ناطقة باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باسم “الهدف” وترأس تحريرها إلى أن اغتيل شهيدا.
و “الهدف” في الحقيقة كانت صحيفة يومية سياسية تصدر في بيروت، لكن عندما اشترت الجبهة الشعبية امتيازها باسم غسان كنفاني، أصبحت الصحيفة مجلة مركزية للجبهة ولسان حالها، وبدأت تصدر برئاسة تحرير غسان كل أسبوع بعشرين صفحة على قطع كبير. و قد عبر غسان عن الغاية من إصدارها في عددها الأول الذي صدر 26 يوليو 1969، بـ”رفضها لكل الصيغ العاجزة المتخذة حينا طابع المساواة، وحينا طابع المهاودة، وحينا ثالثاً طابع الوسيطة، وهي تعتنق هذا الرفض الثوري أساسا للمعركة المصيرية. إنما تأتي رداً على الصناعة الإعلامية العربية التي أسقطتها القيم التجارية و قيم المجتمع المنهار، وفي دوامة العجز والفشل. وأنها لم تسمح لمواقف الارتجال والانفعال المزايدة أن تحل مكان موقف الموضوعية والعلمية.”
- الاستشهاد:
في غرة شهر يوليو عام 1972، حضرت لميس ابنة اخت غسان التي كانت قد أكملت الثانوية العامة بأعلى المراتب في الكويت للالتحاق بالجامعة الأمريكية بـ”بيروت”. و في الثامن من يوليو، خرج غسان مع لميس ليصطحبها إلى الجامعة و ينتهي من إجراءات تسجيلها هناك، و لكن ما أن ركب السيارة و حرك مقودها حتى انفجرت عبوة ناصفة وضعها فيها جهاز مخابرات إسرائيل (موساد)، و انتشرت أشلاء السيارة و أشلاء غسان و ابنة اخته في الهواء. و تقول زوجته السيدة آني عن هذا الحادث “(… بعد دقيقتين من مغادرة غسان ولميس ـ ابنة أخته ـ سمعنا انفجارا رهيبا تحطمت كل نوافذ البيت .. نزلت السلم راكضة لكي أجد البقايا المحترقة لسيارته .. وجدنا لميس على بعد بضعة أمتار .. ولم نجد غسان، ناديت عليه !! ثم اكتشفت ساقه اليسرى.. وقفت بلا حراك.”
شهدت مدينة بيروت حشداً كبيراً وجماً غفيراً في جنازة غسان، ولعل جنازته كانت أكبر تظاهرة سياسية بعد وفاة ناصر. ودفنت بقايا غسان في مقبرة الشهداء في بيروت، واعترف مغتالوه عن جريمة قتله فيما بعد. ففي 22 يناير عام 1973، نشرت صحيفة إسرائيلية (Jerusalem Post) بأن عملاء إسرائيليين مسؤولون عن استشهاد غسان، واعترف بذلك قادة الكيان الصهيوني في شكل رسمي في أكتوبر عام 2005 بأن عملاء جهاز “الموساد” قتلوا غسان عن طريق وضع عبوة ناسفة في سيارته. ولم تكن شهادة غسان إلا حلقة من حلقات مؤامرة الصهاينة لاغتيال العبقريات و القادة الفلسطينيين الذين يلعبون دوراً في النضال الشعبي ضد التعدي والعدوان الصهيوني كما يقول أوس داؤد يعقوب: “كان اغتيال …غسان كنفاني… متابعة للمسلسل الإرهابي الصهيوني الرهيب، الذي ألحقه قادة العدو الصهيوني بأخس و أجبن محاولات الاغتيال والتصفيات الجسدية والتشويه والإرهاب عبر الطرود الملغومة، و تفجير السيارات، و زرع القنابل الموقوتة في السيارات والهواتف و الغرف، و التي كان من ضحاياها في بيروت اغتيال عدد من قادة العمل الوطني الفلسطيني، أمثال: اغتيال الكمالين ناصر و عدوان، و محمد يوسف النجار (أبو يوسف)، و محاولة اغتيال الدكتور أنيس صايغ، والصحفي بسام أبو شريف، والتي ذهب ضحيتها في بلدان الشتات والمنافي نخبة من خيرة رجالات فلسطين والأمة العربية، من كتاب و مبدعين، أمثال: وائل زعيتر، و محمود الهمشري، و د. باسل الكبيسي، و ماجد أبو شرار، و ناجي علي، وغيرهم كثير.”
الرثاء:
رثى كثير من الكتاب والأدباء العرب في مقالاتهم و شعرهم على غسان كنفاني، واعترفوا بفضله، ودوره في المقاومة الفلسطينية. وفيما يلي نورد بعض مقتبسات من عدة مقالات كتبت في رثاء غسان كنفاني لتسليط الضوء على مدى تأثر الأدباء والكتاب والمفكرين به:
محمود درويش، الشاعر الفلسطيني الرائد الذي كتب مقالة طويلة في نثر شبه شعري بعنوان “محاولة رثاء بركان” في رثاء غسان كنفاني يقول:
” اكتملت رؤياك، و لن يكتمل جسدك. تبقى شظايا منه ضائعة في الريح، و على سطوح منازل الجيران، و في ملفات التحقيق. و لم يكتمل حضورنا نحن الأحياء-طبقا لكل الوثائق. نحن الأحياء مجازا. و أنت الميت-طبقا لكل الوثائق. أنت الميت مجازا.
نحزن من أجلك؟ لا.
نبكي من أجلك؟ لا.
أخرجتنا من صف المشاهدين دفعة واحدة، و صرنا نتشوف الفعل، و لا نفعل. أعطيتنا القدرة على الحزن، وعلى الحقد، على الانتساب. و كنا نتعاطى الحزن بالأقراص، و نتعاطى الحقد بالحقن، و نتعاطى الانتساب بالوراثة.
مرة واحدة أعطيتنا القدرة على الاقتراب من أنفسنا، و على الرغبة في الدخول إلى جلودنا التي خرجنا منها دون أن ندري. الآن ندري، حين خرجت منا.
و من أنت يا غسان كنفاني؟
حملناك في كيس، و وضعناك في جنازة بمصاحبة الأناشيد الرديئة، تماما كما حملنا الوطن في كيس، و وضعنا في جنازة لم تنته حتى الآن، و بمصاحبة الأناشيد الرديئة.
كم يشبهك الوطن!
و كم تشبه الوطن!
والموت دائما رفيق الجمال، جميل أنت في الموت يا غسان. بلغ جمالك الذروة حين يئس منك و انتحر. لقد انتحر الموت فيك. انفجر الموت فيك لأنك تحمله منذ أكثر من عشرين سنة ولا تسمح له بالولادة. اكتمل الآن بك، واكتملت به. ونحن حملناكم. و أنت والوطن والموت. حملناكم في كيس و وضعناكم في جنازة رديئة الأناشيد. و لم نعرف من نرثي منكم. فالكل قابل للرثاء. و كنا قد أسلمنا أنفسنا للموت الطبيعي.
و يا غسان كنفاني. للمناسبة، قل لي من أنت؟
غامض، و عاجز عن الإجابة، لأنك فلسطيني حقيقي. كلما اشتد وضوحك اشتد غموضك. تنسى نفسك في البحث عن الوطن. و ينساك الوطن في بحثك عن نفسك، ثم تلتقيان يومين في اليوم. في اليوم الواحد تلتقيان أمس و تلتقيان غدا. و ما الفرق بينكما؟ هو الفارق بين ظل الشجرة في الدم، وبين ظل الشجرة الماء.
فلسطيني حتى أطراف أصابعك. فلسطيني حتى الحماقة.
و هذا هو مجدك إذا كان المجد يعنيك.
تسلم على السائح، فتصيبه عدوى فلسطين….
هذا هو مجدك إذا كان المجد يعنيك.
ليست أشلاؤك قطعا من اللحم المتطاير المحترق. هي عكا، و حيفا، و القدس، و طبريا، و يافا. و طولى للجسد الذي يتناثر مدنا….
نسفوك كما ينسفون جبهة، وقاعدة، وجبلا، وعاصمة.
وحاربوك، كما يحاربون جيشا..لأنك رمز، و حضارة جرح.
ولماذا أنت؟ لماذا أنت؟
لأن الوطن فيك صيرورة مستمر و تحول دائم. من سواد الخيمة حتى سواد النابالم. و من التشرد حتى المقاومة….
لو وضعوك في الجنة أو جهنم، لاشغلت سكانهما بقضية فلسطين.
ها هم يتبارون في رثائك. كأنك شيء ذاهب…
ها هم يتبارون في رثائك، كأنهم يرثون فردا.
آه.. من يرثي بركانا!”
هذه المقتبسات تلقي الضوء على مدى تأثر محمود درويش بغسان كنفاني، و كذلك تدل على إدراكه المكانة التي احتلها غسان كنفاني في الكفاح الشعبي أديباً وصحفياً وسياسياً و فكرياً.
ويقول أنيس صائغ في مقال كتبه بعنوان “غسان كنفاني: لقاء لم يتم”:
“عاش غسان ثورة دائمة في العلاقات الخاصة، كما في الشؤون العامة. فنانا كان، أو أديبا، أو كاتبا، أو مفكرا، صديقا كان، أو رفيقا، أو زميلا، أو قريبا، أو زوجا، أو أبا، أو أخا، كان ثورة تلتهب مثلما تحرق أعصابه. لذلك كان النضال الفعلي في الثورة الفلسطينية/العربية/الإنسانية، بالكتابة والتوجيه والدعوة والانتماء العقائدي، و تحمل المسؤولية، بؤرة يحقق غسان فيها ذاته، و يقترب من مثله العليا السامية. و لعله كان أيضا يريح فيها أعصابه.”
- آثار غسان كنفاني:
بما أن شخصية غسان كانت ذات موهبة فياضة، و ذات أوجه متعددة، تنوعت عطاءاته و إنتاجاته في الأدب، والنقد، و الفن، والثقافة، والسياسة، فثبت كاتبا مكثرا خلال عمر غير مديد، و أثرى المكتبة العربية إثراء يقل نظيره. إنه ملأ صفحات الصحف بقلمه السيال، و أخرج روايات رائعة ممتازة، و كتب القصص المثيرة، و أعد بحوثا و دراسات قيمة، و أصدر مسرحيات جديرة بالتمثيل على خشبة المسرح ألف مرات، فكما يقول عبد الله ابو راشد “كان (غسان) حالة انسانية متوازنة و بداعية منفردة يقف على مسافة واحدة من جميع صنوف الأدب والفنون والصحافة و السياسة التي خاض غمارها منذ بواكير حياته.” وكل ذلك لغرض نبيل و هدف سام، و هو مأسأة فلسطين و حقوق مواطنيه الفلسطينين الذين يشكلون محور كتاباته، كما قال بنفسه -و هو يجيب ابنة أخته لميس التي طلبت منه أن يترك العمل النضالي ويتفرغ لكتابة القصص لأن قصصه جميلة – أنا أكتب جيدا لأنني أومن بقضية، و بالمبادئ. في اليوم الذي أترك هذه المبادئ، ستكون قصصي فارغة. و إذا تركت المبادئ خلف ظهري، لما تحترميني بنفسك. وجملة القول، إنه خلف آثاراً رائعة وغزيرة رغم حياته القصيرة، وترك لنا تراثاً عظيماً قد أصبح جزءاً من الأدب العالمي، وسوف يبقي مدى حياة الأدب العربي.
- الدراسات والبحوث:
صدر لغسان كنفاني خمس دراسات و بحوث، “أدب المقاومة في فلسطين المحتلة” عام 1966 في بيروت، و”الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال 48 – 68″ عام 1968 في بيروت، و “فى الأدب الصهيوني” عام 1967 في بيروت، و “المقاومة ومعضلاتها”، و”ثورة 36 – 39 في فلسطين، خلفيات و تفاصيل”.
المسرحية: أخرج غسان كنفاني ثلاث مسرحيات “الباب” عام 1964، و”جسر إلى الأبد” عام 1965، و”القبعة والنبي” عام 1967.
رواياته: أخرج غسان كنفاني في طول حياته أربع روايات مختصرة كاملة “رجال في الشمس” عام 1963 ، و”ما تبقى لكم” عام 1966، و”أم سعد”عام 1969، و “عائد إلى حيفا” عام 1969. و كتب، ما عدا هذه الروايات الأربع، ثلاث روايات أعجلته المنية قبل أن يكملها 1-العاشق، 2-الأعمى و الأطرش، و 3- برقوق نيسان. و هناك رواية تم إصدارها عام 1980 بعد استشهاده بعنوان “الشئ الأخر أو من قتل ليلى حائك”.
قصصه القصيرة: صدرت لغسان كنفاني خمس مجموعات قصصية و هي: “موت سرير رقم 12” عام 1961م، و “أرض البرتقال الحزين” عام 1962، و “عالم ليس لنا” عام 1965، و”عن الرجال والبنادق” عام 1968، و”القميص المسروق وقصص أخرى” نشرت بعد وفاته.
المصدر: غسان كنفاني: دراسة في حياته وأعماله د/ محسن عتيق خان الندوي