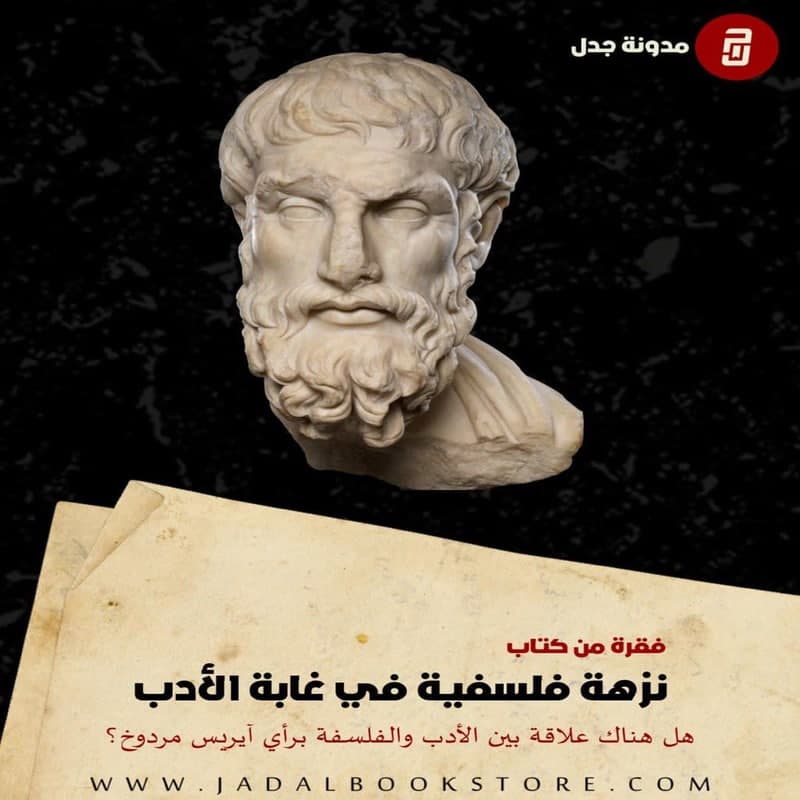الأدب والفلسفة:
من الحوار بين آيريس مردوخ وبريان ماغي
الأدب والفلسفة:
الأدب يوفر المتعة ويفعل الكثير من الأمور، أما الفلسفة فتفعل أمراً واحداً فحسب …
لطالما كان بعض عظماء الفلاسفة كُتّاباً عظاماً بحسب مايعتقد الأدباء العظام ذوو الصنعة الفنية الراسخة، وأظن أن الأمثلة الأكثر تعبيراً عن هؤلاء الكتّاب – الفلاسفة هي: أفلاطون ، القديس أوغسطين، شوبنهاور ، نيتشه ،،، وثمة آخرون وإن كانوا لا يعدّون قاماتٍ عظيمة مثل السابقين الذين ذكرتهم لكنهم كانوا بالتأكيد كُتاباً على قدر كبير من الصنعة الجيدة: ديكارت، باسكال، بيركلي، هيوم، روسو. في وقتنا الحاضر ( وقت إجراء الحوار ، المترجمة ) فإن كلّاً من برتراند راسل و جان بول سارتر قد مُنحا جائزة نوبل للأدب؛ لكن ثمة في الوقت ذاته فلاسفة عظامٌ هم كُتاب سيئون، ويحضر في الذهن على الفور كانت وأرسطو اللذان كانا فيلسوفين عظيمين و إثنين من أكثر الكُتّاب رداءة في الكتابة الأدبية، أما آخرون سواهم -مثل القديس توماس الأكويني وجون لوك – فكانوا على قدر غير قليل من الركاكة الأدبية. الأمر بالنسبة إلى هيغل مختلف عمّا سواه؛ فقد صار عمله أنموذجاً للكتابة المكتنفة بالغموض والتعمية حتى بات الأمر مثار سخرية ومزحة سمجة في سياق الحديث عن الفلسفة الموظّفة في الكتابة الأدبية، وأظّن من جانبي أن هيغل هو الكاتب الذي تتطلب قراءته جهداً ومشقة غير مجدية أكثر من كل الكُتاب الآخرين ذوي الشهرة المدوية على مستوى العالم بأسره.
إنّ ماتكشف عنه الأمثلة السابقة بوضوح هو أن الفلسفة ليست تفريعاً أو حقلاً معرفياً منتمياً للأدب؛ إذ أن نوعية الكتابة الفلسفية وأهميتها تكمن في إعتبارات أبعد من القيمتين الأدبية والجمالية، وإذا ماكان الفيلسوف -أي فيلسوف- يجود في طريقة كتابته فتلك مزّية تحسب له بالتأكيد وستجعله على قدر كبير من الغواية التي تدفع الآخرين لدراسته؛ غير أن الكتابة الفاتنة لن تجعل منه فيلسوفاً أفضل، وأقول هذا بوضوح صارم ومنذ البدء لأنني وفي سياق هذه المحاورة سأتناول بعض الجوانب التي يمكن أن تكون مناطق تداخل بين الفلسفة والأدب في عمل كاتبة تمتد خبراتها لتشمل عالمي الفلسفة والأدب معاً.
المصدر: كتاب نزهة فلسفية في غابة الأدب
المؤلف: بريان ماغي
ترجمة وتقديم: لطيفة الدليمي