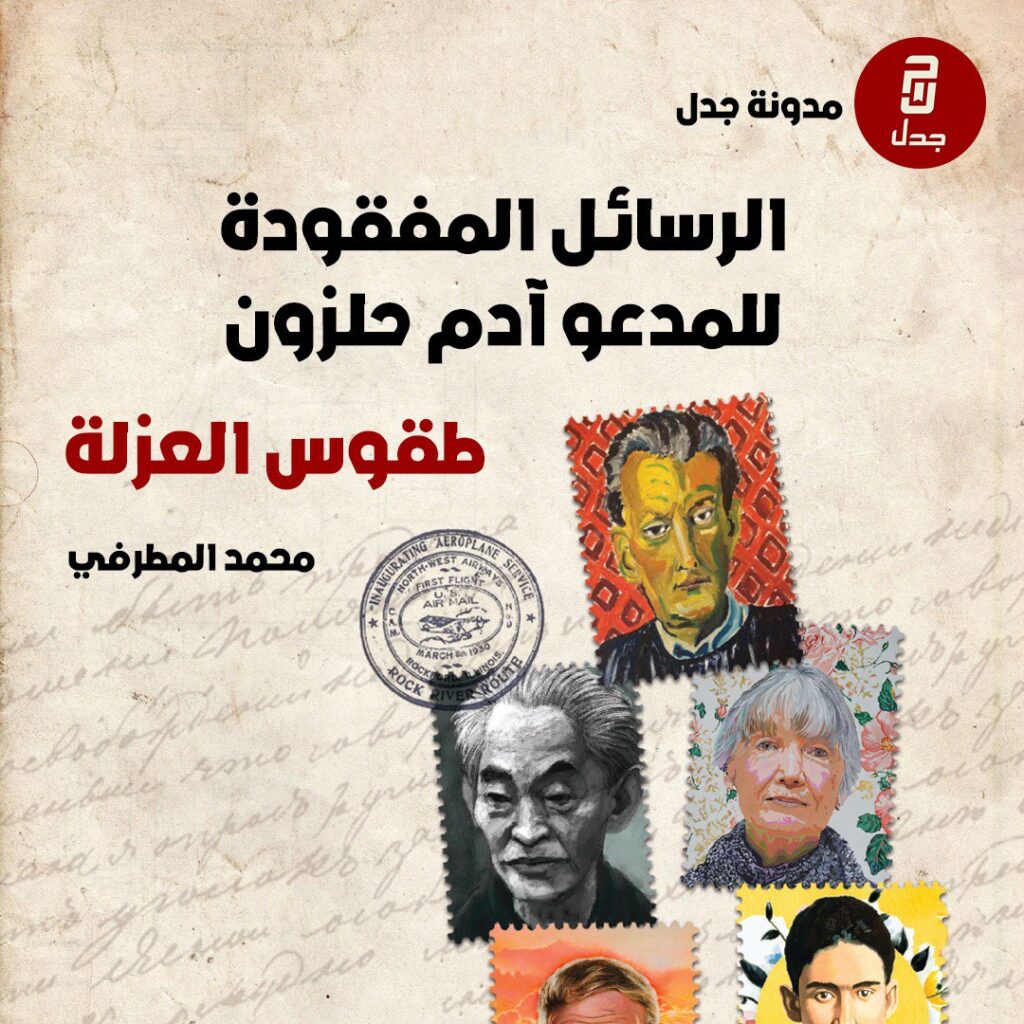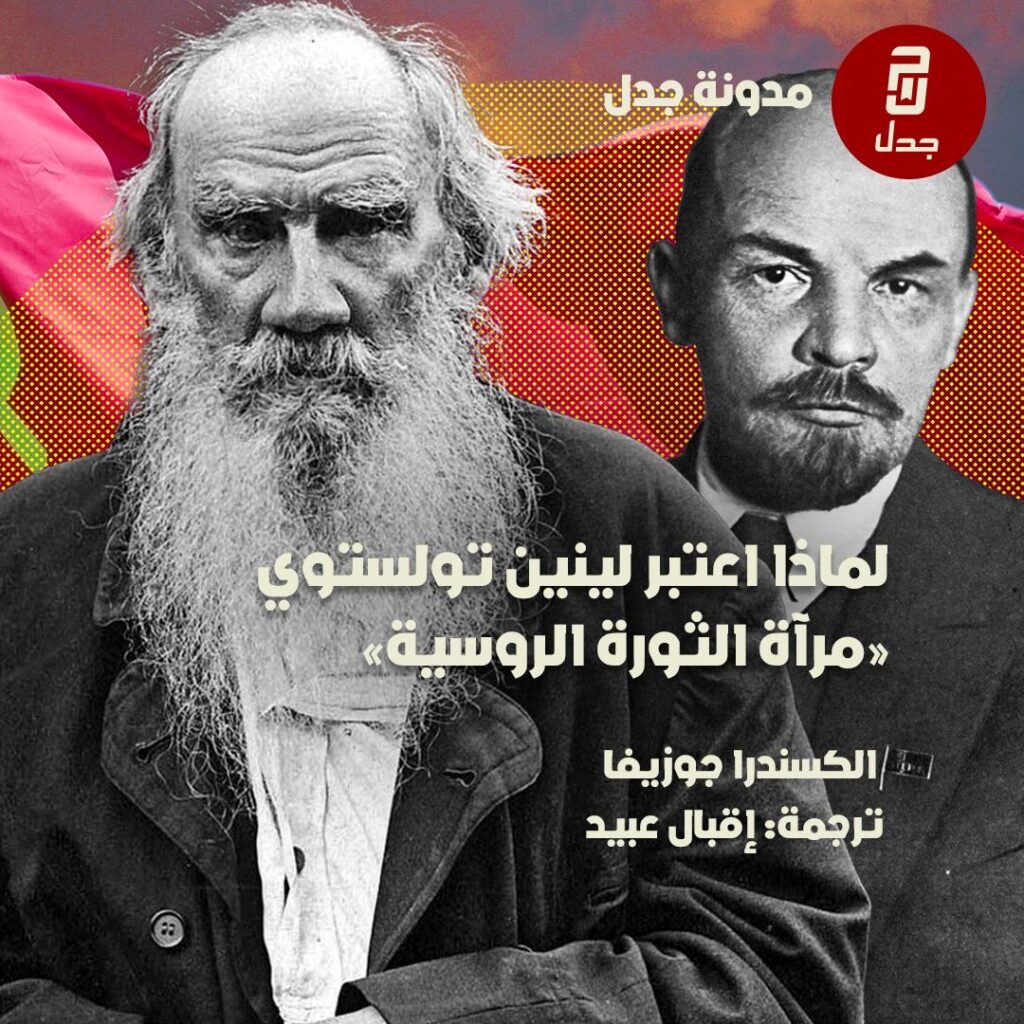51 عامًا على اغتيال غسان كنفاني.. “تسقط الأجساد لا الفكرة”
“إن قضية الموت ليست على الإطلاق قضية الميت، إنها قضية الباقين”.
تثبت نظرة ونظرية الكاتب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني جدواها وواقعيتها حتى اليوم في الذكرى الـ50 لاغتياله، في 8 من تموز، من قبل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي (الموساد)، في شارع الحازمية في قلب العاصمة اللبنانية، بيروت.
الاغتيال الذي قابلته الصحافة العربية حينها بمنحه صدر صفحاتها الأولى، وقابله المناصرون للقضية الفلسطينية بالدعوة للثأر والانتقام، وتعاملت معه فصائل المقاومة بالوعيد، كان انتصارًا بعيون رئيسة الوزراء الإسرائيلية حينها، جولدا مائير، التي قالت تعقيبًا على الاغتيال، “بمقتل غسان تخلصنا من لواء فكري مسلح، فغسان كان يشكّل خطرًا على إسرائيل أكثر من ألف فدائي مسلح”.
استهداف من هذا النوع يؤكد البعد اللامرئي والخطر الذي استشفه الاحتلال الإسرائيلي في قلم غسان، وفكره ومنطقه.
وبالنظر إلى مجمل الإنتاج الفكري المكثف، قياسًا بالوقت الذي منحه الكاتب الثلاثيني للرواية والأدب والفكر، تتجلى القضية الفلسطينية بتفاصيلها ويومياتها انطلاقًا من الحرب والمقاومة إلى اللجوء والنزوح وصولًا إلى المخيمات والتأقلم، في أكثر مناطق السرد بعدًا عن القضية، فغسان لا يكتب دون جدوى، ولا يترك الكلمات تسوسه، وفق ما هو محفوظ من إرث أدبي وفكري ووطني لكاتب اغتاله عدوه وهو في الـ36 من العمر.
الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، رثى غسان وخاطبه في حضرة غيابه قائلًا، “نسفوك، كما ينسفون جبهة، وقاعدة، وجبلًا، وعاصمة، وحاربوك، كما يحاربون جيشًا (…) لأنك رمز وحضارة جرح”.
ولد غسان كنفاني في عكا، وعاصر في ريعان الطفولة احتلال فلسطين، وجرّب مرارة النزوح واللجوء، لينخرط في العمل النضالي والفكري باكرًا، من بوابة الصحافة، و”منظمة التحرير الفلسطينية”، والاجتماعات واللقاءات والمقابلات، والمشاريع النضالية، خدمة لقضية بلاده، متسلحًا باللغة المكتنزة بالمشاعر والقدرة على التحريض وخلق حالة تعبئة نفسية قائمة على المنطق أيضًا، إلى جانب المشاعر.
ومن أبرز مؤلفاته في هذا الصدد، “القميص المسروق”، وهي مجموعة قصصية طرح غسان عبرها مجموعة من القيم والمفاهيم، وفصّلها لا باعتبارها قيمًا ثورية فقط، بل أخلاقية ضرورية لنجاح كل ثورة، ولا بد منها من أجل حياة مطمئنة.
وفي المجموعة المكوّنة من ثماني قصص، لا يناقش كنفاني القيم الأخلاقية للثورات، فهي ثابتة وصلبة لا تتماشى مع المرحلة بمقدار ما تسعى لتطويعها وإخضاعها، لتثبت أنها أقوى من المتغيرات.
وفي زحمة كل ذلك، وفي سبيل حب جارف حمله للكاتبة السورية غادة السمان، لكنفاني كتاب باسم “رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان”، هذه الرسائل حملت دروسًا في عمق اللغة ومنطقها وكثافة المشاعر الإنسانية المفرغة على الورق، كما حمل كاتب تلك الرسائل أيضًا مرض السكري والنقرس وهمّ البلاد على الجسد النحيل.
ومن أبرز أعمال غسان كنفاني أيضًا، “عالم ليس لنا”، و”موت سرير رقم 12″، و”رجال في الشمس”، و”ما تبقى لكم”، و”أرض البرتقال الحزين”، ورواية “العاشق”، وهي رواية ناقصة، لم تكتمل، أو ربما اكتملت بنقصها طالما أن الاغتيال لم يمهل الكاتب ليضع نقطة النهاية ويسدل الستار على أبطال قصصه الثلاث.
يقدّم غسان في “العاشق” وجهًا أدبيًا لم يعهده به القارئ، فرغم نشر غادة السمان رسائله إليها، بما تفور به من حب جامح يحمله رجل متزوج أتعبه المرض، وأنهكه النشاط السياسي في سبيل قضيته، وهو في ريعان الشباب، فإن “العاشق” تصوّر غسان مراقبًا لحب مختلَق، لا بطلًا وضحية معًا.
وحققت هذه الأعمال التي لم تنتهِ، أو لن تنتهي، أو ربما منحتها الأقدار نهاية مفتوحة، التأثير والغرض منها، باعتبارها ما زالت حاضرة لا على رفوف المكتبات العربية فقط، بل وبين يدي وفي أذهان أجيال تتعاقب منذ 51 عامًا، منذ الاغتيال، لتثبت مقولة غسان عليه شخصيًا، “تسقط الأجساد، لا الفكرة”.