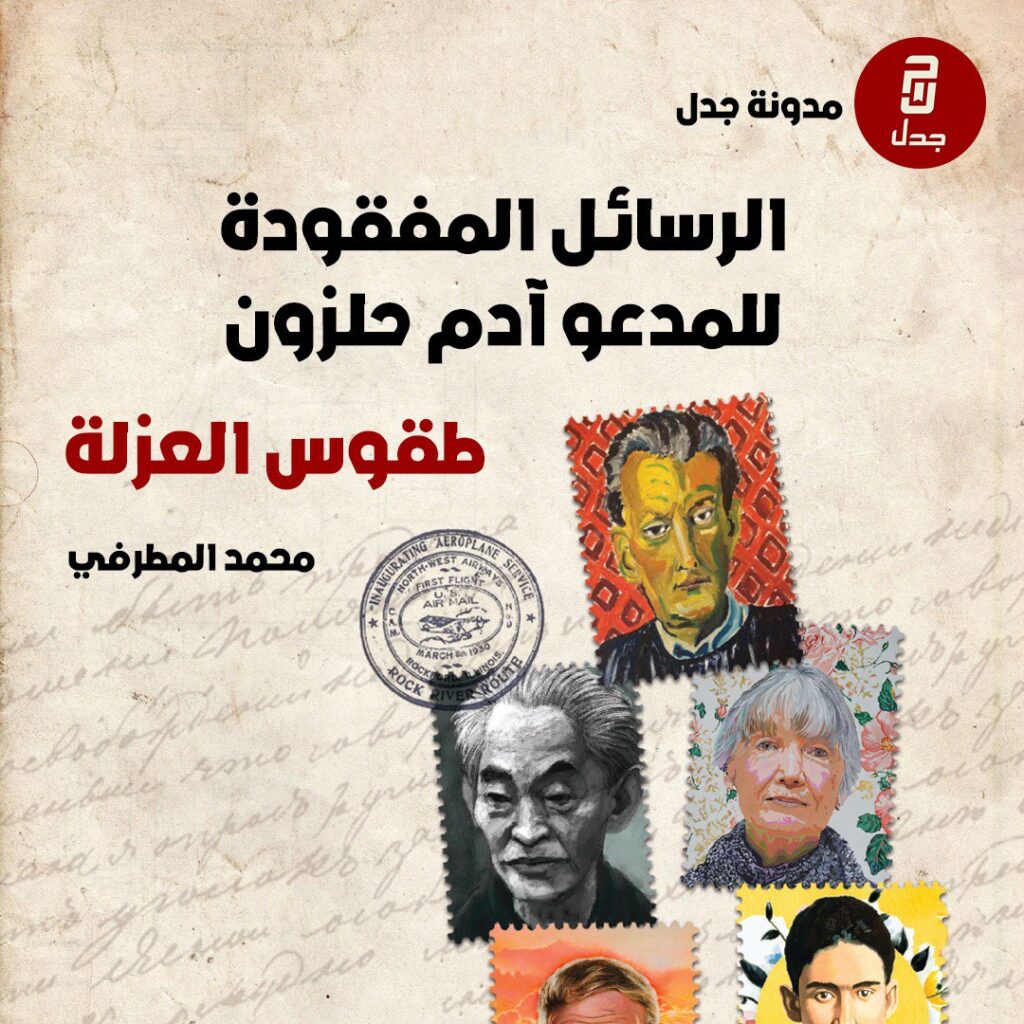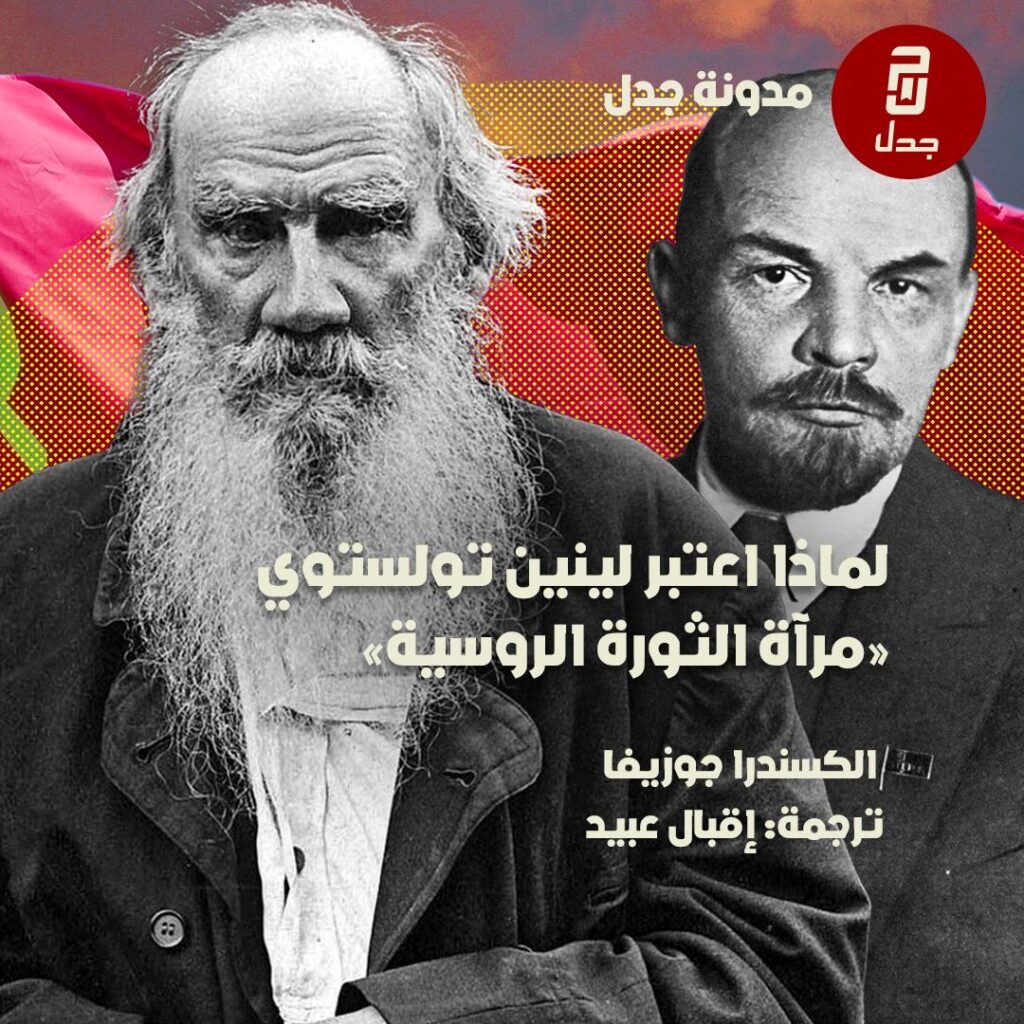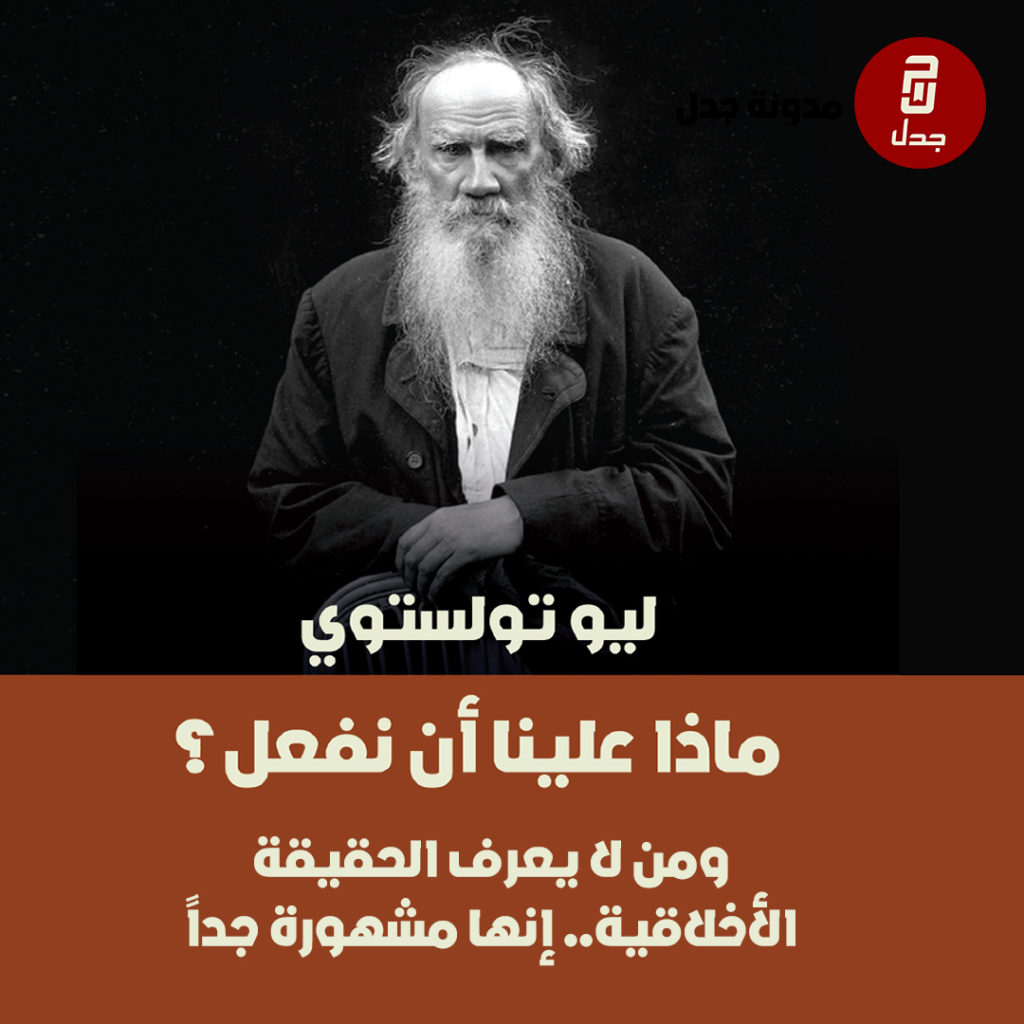“النسوية للجميع”.. بيل هوكس تعالج ثغرات النظرية والممارسة النسوية | بقلم: هيڤا نبي
يواجه كل من الخطاب النسوي والممارسات النسوية سوء فهم كبير قد يكون من بين أسبابه العميقة النسوية نفسها، في جانبيها النظري والتطبيقي، وهذا ما لا يطرح بشكل جدي للنقاش والبحث، وتستغله المنظومة الأبوية التقليدية ضد الحركات النسوية. وهذا ما دفع الناقدة والمفكرة النسوية بيل هوكس لتعيد تقييم واقع النسوية بشكل لافت.
في كتابها “النسوية للجميع: السياسات العاطفية” تتوجه الناقدة والمفكرة النسوية بيل هوكس بالدرجة الأولى إلى مَن لم يتعرّف إلى النسوية إلا من خلال الأفكار والكتابات المستهلكة حولها، أي كل من عرف النسوية من خلال خطابات النظام الأبوي. فتتناول مراحل النضال النسوي والإسهامات والتغيرات التي نتجت بفضل الثورة النسوية في الستينات والسبعينات وما بعدها.
لكن الكتاب الصادر عن دار جدل الكويت، بترجمة منير عليمي، موجه بدرجة أكبر للنسويات أنفسهن، إذ تهتم الكاتبة بتسليط الضوء على مكامن النقص والخلل والضعف في النظرية والممارسة النسويتين.
الطبقية والعنصرية والحب
الكتاب يبحث عن لغة مشتركة مع النساء والرجال من كافة الطبقات لتجاوز النقص في النظرية والممارسة النسويتين
الكتاب يبحث عن لغة مشتركة مع النساء والرجال من كافة الطبقات لتجاوز النقص في النظرية والممارسة النسويتين
يمكن القول إن هوكس تقف في المنتصف بين الدفاع عن النسوية ونقدها: دفاع عنها بتسليط الضوء على الإنجازات والتغيرات التي حصلت للعالم بفضل الحركات النسوية وإسهاماتها، ونقد للنسوية من حيث إنها حركة سياسية لم تتخلّص في بعض مواطنها من العنصرية والطبقية والعرقية، وعجزت أو أحجمت في بعض المواطن عن تقديم بدائل للخطابات الذكورية. فالهدف الذي تتطلع إليه النسوية كما تراها بيل هوكس هو إنشاء مجتمع متطهر من الطبقية والعبودية والاستغلال والتحيز الجنسي “عالم مجرد من كل هيمنة، حيث الإناث والذكور ليسوا متشابهين أو متساوين دائما، ولكن حيث الرؤية التشاركية هي الروح التي تشكل تفاعل (هم)”.
ومن أبرز النقاط التي تثيرها الكاتبة في هذا الشأن هي قلة وعي النسوية وإغفالها أحيانا الفروقات الطبقية داخل النسوية نفسها. فما إن تسلّمت النسوية البيضاء راية النضال حتى زاد الشرخ بينها وبين النسوية السوداء ونسوية الطبقة العاملة، إذ جعلت النسوية البيضاء نفسها النموذج المعياري في الممارسة والنظرية النسويتين. وبهذا تم تجهيل خصوصية هذه الطبقات والتي لا تنسجم غالبا مع مطالب وخصوصية النسوية البيضاء.
ترى هوكس أن النسوية يجب أن تعمل على محاربة العنصرية والتمييز على أساس العرق، بل إن خطاب الأختيّة وممارستها سيكون مستحيلا في ظل الإبقاء على الطبقية والعنصرية، وهي على تعارض كبير أساسا مع أهداف النسوية، تقول “لقد شهدتُ لسنوات إحجام المفكرات النسويَّات البيض عن الاعتراف بأهمية العرق، لقد شاهدت رفضهنَّ تجريدهنَّ من التفوق الأبيض، وعدم رغبتهنَّ في الاعتراف بأنَّ الحركة النسوية المناهضة للعنصرية هي الأساس السياسي الوحيد الذي من شأنه أن يجعل الأختيَّة حقيقة واقعة. وشهدت ثورة الوعي التي حدثت عندما بدأت النساء الفردانيَّات في التحرر من الإنكار، والتحرر من التفكير التفوقي للبيض. هذه التغييرات الهائلة تعيد إيماني بالحركة النسوية، وتقوي التضامن الذي أشعر به تجاه جميع النساء”.
إلى جانب الوقوف في وجه التحيز العنصري والعرقي، تؤكد هوكس الحاجة إلى ربط النظام الأبوي بالنظام الرأسمالي، والتركيز على أن التخلص من الثاني مقرون بالتخلص من الأول. فالرأسمالية هي التي غيرت شكل الأسر والعائلة وشكل العمل ولم تتوقف حتى بعد أن جعلت الاكتفاء الذاتي الاقتصادي غير ممكن للنساء كما للرجال. أما الأبوية فقد بررت العنف بأشكاله وجعلت ممارسته جزءاً من الحياة الأسرية سواء على النساء أو الأطفال أو حتى الرجال. تكشف الكاتبة هنا مثلاً عن عدم وجود تدخل نسوي لتسليط الضوء على دور الأمهات في تعزيز النظام الأبوي ومن ضمن أخطر نتائجه العنف الموجه ضد الأطفال. هؤلاء الأمهات اللاتي تبنين الرؤية الأبوية يستمررن في ممارسة العنف على الأطفال حتى وهن أمهات عازبات.
ما إن تسلّمت النسوية البيضاء راية النضال حتى زاد الشرخ بينها وبين النسوية السوداء ونسوية الطبقة العاملة
ولأن ارتباط هذين النظامين متداخل بشكل كبير، فإن النضال ضد الرأسمالية كرديف للأبوية يحتم الحاجة إلى إعطاء بدائل كثيرة عن المنظور الأبوي والرأسمالي للجمال والتربية والعلاقات وشكل الزواج والحب. رغم ثورتها على المعايير الجمالية الذكورية التي تحصر جسد المرأة في قالب واحد، عجزت النسوية عن تقديم بدائل عن الجمال التقليدي، وبالتالي تركت فراغاً وحاجة إلى معرفة الجمال أو حدود الجسد الممكن خارج القوالب، ما أعاد النساء إلى طلب الجمال وفق المعايير الشائعة. وهذا ما استغلته الرأسمالية أشد الاستغلال.
وبنفس الدرجة عجزت النسوية عن خلق خطاب نسوي إيجابي عن الحب يصبح مرجعاً نسوياً للرجال والنساء على حد سواء. تقول هوكس “بينما كان الكثير منا يحب في حياته الخاصة، وهو حب متجذر في الممارسة النسوية، لم نخلق حواراً نسوياً واسع النطاق حول الحب”. والأمر لم يكن بعيداً في التربية، حيث الأسس التي تقوم عليها الأبوية لم تُهدم تماماً، بل استمرت في حضورها من خلال الأمهات المتبنيات للخطابات الأبوية. تضيف هوكس “فالأم التي قد لا تكون أبداً عنيفة، لكنها تعلم أطفالها، ولاسيما أبناءها، أنّ العنف وسيلة مقبولة لممارسة السيطرة الاجتماعية، لا تزال متواطئة مع العنف الأبوي. على تفكيرها أن يتغيَّر”.
هذا القصور لا يعني أن النسوية لا تمتلك خطاب حب يختلف اختلافا جذرياً عن الحب في المؤسسة الأبوية، بل يعني أن النسويات لم يلتفتن للتركيز على ذلك إلا متأخراً، مما سمح للإعلام الأبوي تصدير النسوية كلها كسياسة ترتكز على كراهية الرجال والأسرة والعائلة. أما الرؤية النسوية للحب فتتلخص في أن الحب بين الجنسين لا يمكن أن “يتجذر في علاقة تقوم على الهيمنة والإكراه”. إن الحب الذي تتطلع إلى تأكيده النسويات هو حب رافض لكل الروابط السلطوية والتملكية.
إيجاد لغة مشتركة
إلى جانب نقد التحيزات العرقية والجنسية والإكراهات الممارسة من قبل الرأسمالية، لا تغفل الكاتبة الجانب الذي تجد فيه النسويات حاجة ملحة للانغماس والممارسة وهو جانب الروحانية. إن روحانية الأديان تم تخريبها بشكل كبير من قبل رجال المؤسسة الدينية وخطاباتها النافية للمرأة عامة. ودفاعا عن الروحانية التي تحتاجها النساء ويمارسنها تتولد الحاجة إلى تسليط الضوء على الشروخات التي أحدثها الدين المؤدلج بين الذكر والأنثى بدءا من الخطيئة المنسوبة لحواء. تقول هوكس “لقد ساعدنا تمثيل الله بطرق متنوعة، واستعادة احترامنا للمرأة المقدسة، على إيجاد طرق لإعادة تأكيد أهمية الحياة الروحية”.
أما المطلب المهم الذي تطرحة هوكس في كل تصور رؤيوي للنسوية فهو إيجاد لغة مشتركة مع النساء والرجال من كافة الطبقات وعودة إلى بدايات النسوية التي عملت على التوعية العامة والشاملة للجميع قبل أن تحصر نشاطاتها في الأكاديميات والجامعات وتعزل نفسها.
الاهتمام الذي توليه هوكس لجوانب النقص في النظرية والممارسة النسويتين إنما يأتي من الحاجة الملحة إلى الانتباه إلى الفراغات التي أهملتها، أو لم تعمل عليها النسوية بشكل كاف وجاد
تطالب هوكس كذلك بعمل فعال لا على مستوى النخبة والأكاديميات بل على مستوى العامة، من مثل إنشاء كتيبات مدرسية ونشر التوعية برؤية النسوية في الأوساط الاجتماعية، إضافة إلى فتح محطات تلفزيونية وإذاعية نسوية وتمويل برامج تعليمية وفتح مدارس وكليات نسوية لا تضم فقط النساء البيض كما جرت العادة، بل تفتح الباب بشكل جاد أمام الملونات والمنتميات للطبقات الفقيرة، تقول “يلقي منتقدو النسوية باللوم على الحركة في كلّ الاستياء الذي تواجهه المرأة العصرية، إنهم لا يتحدثون أبداً عن النظام الأبوي أو الهيمنة الذكورية أو العنصرية أو الاستغلال الطبقي”.
إن الاهتمام الذي توليه هوكس هنا لجوانب النقص في النظرية والممارسة النسويتين إنما يأتي من الحاجة الملحة إلى الانتباه إلى الفراغات التي أهملتها، أو لم تعمل عليها النسوية بشكل كاف وجاد، بحيث إنها بعد وقت أُعيد ملؤها بالخطابات الأبوية وصارت سلاحاً ضد النسوية نفسها. هذه الثغرات استغلتها النظم الأبوية لأن النسوية لم تقدم لها بدائل في الوقت المناسب، تقول “تعتقد جماهير النَّاس أن الحركة النسوية دائماً تتعلق بالمرأة التي تسعى إلى أن تكون متساوية مع الرجل فحسب. والأغلبية العظمى من هؤلاء الناس تعتقد أن النسوية مناهضة للذكور. يعكس سوء فهمهم للسياسات النسوية حقيقة أن معظم الناس يستقون معارفهم عن النسوية من وسائل الإعلام البطريركيّة”.
لا يمكن حصر أهمية هذا الكتاب في اللمحات العديدة التي تقدمها الكاتبة عن الممارسة النسوية، ولا في فتحه الباب أمام المزيد من العمل الفعال، بل على الأخص لأنه يُظهر أن:
اختيار السياسة النسوية هو اختيار للحب.
أنك إذا كنت ضد الرأسمالية فهذا يعني أن طريق النسوية هو طريقك.
إذا كنت ضد سلطة رجال الدين والدين المؤدلج فطريق النسوية أمامك وهو طريقك.
إذا كنت ترغب بالاحتفاظ بالروحانية وترفض في ذات الوقت بقايا السلطوية الدينية التي تنبذك من أرض الله فطريقك يتقاطع مع طريق النسوية.
إذا كنت ضد العنف ضد الأطفال سواء أكان ممارسه رجلا أو امرأة فإن طريق النسوية يتقاطع مع طريقك.
إذا كنت ضد السلطة كمفهوم وممارسة على البشر والكوكب سواء بسواء فطريق النسوية هو طريقك.
إذا كنت ضد الطبقية والعرقية في أصغر تفاصيلها فإن النسوية لا تخالف مطلبك، هي ضد كل تحيز وعنصرية حتى عنصرية النسوية البيضاء الغنية ضد نساء الطبقة العاملة.
المصدر: صحيفة العرب