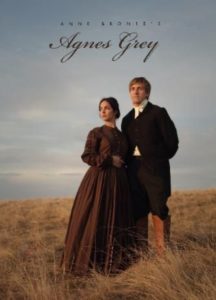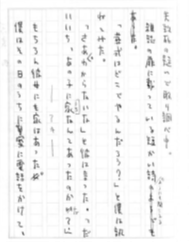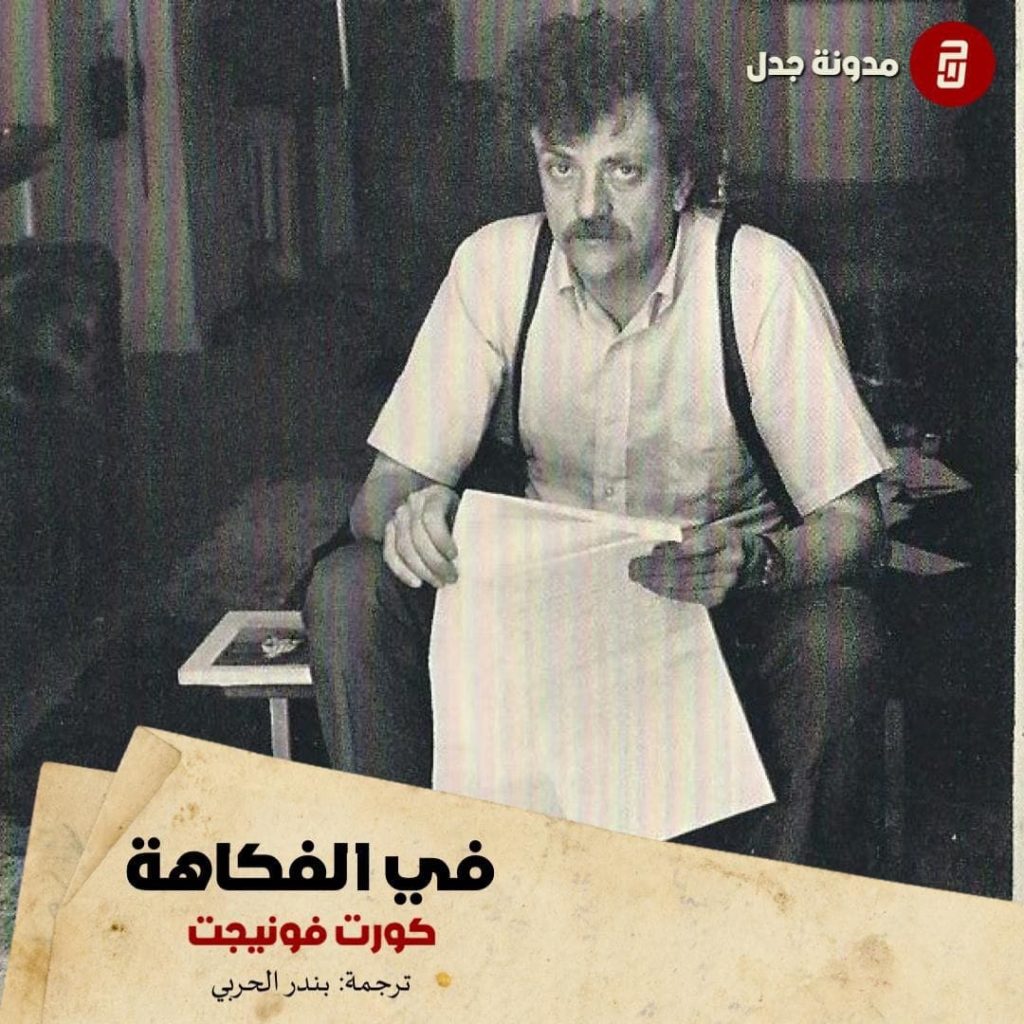أغنس غري رواية لا أقل من عبقرية
أغنس غْري: رواية لا أقلّ من عبقرية
شهر كانون الأول/ ديسمبر هو الوقت الذي يشتري فيه الناس الديك الرومي، ويلفّون الهدايا، ويعلّقون على الأبواب نبات الهدال، لكنّ هناك سبباً آخر للاحتفال في هذا الشهر؛ فهو يصادف الذكرى السنوية لنشر اثنين من أعظم ما كُتب من الكتب طراً.
نُشر معاً كتاب مرتفعات ويذرينغ (Wuthering Heights) بقلم إميلي برونتي، وكتاب أغنس غْري (Agnes Grey بقلم آن برونتي، من قبل الناشر نفسه توماس كوتلي نيوبي، في كانون الأول/ ديسمبر 1847. وقد شكّلت الكُتب مجموعةً من ثلاثة مجلدات؛ اثنين منها لكتاب مرتفعات ويذرينغ، ومجلد واحد لكتاب أغنس غْري. كان هذا الشكل معروفاً باسم ثلاثية، وقد شاع، بشكل خاص، في منتصف القرن التاسع عشر، وخاصة بين الناشرين، الذين يتقاضون رسوماً ثلاثة أضعاف من المكتبات المنتشرة، التي كانت ضمن عملائهم الرئيسيين.
وفي حين أنّ مرتفعات ويذرينغ تحظى بالثناء في جميع أنحاء العالم، نجد أن أغنس غْري لا تحصل على ما تستحقه تقريباً. وبينما تختلف تماماً عن الرواية الجريئة والدرامية الأخرى لآن المستأجر من ويلدفيل هول، أجد أن أغنس غْري، في نظري، بروعتها نفسها. في الواقع، أعلم أنني لست وحدي من يرى أن أغنس غْري هي من أكثر الكتب التي لا تحظى بالتقدير، فلماذا أحبّها كثيراً؟
أحد الأسباب، التي جعلتني أحبّ رواية أغنس غْري، هو السبب نفسه الذي جعلني أعدُّ كتاب شيرلي (Shirley)للكاتبة شارلوت برونتي أفضل عمل لها: هذا الكتاب هو سيرتها الذاتية، ويحتوي على أشخاص وأحداث كانت آن تعرفها.
تبدأ الفقرة الثانية من الكتاب: «كان والدي رجلَ دينٍ من شمالي إنجلترا»، تماماً كما كان والد آن رجل دين (أي يعمل في) شمالي إنجلترا. إنه أول دليل من بين العديد من القرائن، التي تشير إلى أن أغنس هي في الواقع آن، أو أكتون (Acton)، كما كانت الكاتبة تسمّي نفسها في ذلك الوقت.
عند كتابتي السيرة الذاتية لآن، وجدت ستين حالة من الكتاب يمكن أن تكون مرتبطة، بشكل مباشر، بأحداث وقعت في حياة آن. بطبيعة الحال، هو عمل روائي، وأبدعت فيه من هذه الناحية، ولكن، كما يعلم كل كاتب روائي، لا يوجد كتاب واحد لا يحتوي على قطعة من الكاتب نفسه، وإنكار ذلك هو سوء فهم لفنّ الكتابة الروائية.
يبدو لي أنّ هناك الكثير مما تشترك فيه الكاتبة آن مع أغنيس أكثر مما تشترك مع معظم أبطال الرواية؛ لذا من خلال قراءة أغنس غْري نشعر بأننا أقرب إلى الكاتبة آن برونتي نفسها. حتى من دون هذه التوصية ستبقى الرواية شيقة ورائعة.
أغنيس غْري هي قصة مربّية وتعاملها مع عائلتين مختلفتين تماماً هما: عائلة بلومفيلد وعائلة ميوريه (اللتان تبدوان على غرار عائلتي إنغهامز وروبنسن؛ حيث عملت الكاتبة آن نفسها لديهما مربيةً). يتعامل أطفال بلومفيلد بقسوة مع الحيوانات، ويصطادون الطيور ويعذبونها، ويقسون على مربّيتهم، ويتشاجرون معها، ويبصقون في حقيبتها. يتطابق هذا مع ما نعرفه عن أطفال إنغهامز، الذين وصفتهم شارلوت، بشكل لا يُنسى، بأنهم «صغار أغبياء لا أمل منهم».
فتيات عائلة ميوريه، اللائي تعلّمن على يد أغنيس، هنّ أكثر ذكاءً ولطفاً، لكن أغنيس صُدمت بموقفهنّ من الزواج، وبالطريقة التي تحاول والدتهنّ إجبارهنّ بها على زيجات لا حبّ فيها. مرة أخرى، يتطابق هذا الأمر مع ما نعرفه عن فتيات روبنسون؛ فإحداهنّ هربت مع ابن مالكٍ لمسرح، واستمرت اثنتان منهنّ في الكتابة إلى آن للحصول على مشورتها، بعد فترة طويلة من توقفها عن العمل مربيةً لهم.
في قلب القصة، بشكل متزايد، تكمن أغنيس نفسها وحبها للمدير المساعد ويستون. في هذا يمكننا أن نقرأ عن حب آنلمساعد والدها ويتمان، تماماً كما نرصده في شعر الرثاء، الذي كتبته آن بعد وفاة ويليام ويتمان المفاجئة (بعد إصابته بالكوليرا التي التقطها من أحد أبناء الرعية، الذين زارهم، وكانوا مرضى، والزيارات هذه كانت مَهمة يقوم بها ويستون في أغنيس غْري).
لن أكشف النهاية باستثناء أن أقول إنّها نهاية رومانسية بشكلٍ لا يصدق، ومؤثرة أيضاً بشكل لا يصدق… هل هذه الشخصية البديلة أغنيس هي آن، التي تمنح نفسها، عبر الكتابة، حياةً انتزعتها الحياة الواقعية بعيداً عنها؟ نهاية الكتاب بسيطة جداً ومتقنةٌ جداً:
«والآن أعتقد أنني قلت ما يكفي».
قليل من الروايات تنتهي بجملة بسيطة كهذه، ورغم ذلك، إن بساطتها تكمن في القدرة على تحريك القارئ بعمق. أغنس غْري هي رواية مكتوبة بشكل رائع، وهي قصيرة، لكنّها دقيقة مُحكمة، ولا شيء فيها في غير محله. في رأيي، هي رواية من عائلة برونتي تفوق كلّ رواياتهنّ الأخرى بتشكيلها المكتمل بشكلٍ مثالي، ما يدلّ على أن آن قد أتقنت بالفعل فنّ كتابة الرواية. ليس هناك الكثير في الأدب الإنجليزي مما يشبهها. ورأيي أنّها تشابه روايات الياباني اللامع الحائز جائزة نوبل ياسوناري كاواباتا؛ حيث لا يحدث الكثير، ثمّ تدرك فجأة أنها استحوذت على قلبك.
جورج مور (George Moore)لإدوارد مانيه (Edouard Manet)
أثنى جورج مور، وهو نفسه كاتب مهمّ من أوائل القرن العشرين، على الكتاب على النحو الآتي:
«أغنس غْري هي أفضل قصة نثرية في الأدب الإنجليزي… قصة بسيطة وجميلة مثل فستان من الموسلين… نعلم أننا نقرأ تحفة فنية. لا يمكن إلا لعبقريةٍ أن تقوم بوضع الأشياء أمامنا بهذا الوضوح، وفي الوقت ذاته بهذا الضبط والتحفظ».
ليس لي إلا أن أوافق على رأيه، لذا إنْ لم تكن قد وافقته بعد، فامنح نفسك هديةَ عيد الميلاد، واقرأ أغنس غْري بقلم آن برونتي. إنّها ليست رواية طويلة مثل بعض الروايات الأخرى، وليست درامية، ولا عالية النبرة، وكذلك ليست صاخبة، بل هي عمل متألق تأتيك عبقريته همساً من الصفحة الأولى حتى الصفحة الأخيرة.